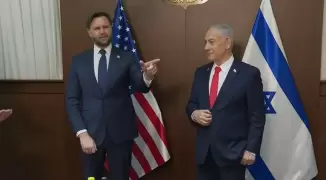فسدت السلطة الفلسطينية، ثمة ما يشبه الإجماع على الأمر، الحقيقة أن الأمر يواصل حدوثه منذ وقت طويل، الحديث عن شبهات الفساد بدأ مبكراً، أثناء تأسيس السلطة في العقد الأخير من القرن الماضي، كان الأمر في البداية ينصبّ على طريقة ملء الهياكل للإدارات والأقسام والمؤسسات، وحيلة المستشارين الذين جرى زجهم في كل مكان، جيش من "المستشارين" بمهمات غامضة ومن دون وصف وظيفي يضع خطوطاً لهيئاتهم أو يوضح ملامحهم أو يحدد أدوارهم، مجاميع من الأشباح المحظوظة تزحف نحو زوايا الهيكل المفتوح ومفترقاته ومفاصل العمل فيه، أشباح تصل من كل مكان بشهادات "خدمة ثورية" و"صلات تنظيمية" الى مبنى "المنتدى" على شاطئ البحر في غزة ومبنى "المقاطعة" في رام الله، ثم تتدفق بثقة أكبر من مكاتب الرئاسة في المبنيين وعبر "الممر الآمن" قبل أن يغلق بين الضفة والقطاع، وهي تلوح بقرارات التعيين وسنوات الخدمة التي جرى احتسابها في وجوه المارة والفلاحين والعمال المتوجهين الى أعمالهم عند الاحتلال وفي ظهورهم، كان هذا يكاد يكون مشهد سنوات التأسيس الأولى.
كانت اتهامات الفساد تنصبّ على الحصص ودفع الكوادر التنظيمية و"المتفرغين" نحو منظومة فرص العمل الهائلة التي أطلقتها عملية إنشاء سلطة وطنية في الجزء المتبقي من فلسطين، الضفة الغربية وقطاع غزة، طوائف على شكل فصائل بمسميات غير دقيقة، أسماء علقت منذ التأسيس في نهايات عقد الستينات وفقدت عبر الزمن دلالاتها، ولكنها واصلت الجلوس في الركن المخصص لـ"اليمين الثوري" رغم أنها تحلم باحتكار "السلطة" ومنافعها، وبالمقاعد المخصصة لـ"اليسار"، رغم أنها تحلم أحلاماً يمينية.
الفصائل التي وصلت الى فلسطين حية وهي تتنفس، بما فيها تلك الافتراضية، كانت تبحث عن حصتها الخالدة في مؤسسات منظمة التحرير، وتسعى الى نقل التجربة بحذافيرها الى مؤسسات السلطة، الحصة التي ضمنتها "قائمة الوحدة الوطنية"، عملياً ما يتبقى بعد حصة "النصف +1" التي تحصل عليها "فتح"، كان الصراع يدور بالكامل في الحصة المتبقية لليسار المقسم، لأسباب غير مقنعة، والتي كان يطلق عليها سراً "النصف – 1"، أما في "النصف+1" فثمة صراع مختلف بين مراكز القوى في "فتح".
الحديث عن الفساد كان يدور في الغالب على هذه المحاصصة. كل فصيل كان يحاول دفع "مستشاريه" وكوادره نحو الهيكل، بينما كانت البوابة تضيق والهيكل يتضخم ويتلقى مجاميع من "البطالة المقنعة"، وهي على أي حال أكثر خطراً ومأسوية من "البطالة" الحقيقية التي تتفشى بين الجمهور والمتخرّجين والمؤهلين، إذ تتحول مع الوقت الى عوامل معيقة ومدمرة لأفكار التخطيط والمخيلة الإبداعية والإنجاز وإمكانات التطور والتنمية، وهو ما يحدث الآن.
فساد السلطة لم يعد خافياً ولم يعد الحديث عنه سراً وطنياً، وهذا يشمل الفصائل التي وافقت على حدوثه عبر بحثها عن حصصها، بطرق مختلفة، تبدأ من الولاء الأعمى وصولاً الى المقاطعة العدمية.
الإسلام السياسي، "حماس"، التي تقدم نموذجاً بالغ التخلف حول الحكم، حيث تسترشد بتأويلات "جماعة الإخوان المسلمين" وأفكار الخلافة والتسلط وسوء الإدارة، وتغييب كل ما هو مدني ومتصل بالعصر، وكتم الحريات تحت لافتة المقاومة هي مستوى آخر من الفساد.
الأمر يتكرر بصورة مأسوية، فكما حوّلت الأنظمة الدكتاتورية في الإقليم، عبر ادعاء مزيف، "فلسطين" الى عبء على كاهل شعوبها، تحول هذه الفصائل المقاومة الى عبء على كاهل الفلسطينيين.
هذا وصف لا يسعى الى التحليل ويمكن تعميمه على إقليم الشام بدرجات متفاوتة، وبمظاهر مختلفة، ولكنه يتفق في الجوهر، سوريا ولبنان على وجه الخصوص.
لا السلطة تمثل الشعب ولا المعارضة تمثل المعارضين.
تتجمع المعارضة في فلسطين خارج الصراع القائم بين منظومة الحكم والساعين اليه، وتبحث عن البدائل الممكنة، وتزدهر خلال ذلك ظواهر مثل ظاهرة استعادة نفوذ العائلات وقوانين العشائر ومنظومة الأعراف، بما يشمل مواجهة القانون المدني، وتنشأ القدرة على مساومة السلطة على بنوده، وخضوع السلطة للمساومة، لعل هذا يفسر على سبيل المثال تعثر تنفيذ القوانين الخاصة بـ"جرائم الشرف" وقتل النساء وتطبيق اتفاقية "سيداو" حول حماية النساء من العنف.
في مستوى آخر، يمكن سوق أمثلة كثيرة على تجاوز قانون السلطة نفسه، من خلال سيل المراسيم "بقوة القانون"، التعيينات وتحييد المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير)، وقبل ذلك "حل" المجلس التشريعي (برلمان السلطة)، كذلك عجائب القوانين التي تبتكرها "حماس" في غزة من التعيينات الى آداب المشي على الشاطئ أو فرض الزي، وصولاً الى كيف تجلس النساء في المقهى.
الاسترخاء الطويل في السلطة، لأسباب كثيرة وعوامل خاصة، منها الاحتلال ونزعة التسلط المتوفرة بكثافة، يمنح "المجموعتين الحاكمتين" شعوراً مزدوجاً وزائفاً بالحصانة والحكمة، في حالات أخرى يتداخل حضورها مع التاريخ. تفقد "النخب" بصيرة تأمل التاريخ عندما لا تخشى تداول السلطة، وتتصرف على أنها محرك له، تقترح عبر ثقافتها حول نفسها مدخلاً، وتلتحق بالتاريخ بصفتها صانعة لحوادثه بكل ما يمكن أن ينتجه هذا الوهم من كوارث وكوميديا. وفي شروط الواقع الفلسطيني يكتسب هذا الوهم شيئاً من القداسة والحصانة "الوطنية" التي أعيد تدويرها، وهذا يشمل الى جانب المجموعتين الحاكمتين سلطة الفصائل على أعضائها، في حالة توفر هؤلاء الأعضاء، وبعض مؤسسات المجتمع المدني.
وكلما تراكمت الأخطاء وسوء الإدارة يتجدد الاحتجاج بأشكاله، من التظاهرة التي تحمل شبهة الاعتراف بالسلطة، الى الإهمال الذي يصل الى مستوى تجاهل وجودها تماماً.
ثمة مواجهة تتصاعد في الضفة مع الاحتلال، مواجهة تشمل معظم مناحي الحياة وتنتشر من عنابر السجون الى كل المناطق تقريباً، في الأغوار والشمال والجنوب مروراً بالقدس، مواجهة الاحتلال بهذه العفوية والقوة والشمول من دون الالتفات الى السلطة وأجهزتها وخطابها وسعيها الى السلام الاقتصادي وبناء الثقة مع الاحتلال، هي أقصى حالات الاحتجاج وأكثر أدوات المعارضة نجاعة وفعالية، أمام الاحتجاج وبسبب الافتقار الى فضيلتي الإصغاء والتأمل يتعزز الشعور لدى السلطة بجهل القاعدة ونكرانها للجميل وافتقارها الى بعد النظر.
هذه هي الفقاعة التي تعيش فيها السلطة الفلسطينية بنوعيها، رام الله وغزة، في غياب الانتخابات والاحتكام الى الصناديق، الوهم الذي ينتج وهمه ويراكم كارثته على محفة وطنية.