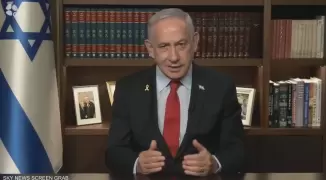تكلّم أدونيس، في أيامه السعودية، كما يكتب، أي شرّق وغرّب، بطريقة يصعب أن تكون مجدية في كل محاولة محتملة للإفلات من شبهة الكلام الفاضي. وهذا، في حد ذاته، لا يحسب له أو عليه، فثمة الكثير من الكلام الفاضي في عالم اختلطت فيه الحقائق بالأكاذيب، نتيجة الاستثمارات المالية والبشرية الهائلة في تقنيات ووسائل ومنصّات الدعاية والإعلام.
ومع ذلك، في الوظيفة التي اختارها لنفسه (المثقف العام الحداثي المُحدِّث والرائي، داعية الحداثة، والمتمرّد على السائد) ما يعزز صعوبة الإفلات من شبهة كهذه، وما يبرر تحويلها إلى مناسبة، وخلفية عامة، لتأمّل مدى تطابق "الدعوة والداعية"، بعد حضور في الحقل العام زاد على ستة عقود، والحكم له أو عليه، وقد صار وسيلة إيضاح لكل ما رأى، وخرج منه وعليه، وسعى إلى تحديثه. فسر الداعية في الدعوة، والعكس صحيح، أيضاً.
سيتضح هذا، بصورة أفضل، في حال الاستعانة بفكرة لامعة لحنّا أرندت: "الإحلال الدؤوب والكلي للأكاذيب محل الحقائق الفعلية لا يعني قبولها كحقائق، ولا أن الحقائق ستشوّه بوصفها أكاذيب، بل يعني أن الإحساس إزاء اتخاذ هذا الموقف أو ذاك في الواقع، ومعيار الصدق بوصفه نقيضاً للزيف - وهي الوسائل العقلية لتحقيق غايات كهذه - من الأشياء التي تتعرّض للتدمير".
بمعنى آخر: لا الحقائق ولا الأكاذيب تكف عن كونها كذلك، ولكن صعود الداروينية الأخلاقية، في سياق تفاعلات عميقة بين القمع، وغسيل الأدمغة، وتماهي الضحية مع الجلاّد، يعني أن التعامل مع اختلاط هذه بتلك، وصرف النظر عن أهمية التمييز بينها، يمكن تفسيره، دائماً، لا بسياسات ومصالح الحكومات والشرائح الاجتماعية السائدة، بل بضرورات ومهارات العيش، واليأس من صلاح الإنسان.
ويعنينا، على نحو خاص، أن أرندت تتكلّم عن "وسائل عقلية". وهذا ما ستتضح دلالته الآن، ولا جُناح علينا إذا عثرنا، في الأثناء، على ما يُفسّر سر "الدعوة والداعية". ولنقل إن الداروينية الأخلاقية لم تعقب زمناً فردوسياً وهمياً ومتوّهماً، لم يعرف الأكاذيب، بل كانت، دائماً، جزءاً من عملية تشكّل حقلَي السياسة والدين. وقد كانا حقلاً واحداً على مدار قرون طويلة.
عرفت القرون الطويلة ما لا يحصى من القائلين "بالحقيقة" (كائناً ما كانت)، وكذلك "صنّاع الأكاذيب". ولا يعنينا سوى التشديد على فرضية أن "الحقائق" في الأزمنة الحديثة، كما "الأكاذيب" مفاهيم جديدة، ووثيقة الصلة بمفاهيم واكتشافات جديدة أيضاً: "ولادة الإنسان" في التاريخ (بتعبير باختين)، وما نجم عنها من الدساتير، والبرلمانات، والأحزاب، وحقوق المواطنة والإنسان، على اختلاف أنواعها.
صارت ولادة مثقف الأزمنة الحديثة، في سياق "ولادة الإنسان"، ممكنة، أيضاً، مع حقوق المواطنة (خاصة بعد الثورة الفرنسية، أم الثورات الاجتماعية الكبرى في التاريخ)، وصار في وسعه، بعد ظهور الجامعات، وتقدّم العلوم على أنواعها، وظهور الصحافة، ادعاء مصادر مستقلة و"علمية" للمعرفة في القرن التاسع عشر (حتى ماركس أطلق على نظريته الاشتراكية "العلمية"، تأثراً بالنزعة السائدة في زمنه).
ما سبق هو مصدر "الوسائل العقلية" في كلام أرندت: الحقيقة لا بوصفها نوعاً من "الكشف" و"المغامرة العرفانية" (وما يدخل في حكمها من الكلام الفاضي)، بل بوصفها نتيجة منطقية لعلوم ومناهج المجتمع والإنسان. وإذا كان ثمة ما يبرر وجود المثقف في الأزمنة الحديثة، فلن نجد ما هو أنبل وأفضل من الدفاع عن، وحماية، "الوسائل العقلية" من التدمير.
نشأت الحداثة بمعنى modernism - كما ذهب العظم في نقده للرجعي والأصولي في حداثة أدونيس - كردة فعل معادية في الجوهر لروح وذائقة القرن التاسع عشر، ونزعته العقلية. وبما أن تعبيرات من فصيلة "الكشف" و"الأسطورة" و"السر" و"ما وراء الكلام"، بل و"الثورة"، حمّالة أوجه، وتقبل التفسير بطرق مختلفة، فقد صارت، كما القائلون بها، عنواناً، لما يُعرّف، على لسان أدونيس بجيل الحداثة الأوّل، وهذا ما يستحق منّا معالجة مستقلة.
مهما يكن من أمر، تضافرت، في بيروت الخمسينيات والستينيات، التجليات الأولى لثروة النفط في الفيافي البعيدة، وما استدعت من وجود مصارف ومرافق سياحية وفنون وخدمات، إضافة إلى صعود القوميات الرومانسية الناصرية والبعثية وحركة القوميين العرب، وما اقترن بهؤلاء من اقتصاد الطباعة والصحافة والتعليم والصراعات العقائدية والحزبية، في ظل ليبرالية سياسية واقتصادية بضوابط طائفية.
أسهمت هذه المكوّنات مجتمعة في بلورة رافعة اجتماعية - اقتصادية، وحاضنة سياسية، ومنصة أيديولوجية لحداثة "الكشف" و"الغامض" و"السر" و"ما وراء الكلام"، و"الثورة" بطبيعة الحال. وقد وصلت بيروت، كما حداثتها، إلى نهاية مأساوية مع اندلاع الحرب الأهلية، وما نجم عنها من أفق مسدود، وخراب عميم ومقيم. (هذا، بدوره، ما يستدعي معالجة مستقلة، أيضاً).
على أي حال، اللافت، والمفارقة المُوحية، أن "حداثة" أدونيس ما زالت بحكم التباسها، وعدائها للمنطق (كما تجلت في زمن الثورة السورية، وفي أيامها السعودية) وصفة شديدة الفعالية لتقويض فعالية المثقف في الحقل العام بوصفه مدافعاً عن، وحامياً، لمنطق التمييز بين الحقائق والأكاذيب. والطريف أن جماليات "الكشف"، "والغامض" و"الأسطورة" و"السر"، تبدو صالحة للتداول والتدوير والتبرير في زمن "الحداثة الإبراهيمية"، كما كانت في زمن القوميات الرومانسية، وعاصمتها البيروتية، وتضمن في الحالتين لصاحبها "طريق السلامة".
يحدث هذا في زمن الثورة المضادة، في ظل حروب أهلية، تسخن وتبرد، انفجرت فيها، وفاضت، مرافق الصرف الصحي السياسية والثقافية، وطمست الفرق بين حكومات تتصرف كميليشيات، وميليشيات تتصرّف كحكومات، وعلى الحواف المسننة، وقد صارت هشّة كعظام تحللت، لمجتمعات حضارات نهرية وبحرية تسبح الآن في دمها، ثمة من يتأهب للانقضاض. كل ما في "وقت بين الرماد والورد" يشهد على صاحبه. فاصل ونواصل.