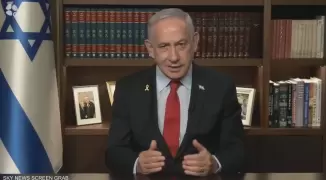الإعلان السعودي الذي يقضي بوقف الاتصالات بشأن موضوع «تطبيع» العلاقات مع إسرائيل لم يكن مفاجئاً، وربما توصّلت القيادة السعودية إلى قرار بوقف هذا المسار كلّياً.
المملكة العربية السعودية دولة كبيرة وقوية، بمساحتها الجغرافية، وموقعها الاستراتيجي وبعدد سكّانها، وهي قوية بثرواتها، وبمكانتها الدينية، وهي فوق ذلك دولة طموحة تشقّ طريقها نحو أن تصبح بما تمتلك من مقوّمات دولة ذات تأثير إقليمي ودولي.
النزعة الاستقلالية لدى القيادة السعودية واضحة، نحو التخلّص من الخيارات الإجبارية، والارتهان لعلاقات دولية بعينها، والتضحية بمصالحها لحساب أطرافٍ دولية مهيمنة.
لا حاجة للسعودية، لأن تفتعل دوراً أكبر من حجمها وتأثيرها الكبير والمتزايد على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن العربي، حتّى تضطر لبيع كرامتها وهويّتها الوطنية والقومية، لقاء مكاسب صغيرة، ستظلّ مُعرّضة للمصادرة، إن هي خرجت عن الدور المفروض عليها من قبل أطراف خارجية.
ربّما لا تُدرك بعض الدول التي «طبّعت» علاقاتها بإسرائيل خلال السنوات الثلاث المنصرمة، أنّها تدفع أثماناً باهظة لقاء وعودٍ، ومساعدات، ذات طابعٍ أمني، ستنقلب عليها في أيّ لحظة.
إسرائيل ليست دولة يرتكن إليها، ولا هي دولة قيم وأخلاق، أو دولة التزام بما يتمّ الاتفاق عليه، وهي دولة لها تطلُّعات استعمارية، تفيض عن فلسطين التاريخية.
لا تتورّع إسرائيل عن التآمر على الأنظمة التي توقّع معها اتفاقيات، فسلوكها الأمني العدواني يسبق أيّ سلوكٍ آخر.
بعد أكثر من أربعة عقودٍ من اتفاقية «كامب ديفيد»، لا تزال تتآمر على مصر الكبيرة من خلال علاقات ومشاريع مشبوهة، تستهدف السيطرة على مياه نهر النيل، ومُحاصرة مصر من الجنوب، حيث يدها الطويلة في الصراع الدائر في السودان، بعد أن لعبت دوراً في انقسامه إلى شمالٍ وجنوب.
إسرائيل ترفض كلّ الوقت تقديم أسلحة ومعدّات حربيّة متطوّرة كالتي تحصل هي عليها، ولا تتورّع عن الإعلان عن مخاوفها من التوجُّه المصري لبناء مفاعلٍ نوويٍّ سلمي.
على عكس السعودية، فشلت الدول العربية الأربع التي «طبّعت» علاقاتها مع إسرائيل خلال السنوات الثلاث المنصرمة، في أن تمارس أيّ مستوىً من الضغط على إسرائيل للتعامل بطريقةٍ مختلفة إزاء ملفّ القضية الفلسطينية، ما يُسقِط الخطاب القومي المدّعي لتلك الدول، ويُؤكِّد حصريّة رُؤاها القُطرية الضيّقة.
لم يبقَ على الرئيس الأميركي جو بايدن إلّا أن يرقصَ فرحاً واحتفالاً بما تمّ الاتفاق عليه خلال مؤتمر «مجموعة العشرين» في الهند (البهارات)، حيث يُفترض أنّ كلّ الأطراف المعنيّة مُوافقة على إنشاء طريق بحري وبرّي يربط الهند بالإمارات والسعودية والأردن بإسرائيل.
العرب هم الذين سيتحمّلون تكلفة هذا المشروع في حال التزمت الأطراف بالعمل على تنفيذه، الذي يُقال إنّه أقلّ تكلفةً من قناة السويس، وأقلّ وقتاً وجهداً خلال نقل البضائع إلى أوروبا.
إسرائيل هي الأخرى رقصت طرباً لهذه الفكرة، لأنّها ستؤدّي إلى زيادة إيراداتها، وتنشيط موانئها على «المتوسّط»، وتحقق لها مكانة الربط الاستراتيجي بين آسيا، وأوروبا والتحكُّم في طرق تدفُّق الطاقة.
غير أنّ الأهمّ بالنسبة لإسرائيل أنّ مثل هذا الطريق سيؤدّي إلى استبدال طريق قناة السويس، ويُحجّم مردوداتها، بالإضافة إلى إضعاف مكانة مضيقي باب المندب وهرمز، ويحرم الدول المطلّة على المضيقين من بعض الموارد.
قبل ذلك وفي إطار الاستراتيجية ذاتها، فكّرت إسرائيل بحفر قناة تربط البحر الأبيض بالأحمر، والأرجح أنّ الفكرة لا تزال قائمة في حال مشروع الربط الذي تمّ الإعلان عنه في قمّة «مجموعة العشرين».
حتّى الآن تُطرح تفسيرات مختلفة للقرار السعودي بوقف الاتصالات بشأن «صفقة التطبيع»، والأرجح أنّ أسباب القرار تتجاوز كثيراً التفسيرات المنقوصة التي تُطرح هنا وهناك.
الشروط التي طرحتها المملكة لقاء «تطبيع» العلاقات مع إسرائيل تشير بوضوح إلى أنّ سياسة ودوافع القيادة السعودية بعيدة كل البُعد عن الانصياع لطلبات أو حتى ضغوط أميركية، وأنّها، أيضاً، بعيدة عن منطق، منح بايدن إنجازاً كبيراً لكي يساعده في التغلُّب على أيّ منافسٍ جمهوري.
بايدن في الأساس مرشّح ضعيف جدّاً، ولا يملك فرصاً قويّة للمنافسة والفوز.. فعدا زلّات لسانه وسقطاته العديدة، فإنّه الآن يتعرّض لمحاولة عزله، حيث أعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري، البدء باتخاذ الإجراءات لتحقيق ذلك، لأسبابٍ تتعلّق بفساد عائلة بايدن وبقدراته الصحية والعقلية.
هذا يعني أنّ بايدن وإدارته لا يملكون القدرة أو الصلاحية على تنفيذ أيّ اتفاقٍ يتطلّب من الولايات المتحدة، تقديم مساهمتها ودورها في الاتفاق.
أميركا يجب أن تتعهّد بتقديم المساعدة للمملكة في بناء مفاعلٍ نووي، وعليها أن تقدّم لها أسلحة متطوّرة جدّاً كالتي تحصل عليها إسرائيل وتتكفّل، أيضاً، بتأمين الحماية، وأيضاً عليها أن توظّف إمكانياتها لممارسة ضغطٍ حقيقي فعّال على إسرائيل بشأن الملفّ الفلسطيني.
في الواقع لا تتوفّر الحدود الدنيا من الثقة، بالتزام الولايات المتحدة بدفع مثل هذه الأثمان، والثقة معدومة أصلاً في أن تقبل إسرائيل ببنود هذه «الصفقة» في ظلّ حكومة عنصرية «يمينية» فاشية متطرّفة.
لا تستطيع الولايات المتحدة، وهي بالتأكيد لا ترغب في أن تلوي ذراعَ إسرائيل بالرغم من خلافها مع بنيامين نتنياهو وبعض وزرائه، وهؤلاء أصلاً ليسوا مستعدّين لتقديم الحدّ الأدنى من التعامل مع الفلسطينيين.
ستنهار الحكومة الإسرائيلية الحالية في حال وافقت والتزمت بالشروط السعودية التي لا تكتفي بطرح بعض الخطوات التسهيلية للفلسطينيين وإنّما تطالب بالتزام إسرائيل بـ «رؤية الدولتين».
والحقيقة أنّ السعودية ليست مضطرّة لتقديم هِباتٍ مجّانية لإسرائيل أو أميركا، بينما لديها بدائل لتحقيق كلّ ما تريده ما عدا الملفّ الفلسطيني، حيث يُتيح لها الصراع والتنافس الدولي أن تحقّق ما تريد، وأن تحصل على ما تريد من الصين أو روسيا..
لقد أعطت المؤشّرات الواقعية مؤخّراً مصداقية لاستعداد السعودية، للبحث عن مصالحها وتعزيز طموحاتها بعيداً عن الهيمنة الأميركية وحلفائها.