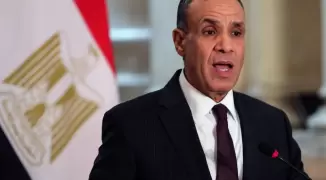أن تمتلك بيتاً، هو حلم وهاجس كل إنسان تقريباً؛ باستثناء فئة قليلة من الناس ممن يعيشون على هامش المجتمعات، خاصة في المدن الصناعية يفترشون الأرصفة ومحطات القطارات، يسمونهم «Homeless»، لا نعلم يقيناً إذا كان هؤلاء مُجبرين على هذه العيشة، بسبب الفقر، أم أنهم زاهدون في الحياة، لدرجة أنهم لا يفكرون بإيجاد بيت.
في الأزمنة الغابرة لم يعرف الإنسان القديم البيت بالشكل الذي نعرفه اليوم، لذا كان امتلاك البيت حلماً غامضاً وبعيداً، فقد عاش الناس في تلك العصور الموغلة في القِدم في الكهوف، باعتبارها مأوى مؤقتاً يقيهم من تقلبات الطقس، ويحميهم من وحوش الفلاة، وفي أماكن أخرى سكنوا في أعشاش على قمم الأشجار الباسقة، للوقاية من لدغات الحشرات، والمفترسات التي لا تحسن تسلق الأشجار.. أي أن البيت ظل ولعصور طويلة جداً مجرد حيز مؤقت يؤمّن الحماية لسكانه.
ومع تطور المجتمعات وتعقد أشكال الحياة صار البيت عبارة عن خيمة يحملها أصحابها أينما حلوا وارتحلوا (ظل هذا الشكل قائماً حتى اليوم عند البدو واللاجئين)، لكن النقلة النوعية لشكل البيت ووظيفته حصلت مع الثورة الزراعية، التي تطلبت الاستقرار في منطقة ما، لرعاية المزروعات وانتظار حصادها وقطافها.. وكانت البيوت في تلك الحقبة مشتركة (تسمى عصور المشاع).
النقلة الثانية والأهم حصلت مع نشوء نظام المـلكية، أي حين أحاط أول شخص بيته بسور، ورسم له حدوداً، وأعلن عن ملكيته الخاصة لهذه المساحة، والتي صار تجاوزها يحتمل إعلان الحرب.
بموازاة الـمُغر والكهوف والبيوت الشجرية والخِيام كان مسار آخر لتطور مفهوم البيت يتخذ منحى تصاعدياً (لم يتوقف حتى الآن)، وقد بدأ مع تشكل الأسرة، والتجمعات العشائرية الصغيرة، التي بدأت تتحول إلى حواضر عمرانية على شكل قرى زراعية، ثم إلى مدن مركزية، وممالك.. وكانت بيوت تلك الأزمنة من الطين والحجر والأخشاب وخليط مما كانت توفره الطبيعة آنذاك، وبلا خصوصية، وإلى الآن تشترك عشرات البيوت في الأحياء القديمة بسقف واحد.
وكانت البيوت من طابق واحد، حتى ظهرت الخرسانة في بداية القرن الـ 19، ولم تظهر العمارات الشاهقة وناطحات السحاب إلا بعد اختراع المصعد.
في البدايات السحيقة اهتدى بُناة المنازل الأولون إلى فكرة الباب، ثم الشباك، والسقف، ثم تقسيم المنزل إلى غرف متخصصة، وكان البيت في أغلب الأحيان يشترك فيه أصحابه وحيواناتهم من بهائم ودواجن.. وظلت فكرة «الحمّام» مستبعدة، ومؤجلة حتى عهد قريب جداً.
ومع مرور الوقت صارت البيوت وأنماط العمران سمة كل عصر؛ اليوناني، الروماني، الأندلسي، والفاطمي.. وصارت تعبيراً عن تفاوت الطبقات؛ فهناك أحياء للأثرياء، وأخرى للفلاحين والعمّال، وغيرها للفقراء والمعوزين، تعرفها من شكل البيوت وطرازها ومساحاتها. وصار بالإمكان تمييز ذوق وثقافة صاحب البيت، وفرز محدثي النعمة، الذين يبنون قصوراً فارهة ويخصصون في فنائها قناً لتربية الدجاج.
كانت وظيفة البيت الأساسية تأمين الحماية من تقلبات الطبيعة ومخاطرها، وأيضاً من مخاطر البشر الآخرين.
وهنا لا فرق بين مغارة في العصر الحجري، والبيت الذكي الذي يصمِّمه اليوم أبرع المهندسين. ولكن للبيت وظائف أخرى، بأدوار معنوية تتكامل مع أدواره المادية، وقد يؤدي أي بيت دور الحماية المادية، لكن البيت الحقيقي هو الذي يمنح الحماية المعنوية، أي الشعور بالأمان، فيصبح فضاؤه الداخلي نقيض كل الخارج المثير للقلق والخوف والمتاعب.
وإضافة لكونه الحاضنة الأهم للرابطة الأسرية، هو في جوهره بمثابة عالَم مصغّر فيه القليل من كل ما في العالم الكبير: الأفكار والمشاعر وأنماط الحياة وكل ما يلبي حاجاتنا ورغباتنا، وما ينتجه ويخترعه العالم.
ولكن مشاعرنا تجاه البيت الذي نسكنه تختلف من شخص لآخر، المالك غير المستأجر، البيت الضيق يختلف عن الواسع، والقديم ليس كالحديث.
والبيت يمنحنا الألفة والشعور بالدفء من خلال العاطفة والعادات اليومية والعلاقات الأسرية التي تُضّخ فيه؛ فالبيت مهما كان بديعاً وفخماً دون تفاعل سكانه يصبح مجرد كتلة من الجدران الصماء والأثاث البارد.. فمثلاً، يحرص بعضنا على إبقاء بيته نظيفاً على الدوام، يسوده الصمت، ومرتباً بشكل لا يقبل أي خطأ، وكل شيء فيه بمقدار، وفي مكانه المحدد.. حين تدخل هكذا بيت تشعر كأنه متحف، أو معرض، تحسب خطواتك وسكناتك بدقة حتى لا «يتخربط» النظام، ومن شدة نظافته تشعر وكأنه مختبر، أكثر ما تخشاه أن تندلق من فنجانك قطرة قهوة، ستشعر بالضيق.. وأن البيت فاقد للروح، وبلا حيوية.
يكون البيت بيتاً بسكّانه؛ بحركاتهم وأنفاسهم وسهراتهم، بفوضاهم وحميميتهم، بألعاب أطفالهم، وشقاوتهم، بنقاط ضعفهم الإنسانية، وممارساتهم اليومية غير المقيدة، وطبعاً لا يعني ذلك التخلي عن النظافة والترتيب.. شريطة عدم التخلي عن الحرية.
حين فقدت «ميسون» زوجة معاوية حريتها في قصر الخليفة أنشدت: «لبيت تعصف الأرياح به أحبّ إليّ من قصر منيف»، وكان هذا سبب طلاقها، لكنها استعادت روحها الحـرة.. وهذا يقودنا إلى فهم آخر لدور البيت الوظيفي؛ أي خلق الذكريات.. لذا يظل البيت الأجمل بالنسبة لنا هو بيت الطفولة، مهما كان متواضعاً.
كما للبيت دور جمالي، في تصميمه الداخلي والخارجي، ولو تأملت الكثير من محتوياته وأثاثه ستجد أنها مسألة جمالية وحسب، وهذا الجمال (أو الفراغ) ينعكس على نفسيات ساكنيه..
قبل امتلاك البيت أو استئجاره نختار التصميم المفضل والممكن، وبالقدر الذي نهندس فيه البيت يقوم البيت فيما بعد بهندسة حياتنا في فضائه، وفرض أنماط تحركاتنا وسلوكنا وحتى أسلوب تفكيرنا.
في بلادنا نحب البيت الواسع والرحب، لأنّ «البيت الضيق يضيّق الخلُق».. في شرق آسيا البيوت صغيرة جداً، لذا نشأت صناعات عديدة استجابة لهذا الوضع، ولاستغلال كل إنش مربع من مساحته.
البيت مرآة لشخصياتنا، والبيت صنو الوطن، وصورته المكثفة، وقد اختصر محمود درويش المسألة بقوله: أريد جداراً أعلق عليه معطفي.
البيت بساكنيه؛ فلو كان قصراً وهجره أهله، سيهرم سريعاً، وستختنق أبوابه شوقاً في انتظار من يقرعها، إلى أن يتهاوى جثة هامدة.
أقصى عقوبة لأي شخص أن يفقد بيته.. وقد اقترفت إسرائيل أسوأ جرائمها ضد الإنسانية بهدمها وتدميرها عشرات آلاف البيوت الفلسطينية.