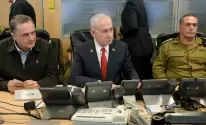صاغ عالم النفس الأميركي ماسلو نظرية تشرح سلّم حاجات الإنسان، لخصها في شكل هرم، بيّن فيه ترتيب الأولويات، ووصف الدوافع التي تُحرّكه، موضحا بأن الإنسان يظل في حالة سعي دائم لإشباع حاجاته، وأنّ أي حاجة غير مشبعة تسبب له إحباطاً وتوتراً وآلاماً نفسيّةً حادة. تأتي في القاعدة حاجات الإنسان البيولوجية (غذاء، نوم، جنس..)، ثم تأتي حاجته للأمان (أمن شخصي وأسري ووظيفي ومجتمعي..)، ثم حاجاته الاجتماعية (الصداقة، والعلاقات، أن يحب، وأن يكون محبوبا، أن ينتمي إلى جماعة)، ثم حاجته للتقدير (الثقة بالنفس، احترام الآخرين، الثناء، الإنجازات..)، وفي قمة الهرم حاجته لتحقيق الذات (الابتكار، الإبداع، التميز، ممارسة هواياته، تقبل الحقائق، وتقبل الآخرين..).
والأسئلة المطروحة: في أي مرحلة يمكن للإنسان الوصول إلى الرضا؟ وهل يشترط فيه تحقيق كافة احتياجاته من أسفل الهرم إلى قمته؟ ومن الأهم فعلا الغذاء أم الأمان؟ وأين يمكن تصنيف الحاجة للكرامة والحرية؟
أغلب الناس يظلون في الدرجات الثلاثة الأولى من الهرم (ومنهم من يظل في قاع الهرم، وبالكاد يؤمّن قوت يومه، ويفتقر للحد الأدنى من الأمان). أما من يصلون مراحل متقدمة في تحقيق حاجاتهم العليا، فيختلفون في توجهاتهم، وفي كيفية تحقيق الرضا، علما بأن الوصول إلى قمة الهرم يظل حلم الإنسان العصي (قمة النجاح، والسعادة، والكمال).
في الأوضاع الطبيعية، سيسعى كل شخص لصعود الهرم، وهذا حقه المشروع، وواجبه تجاه نفسه.. والمجتمعات المتقدمة هي التي بوسع كل مواطن أن يحقق فيها ذاته، دون قهر، ودون واسطة، بقوة القانون، وبجهوده الفردية، ولكم ماذا بشأن المجتمعات غير المستقرة؟ والأوطان التي تخضع لاحتلال؟ وفي فترات الحروب والأزمات والمحن والكوارث؟ بالتأكيد الموضوع مختلف، وسلم الأولويات سيختلف.
عندما يتعرض أي شخص لضغط خارجي يفوق إرادته سيرتد تلقائيا إلى بدائيته، وستوجهه غرائزه الأولية، وهذا الضغط الخارجي قد يكون حادثا فرديا أشعره بالخوف والقلق، وأخرجه من رتابته المعتادة وخلخل نسق حياته وأفقده توازنه.. وقد يكون تأثيرا خارجيا على مستوى المجتمع، كالحروب والصراعات مثلا.. وهنا الموضوع أخطر بكثير.
في فلسطين المحتلة، يواجه الفلسطينيون يوميا وعلى مدار الساعة أسئلة من نوع آخر، ربما لم تخطر ببال ماسلو، ولا حتى فرويد.. أمام آلية القتل وجبروت القوة وطغيان المحتل ستختلف الأولويات؛ أيهما أهم النجاة أم المواجهة؟ الصمود أم الهجرة؟ ستجد ما لا حصر له من حالات فردية قرر الشخص فيها أن يخوض امتحانه بنفسه؛ قد يعرض نفسه لخطر الموت أو التنكيل والإهانة أو السجن لسنوات طويلة فيقرر المجابهة أو الهجوم.. هذا حق مشروع، طالما أن القرار فردي ويتحمل مسؤوليته بنفسه، وهو وحده من سيدفع الثمن.. والسؤال المحير: هل من حقه التضحية بعائلته مثلا؟ أو التسبب بمقتل عشرات غيره بناء على قراره في المواجهة؟
لنضع جانبا الشعارات والكلام العام المنمق عن الحرية والكرامة، وعبارات المديح عن تضحيات الشعب وشجاعته وبطولاته، وهذه حقائق لا شك فيها، بيد أن الحديث هنا عن الحالة النفسية لكل شخص عادي، حتى لو كانت بمجموعها ستشكل حالة عامة (باستثناء الحالات المتطرفة شجاعةً أو جُبناً).
هل بمقدور أي شخص أن يتخذ قرارا يعلم أنه سيتسبب بمقتله أو إصابته بإعاقة أو اعتقاله أو هدم بيته؟ حينها سيواجه صراعا داخليا عنيفا للمفاضلة بين خيارات النجاة والسلامة وتجنب الأذى، وبين إحساسه بالذل والمهانة؟ فإذا قرر الانسحاب وعدم الرد هل بوسعه العيش معذبا بسبب تهشم صورته وكرامته أمام نفسه؟ لأنه تجنب المواجهة وآثر السلامة؟ ما هو الوضع الطبيعي، أو الأصح؟ حفظ النفس، أم التمسك بالقيم التي طالما آمن بها؟
سيكون سهلا على أي مراقب بعيد الإجابة بشعار «مت كريما ولا تعش ذليلا».. ولكن بالنسبة له الموضوع ليس بهذه البساطة والتسطيح.. فطرياً سيختار النجاة، وسيسأل نفسه: ماذا سأستفيد من فقدان حياتي؟ طالما أنه بوسعي النجاة بقليل من التنازل؟ ما هي حدود التنازل المسموح بها؟ ومن الذي يحددها؟ هل موته سيكون مجرد خسارة شخصية، أم سيترتب عليه خسائر للعائلة؟ من الأهم الوطن، أم نجاة العائلة؟
هذه أسئلة مشروعة، وتراود كل إنسان، لكن المعظم يتجنب طرحها، لحساسيتها.. وفي حال الإجابة عنها من المرجح أن نحصل على إجابتين مختلفتين تماما، واحدة حين يكون الشخص بمفرده وأمام نفسه، والثانية حين يكون مع الجماعة، فحين يكون ضمن مجموع ستذوب شخصيته أو تتوارى خلف خطاب الجمهور الأوسع، والذي غالبا ما تكون إجابته نمطية ومثالية، وربما غير واقعية.. وبالتالي سيكون القرار مختلفا.
للتوضيح، انضمام الناس للثورة الفلسطينية وانخراطهم في النضال العسكري أو انتماؤهم لأي فصيل مقاوم كان قرارا فرديا اتخذه كل شخص بمحض إرادته الحرة، وحتى لو ضمت الثورة مئات الآلاف فهم محصلة قرارات فردية.. أما القرار الجماعي في المواجهة فقد حصل مرتين فقط في تاريخنا المعاصر: في الانتفاضة الأولى والثانية.. كان قرارا جماهيريا عفويا بأداء جماعي شجاع جرى تنظيمه وتأطيره فيما بعد.. مع ملاحظة أن الانتفاضة الثانية كان القرار جماهيريا جماعيا بالمشاركة وظل كذلك في السنة الأولى فقط، فبعدها تمت عسكرة الانتفاضة، وتراجعت الجماهير إلى الخلف كمتفرجين وداعمين، وصارت المشاركة مقتصرة على أفراد ومجموعات محددة.
من الواضح أن الجماهير قررت ونفذت حين كانت المواجهة لا تنطوي على مخاطر وجودية، وكانت التضحيات ضمن المعقول، والمشاركة الشعبية لا تتطلب جهدا خارقا أو تدريبا خاصا.. وهذا سر قوة النضال الجماهيري ومعنى المقاومة الشعبية.
قد يضعف الفرد حين يكون بمفرده، أو يتردد.. لكنه سيكون أقوى مع الجمهور، الذي سيقوي بعضه ويشد أزر أفراده، ويحثهم على المواجهة.. الطليعة الثورية تاريخيا هي من تتولى المبادرة وتطلق صافرة البدء وتتقدم الصفوف، ثم تتبعها الجماهير.. ولكن هل يحق للطليعة أن تفرض على المجموع الانخراط؟ وأن تدفعهم للموت تحت شعار التضحية؟ هل يحق لها فرض الحرب بكل تبعاتها القاسية على كل الشعب بأطفاله ونسائه وشيوخه وذوي الإعاقة وسائر المدنيين ومن يرفضون الحرب؟
قرار الهجرة يندرج في السياق ذاته، في الأحوال الطبيعية من حق كل إنسان أن يسافر أينما شاء، بصرف النظر عن الأسباب. وفي الحروب من حقه أن يختار الحياة، كيفما أراد.. لذلك في كل حروب الدنيا كانت أفواج اللاجئين تتدفق إلى مناطق الجوارـ وبعيدا عن التهديد. وطبعا على نية العودة.
بين التضحية وحاجات الإنسان الأساسية
نشر 12 مايو 2025 | 11:03