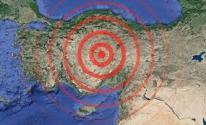يبدو أن الشيخ الغنوشي قد قرّر قطع الحبل السرّي لكي تكون الولادة ممكنة وسليمة في آن واحد.
القطع وليس غير القطع أدى إلى الإعلان الرسمي عن تحول حزب النهضة إلى الفصل ما بين النشاط الدعوي للحزب وما بين النشاط السياسي.
وبالرجوع إلى الرسالة التي أرسل بها الغنوشي إلى اجتماع استنبول للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين كان الغنوشي قد أنهى ومرة إلى الأبد كل محاولات ثنيه وثني حزبه عن هذا النهج الجديد، حتى وصلت الأمور إلى منع الغنوشي وفريقه من إلقاء كلمته على «المنصّة الرئيسية» ما اضطرهم إلى الاكتفاء بتوزيعها على الحضور فقط.
الحقيقة أن بوادر كثيرة كانت قد بدت في الأفق من أن حزب النهضة بقوة دفع خاصة من شخصية الغنوشي ربما يكون في «طريقه» إلى التخلي عن كامل النهج القائم في فكر وممارسة «جماعة الإخوان المسلمين» في الإقليم العربي الخاص، وفي عموم منطقة الإقليم الأكبر والمحيط.
وكانت هذه البوادر (إذا جاز التعبير) تطفو على سطح النشاط «النهضوي» أحياناً وتعود لتخبو في أحيان أخرى، ولم تتحول إلى طريق جديد إلاّ في السنتين الأخيرتين فقط وذلك «على هيئة معالم عامة».
الغنوشي كما بات معروفاً بدأ حياته ناصرياً، وانضم (وربما يكون قد أسس أو ساهم بصورة فاعلة في تأسيس حزب أثناء إقامته في دمشق) إلاّ أن التحول نحو الفكر الإسلامي لم يبدأ إلاّ بعد هزيمة حزيران من العام 1967، حيث انخرط الغنوشي في تأسيس حزبه الجديد والذي سرعان ما تحول إلى جزء من جماعة الإخوان المسلمين، التي «استغلت» الهزيمة للتمهيد لمرحلة جديدة وكبيرة من صعودها في نهاية العقد السابع من القرن الماضي ضمن مفارقات وتحولات اقتصادية واجتماعية موائمة تاريخياً لهذا الصعود. إذ أثّرت الحقبة النفطية في إحداث وتعميق هذه التحولات، كما تلازمت مع صعود التيار القطبي داخل معظم الجماعات الإسلامية، إضافة إلى النكوص السياسي الذي مثلته المرحلة الساداتية وإعادة بعث الوهابية في المنطقة العربية.
ومنذ منتصف الثمانينات على وجه التقريب بدأت ملامح هذا الصعود تتجسّد في سطوة الفكر الإخواني على الشارع العربي، وأخذ الإسلام السياسي يتغلغل ويتوغل في الجسد الاجتماعي العربي، وأخذ يقيم ويشيّد لنفسه اقتصاده السياسي الخاص، وأخضعت مجالات التعليم والثقافة والفكر لهذا الاتجاه.
انضم الإخوان ومن هم على هواهم وشاكلتهم، أو من هم من تفرعاتهم وتفريخاتهم، أو تحت عباءتهم للحلف الأميركي لمحاربة الشيوعية، خصوصاً بعد التدخل السافر للسوفيات في أفغانستان، وبعد هزيمتهم هناك، وبعد أن سقطت القلعة السوفياتية والكتلة الشرقية وانهار النظام العالمي في مصلحة الحقبة الأميركية.
استفادت جماعة الإخوان من حالة «المظلومية» التي ولّدتها حالة الفساد والاستبداد العربي لتعزيز مواقعها، وتحولت إلى قوة كبيرة مؤهلة لقطف ثمار أي تغيرات وتحولات كانت حتمية بالمقارنة مع حالة العجز التي وصلت إليها الدولة العربية العاجزة والفاسدة والفاشلة، والتي حولت مشاريع النهضة والتنمية إلى مشاريع خاصة لنخب التحالف السياسي الذي مثله اندماج المصالح وتداخلها ما بين أجهزة الأمن والطغم الاقتصادية والمالية في الإقليم العربي.
عندما حلّ «الربيع العربي» وجدت جماعة الإخوان المسلمين أن فرصتها التاريخية قد دقت ساعتها، ونزلت إلى الشارع للسيطرة عليه، وجهّزت نفسها للانقضاض على الحالة الجماهيرية المناهضة للأنظمة المستبدة وتحالفت مع الغرب للنيل من الدولة الوطنية، ولوقف تحول الحالة الجماهيرية إلى مرحلة ديمقراطية حقيقية، ولكي تحول دون إحداث تغيرات سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية تتجاوز رؤية وبرامج الجماعة، ولكبح جماح التطور نحو إعادة بناء النظم السياسية باتجاه التغيير الحقيقي للواقع العربي.
هذا السلوك الإخواني أفضى إلى تحالفهم مع الجماعات الإسلامية المتطرفة، وتحولت هذه الجماعة بصورة سريعة للغاية نحو عسكرة الحالة السياسية كأداة لأخونة المجتمع وفرض رؤية الإخوان على الشارع والأحداث.
كان هذا هو حال الإخوان في مصر، وكان سلوكها هو وضع البلاد على حافة الانهيار الداخلي، ووصلت الأمور إلى فتح معركة «مبكرة» جداً مع كل مؤسسات الدولة المصرية القضائية والأمنية والإعلامية والثقافية، وصولاً إلى رهن البلاد للغرب وبعض مقاولي الغرب في المنطقة العربية.
هكذا كان الأمر في معظم البلدان العربية، أيضاً.
وباستثناء الحالة المغربية وإلى حد ما الأردنية، دخل الإخوان في لعبة «التضحية» بوحدة البلاد وتماسك النسيج الوطني والاجتماعي، ورهن مقدرات الشعب والوطن والاستقرار الاجتماعي لمشاريع الغرب التفتيتية، بهدف «ضمان» دعم الغرب للجماعة في الإمساك بزمام السلطة السياسية في البلاد العربية التي طالها الحراك الجماهيري.
حاول الإخوان في تونس، وخصوصاً في المرحلة الثانية من الحكم أن يميزوا أنفسهم عن هذا النهج الإخواني المدمر، ولكن افكار الغنوشي لم تكن بعد قد انتصرت بالكامل، ولم يكن حزب النهضة التونسي قد حسم طريقه الجديدة، ولم تكن الظروف قد نضجت بالكامل للإعلان عن شق الطريق الجديد.
راهن الغرب على هذه الجماعة لأسباب أربعة معروفة: الأول، قوة الإخوان. والثاني، قدرتهم على محاربة التطرف من مواقع دينية وفكرية إسلامية. والثالث، عدم وجود أية برامج اقتصادية واجتماعية من شأنها الاختلاف مع النهج النيوليبرالي لإدارة الاقتصاد الوطني، وأما الرابع والأخير والهام، فهو الاستعداد «للتعايش» مع إسرائيل ومتطلبات أمن إسرائيل.
اعتقد الغرب في ظل نهم الإخوان للسلطة، وفي ظل استماتتهم للتحكم بالمجتمعات العربية أن الفرصة التاريخية لإعادة رسم الخرائط في منطقة الإقليم أصبحت سانحة، طالما أن القضية الوطنية قد نُحيّت جانباً، بل واعتقد الغرب أن فرصة إقامة الكيانات العربية على أسس دينية وطائفية ستمهد الطريق لتجديد «شباب» المشروع الصهيوني من خلال الدولة «اليهودية»، وصار بحكم الوارد إن لم نقل بحكم المؤكد ممكناً إعادة «هندسة» المجتمعات العربية وفق مفهوم المواءمة ما بين الأمة والدولة والدين، وما بين الدولة والأمة والعرق، أو الدولة والأمة والطائفة أو حتى المذهب.
انهار هذا المخطط بعد الثلاثين من يونيو في مصر وانهار بعد الاستفاقة التي شهدتها تونس اثر تعثر تجربة النهضة هناك، وانهار بعدما تحولت تركيا من النموذج المدني إلى النموذج السلطاني، وتراجع حزب العدالة والتنمية عن الكثير من التصورات التي كان قد طرحها كطريق «جديد» ونموذج «مختلف» لـ «الإسلام السياسي»، وبعد أن تسيد أردوغان وأصبح هو المرشد الحقيقي للجماعة بعد اجتماع استنبول الذي أشير إليه.
فبعد أن كان أردوغان يطرح تميزه عن باقي فصائل الإخوان بأنه يرى في الإسلام حالة ثقافية وليس أيديولوجيا سياسية ـ كاتب هذه المقالة سمع من اردوغان هذا النص شخصياً مع بعض الزملاء الصحافيين الفلسطينيين الذين كانوا في زيارة لتركيا بدعوة من مكتب رئيس الوزراء التركي آنذاك ـ فقد ارتدت التجربة التركية بصورة درامية، وهو الأمر الذي أدى إلى بلورة قناعة راسخة عند الشيخ الغنوشي بأن القطع الكامل مع هذا النهج هو الطريق الوحيد القادر على إحداث فرق حقيقي في كامل هذه المعادلة الغنوشية هل هي حالة أم اتجاه؟
أغلب الظن أنها ما زالت حالة، ولكن أغلب الظن، أيضاً، أن الواقع سيزكّي هذه الحالة للتحول إلى اتجاه. بهذا المعنى فإن الشيخ راشد الغنوشي هو رائد، وهو مفكر ملتزم، ومجدد كبير أعاد الاعتبار للوطنية التونسية في ظروف استثنائية، وأعاد الاعتبار للفكر الإسلامي نفسه.
تُرى هل سيكون الشيخ راشد الغنوشي هو محمد عبده في القرن الواحد والعشرين؟، وهل ستعيد أفكار الغنوشي الاعتبار على ما يجب أن يكون عليه الفكر الإسلامي؟!!
هذه هي المراهنة، مع أن ما أقدم عليه هذا المجدد الكبير وما نظّر له حتى الآن تضعه في مصاف المفكرين العظام. أما ردود الأفعال الأوّلية على أفكار الغنوشي فإنها تؤكد على ذلك، وتوحي بأن هذه الأفكار باتت تهدد بعض العروش الفكرية والسياسية لتيار لم يفهم قيمة الوطنية في مسار تطور الشعوب.
فعندما يقول الغنوشي للإخوان: اتقوا الله في أوطانكم، وتراجعوا عن هذا النهج المدمر فإن هذا الشيخ المجدد يكون قد سدّد للإخوان ضربة موجعة سيكون لها ما بعدها في عموم المنطقة.
أما قوة المجتمع المدني في تونس والإرث الذي تركته البورقيبية الاجتماعية مجسّدة بمظاهر ليبرالية حقيقية فقد تركت بصماتها في هذا التحول الهائل.
القطع وليس غير القطع أدى إلى الإعلان الرسمي عن تحول حزب النهضة إلى الفصل ما بين النشاط الدعوي للحزب وما بين النشاط السياسي.
وبالرجوع إلى الرسالة التي أرسل بها الغنوشي إلى اجتماع استنبول للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين كان الغنوشي قد أنهى ومرة إلى الأبد كل محاولات ثنيه وثني حزبه عن هذا النهج الجديد، حتى وصلت الأمور إلى منع الغنوشي وفريقه من إلقاء كلمته على «المنصّة الرئيسية» ما اضطرهم إلى الاكتفاء بتوزيعها على الحضور فقط.
الحقيقة أن بوادر كثيرة كانت قد بدت في الأفق من أن حزب النهضة بقوة دفع خاصة من شخصية الغنوشي ربما يكون في «طريقه» إلى التخلي عن كامل النهج القائم في فكر وممارسة «جماعة الإخوان المسلمين» في الإقليم العربي الخاص، وفي عموم منطقة الإقليم الأكبر والمحيط.
وكانت هذه البوادر (إذا جاز التعبير) تطفو على سطح النشاط «النهضوي» أحياناً وتعود لتخبو في أحيان أخرى، ولم تتحول إلى طريق جديد إلاّ في السنتين الأخيرتين فقط وذلك «على هيئة معالم عامة».
الغنوشي كما بات معروفاً بدأ حياته ناصرياً، وانضم (وربما يكون قد أسس أو ساهم بصورة فاعلة في تأسيس حزب أثناء إقامته في دمشق) إلاّ أن التحول نحو الفكر الإسلامي لم يبدأ إلاّ بعد هزيمة حزيران من العام 1967، حيث انخرط الغنوشي في تأسيس حزبه الجديد والذي سرعان ما تحول إلى جزء من جماعة الإخوان المسلمين، التي «استغلت» الهزيمة للتمهيد لمرحلة جديدة وكبيرة من صعودها في نهاية العقد السابع من القرن الماضي ضمن مفارقات وتحولات اقتصادية واجتماعية موائمة تاريخياً لهذا الصعود. إذ أثّرت الحقبة النفطية في إحداث وتعميق هذه التحولات، كما تلازمت مع صعود التيار القطبي داخل معظم الجماعات الإسلامية، إضافة إلى النكوص السياسي الذي مثلته المرحلة الساداتية وإعادة بعث الوهابية في المنطقة العربية.
ومنذ منتصف الثمانينات على وجه التقريب بدأت ملامح هذا الصعود تتجسّد في سطوة الفكر الإخواني على الشارع العربي، وأخذ الإسلام السياسي يتغلغل ويتوغل في الجسد الاجتماعي العربي، وأخذ يقيم ويشيّد لنفسه اقتصاده السياسي الخاص، وأخضعت مجالات التعليم والثقافة والفكر لهذا الاتجاه.
انضم الإخوان ومن هم على هواهم وشاكلتهم، أو من هم من تفرعاتهم وتفريخاتهم، أو تحت عباءتهم للحلف الأميركي لمحاربة الشيوعية، خصوصاً بعد التدخل السافر للسوفيات في أفغانستان، وبعد هزيمتهم هناك، وبعد أن سقطت القلعة السوفياتية والكتلة الشرقية وانهار النظام العالمي في مصلحة الحقبة الأميركية.
استفادت جماعة الإخوان من حالة «المظلومية» التي ولّدتها حالة الفساد والاستبداد العربي لتعزيز مواقعها، وتحولت إلى قوة كبيرة مؤهلة لقطف ثمار أي تغيرات وتحولات كانت حتمية بالمقارنة مع حالة العجز التي وصلت إليها الدولة العربية العاجزة والفاسدة والفاشلة، والتي حولت مشاريع النهضة والتنمية إلى مشاريع خاصة لنخب التحالف السياسي الذي مثله اندماج المصالح وتداخلها ما بين أجهزة الأمن والطغم الاقتصادية والمالية في الإقليم العربي.
عندما حلّ «الربيع العربي» وجدت جماعة الإخوان المسلمين أن فرصتها التاريخية قد دقت ساعتها، ونزلت إلى الشارع للسيطرة عليه، وجهّزت نفسها للانقضاض على الحالة الجماهيرية المناهضة للأنظمة المستبدة وتحالفت مع الغرب للنيل من الدولة الوطنية، ولوقف تحول الحالة الجماهيرية إلى مرحلة ديمقراطية حقيقية، ولكي تحول دون إحداث تغيرات سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية تتجاوز رؤية وبرامج الجماعة، ولكبح جماح التطور نحو إعادة بناء النظم السياسية باتجاه التغيير الحقيقي للواقع العربي.
هذا السلوك الإخواني أفضى إلى تحالفهم مع الجماعات الإسلامية المتطرفة، وتحولت هذه الجماعة بصورة سريعة للغاية نحو عسكرة الحالة السياسية كأداة لأخونة المجتمع وفرض رؤية الإخوان على الشارع والأحداث.
كان هذا هو حال الإخوان في مصر، وكان سلوكها هو وضع البلاد على حافة الانهيار الداخلي، ووصلت الأمور إلى فتح معركة «مبكرة» جداً مع كل مؤسسات الدولة المصرية القضائية والأمنية والإعلامية والثقافية، وصولاً إلى رهن البلاد للغرب وبعض مقاولي الغرب في المنطقة العربية.
هكذا كان الأمر في معظم البلدان العربية، أيضاً.
وباستثناء الحالة المغربية وإلى حد ما الأردنية، دخل الإخوان في لعبة «التضحية» بوحدة البلاد وتماسك النسيج الوطني والاجتماعي، ورهن مقدرات الشعب والوطن والاستقرار الاجتماعي لمشاريع الغرب التفتيتية، بهدف «ضمان» دعم الغرب للجماعة في الإمساك بزمام السلطة السياسية في البلاد العربية التي طالها الحراك الجماهيري.
حاول الإخوان في تونس، وخصوصاً في المرحلة الثانية من الحكم أن يميزوا أنفسهم عن هذا النهج الإخواني المدمر، ولكن افكار الغنوشي لم تكن بعد قد انتصرت بالكامل، ولم يكن حزب النهضة التونسي قد حسم طريقه الجديدة، ولم تكن الظروف قد نضجت بالكامل للإعلان عن شق الطريق الجديد.
راهن الغرب على هذه الجماعة لأسباب أربعة معروفة: الأول، قوة الإخوان. والثاني، قدرتهم على محاربة التطرف من مواقع دينية وفكرية إسلامية. والثالث، عدم وجود أية برامج اقتصادية واجتماعية من شأنها الاختلاف مع النهج النيوليبرالي لإدارة الاقتصاد الوطني، وأما الرابع والأخير والهام، فهو الاستعداد «للتعايش» مع إسرائيل ومتطلبات أمن إسرائيل.
اعتقد الغرب في ظل نهم الإخوان للسلطة، وفي ظل استماتتهم للتحكم بالمجتمعات العربية أن الفرصة التاريخية لإعادة رسم الخرائط في منطقة الإقليم أصبحت سانحة، طالما أن القضية الوطنية قد نُحيّت جانباً، بل واعتقد الغرب أن فرصة إقامة الكيانات العربية على أسس دينية وطائفية ستمهد الطريق لتجديد «شباب» المشروع الصهيوني من خلال الدولة «اليهودية»، وصار بحكم الوارد إن لم نقل بحكم المؤكد ممكناً إعادة «هندسة» المجتمعات العربية وفق مفهوم المواءمة ما بين الأمة والدولة والدين، وما بين الدولة والأمة والعرق، أو الدولة والأمة والطائفة أو حتى المذهب.
انهار هذا المخطط بعد الثلاثين من يونيو في مصر وانهار بعد الاستفاقة التي شهدتها تونس اثر تعثر تجربة النهضة هناك، وانهار بعدما تحولت تركيا من النموذج المدني إلى النموذج السلطاني، وتراجع حزب العدالة والتنمية عن الكثير من التصورات التي كان قد طرحها كطريق «جديد» ونموذج «مختلف» لـ «الإسلام السياسي»، وبعد أن تسيد أردوغان وأصبح هو المرشد الحقيقي للجماعة بعد اجتماع استنبول الذي أشير إليه.
فبعد أن كان أردوغان يطرح تميزه عن باقي فصائل الإخوان بأنه يرى في الإسلام حالة ثقافية وليس أيديولوجيا سياسية ـ كاتب هذه المقالة سمع من اردوغان هذا النص شخصياً مع بعض الزملاء الصحافيين الفلسطينيين الذين كانوا في زيارة لتركيا بدعوة من مكتب رئيس الوزراء التركي آنذاك ـ فقد ارتدت التجربة التركية بصورة درامية، وهو الأمر الذي أدى إلى بلورة قناعة راسخة عند الشيخ الغنوشي بأن القطع الكامل مع هذا النهج هو الطريق الوحيد القادر على إحداث فرق حقيقي في كامل هذه المعادلة الغنوشية هل هي حالة أم اتجاه؟
أغلب الظن أنها ما زالت حالة، ولكن أغلب الظن، أيضاً، أن الواقع سيزكّي هذه الحالة للتحول إلى اتجاه. بهذا المعنى فإن الشيخ راشد الغنوشي هو رائد، وهو مفكر ملتزم، ومجدد كبير أعاد الاعتبار للوطنية التونسية في ظروف استثنائية، وأعاد الاعتبار للفكر الإسلامي نفسه.
تُرى هل سيكون الشيخ راشد الغنوشي هو محمد عبده في القرن الواحد والعشرين؟، وهل ستعيد أفكار الغنوشي الاعتبار على ما يجب أن يكون عليه الفكر الإسلامي؟!!
هذه هي المراهنة، مع أن ما أقدم عليه هذا المجدد الكبير وما نظّر له حتى الآن تضعه في مصاف المفكرين العظام. أما ردود الأفعال الأوّلية على أفكار الغنوشي فإنها تؤكد على ذلك، وتوحي بأن هذه الأفكار باتت تهدد بعض العروش الفكرية والسياسية لتيار لم يفهم قيمة الوطنية في مسار تطور الشعوب.
فعندما يقول الغنوشي للإخوان: اتقوا الله في أوطانكم، وتراجعوا عن هذا النهج المدمر فإن هذا الشيخ المجدد يكون قد سدّد للإخوان ضربة موجعة سيكون لها ما بعدها في عموم المنطقة.
أما قوة المجتمع المدني في تونس والإرث الذي تركته البورقيبية الاجتماعية مجسّدة بمظاهر ليبرالية حقيقية فقد تركت بصماتها في هذا التحول الهائل.