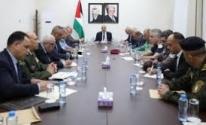ليس من السهل استطلاع وتحليل مرحلة تاريخية لم تكن شاهداً لأحداثها، بل سمعت وقائعها أو قرأت عنها من أحد أطرافها، وخاصة في سياق اختلاف الرواية والرؤية والاصطفاف الفصائلي. وحتى لا نظلم أنفسنا ونظلم التاريخ والوطنية الفلسطينية، فإن علينا - كإسلاميين في قطاع غزة - أن نعترف بأن جلَّ اهتمامنا خلال تلك المرحلة التأسيسية في مطلع الخمسينيات لنشأة الحركة الإسلامية كان مرتكزاً على فكر الإمام حسن البنا (رحمه الله) ورؤية حركة الإخوان المسلمين، والتي كان جوهر عملها في تلك الفترة منصباً على تثبيت أركان الرؤية الإسلامية لمشروع استنهاض الأمة، والذي كان المشهد الإسلامي غائباً فيه، بالرغم من التضحيات الكبيرة التي قدَّمها الإخوان المسلمون في العديد من ساحات النضال من أجل التحرر والاستقلال.
كانت نهاية الخمسينيات هي لحظة المخاض للحركة الوطنية، والتي كان الكثير من قياداتها أصحاب توجه إسلامي، وللعديد منهم ارتباط تنظيمي بحركة الإخوان المسلمين على الساحة الفلسطينية، حيث حاولت هذه العناصر الإسلامية المنضوية داخل التنظيم الإخواني، والمتواجد أكثرهم – آنذاك - في دول الخليج، التواصل فيما بينهم، بهدف التحرك لإيجاد آلية نضالية للعمل الفلسطيني في الداخل والخارج، من خلال إعادة هيكلة التنظيم الإخواني أو عبر إطار وطني مستقل، وتكون تحركاته بمثابة الواجهة النضالية للعمل الإسلامي الفلسطيني على المستويين السياسي والعسكري باتجاه مشروع التحرير والعودة.
جرت في تلك الفترة مكاتبات وحوارات ساخنة بين المستويات القيادية في الحركة، ولكنها لم تكلل بالنجاح؛ لاعتبارات كان لها علاقة بالخوف وفقدان الثقة بمصداقية النظام العربي، وتضاؤل منسوب التفاؤل بإمكانيات دعمه للحراك الفلسطيني المقاوم.
ومع اختلاف الرؤى وغياب الاتفاق بين الطرفين من أبناء الحركة الإسلامية، خرجت وجوه عديدة وركائز أساسية من الحركة وحسمت قرارها بتأسيس حركة فتح، وكان من بينهم الشهيدان: خليل الوزير، وأبو يوسف النجار (رحمهما الله) وآخرون.
كان هذا التوجه الذي انطلقت به حركة فتح في يناير 1965 بمثابة انشقاق على الرؤية التي كان يمثلها التنظيم الإسلامي الفلسطيني، والتي تمحورت حول مسألة الانتماء للإخوان المسلمين، واعتماد نظرتهم لفلسطين كونها أحد قضايا الأمة الإسلامية، ولها الأولوية في العمل من أجل تحريرها، ولكن درجة التفاعل بهذه القضية مرتبطة بالدرجة الأولى بحال الأمة العربية والإسلامية، وهي تحتاج إلى الكثير من الجهد والحشد والتعبئة لتحريك طاقات الأمة على المستويين الرسمي والشعبي لمواجهة إسرائيل، ومدافعتها عسكرياً على أكثر من جبهة عربية، وهذا يستدعي بالطبع جهوزية لم تكن توفرها سنوات الحراك الإسلامي في الخمسينيات والستينيات؛ لأن العمل التنظيمي الوطني والإسلامي كان – آنذاك - في بداياته.
نكسة 67: بداية التحول
قبل العام 1967، لم تكن أعداد الإخوان المسلمين في فلسطين كثيرة، وكان أغلب رجالات الحركة الإسلامية من كبار السن، فيما الشباب الفلسطيني كانت انتماءاته معظمها محسوبة على الخط الناصري أو التيار القومي العروبي.
ومع الهزيمة المدوية عام 67، كانت الصدمة التي لم يعد من هولها أحد يثق بالنظام الرسمي العربي، وبدأ الشباب مشوار البحث عن البديل، الذي سيعيد لشعبنا حقه السليب.
وسط هذا التيه، ظهر دعاة الإخوان المسلمين، وقدَّموا رؤية جديدة لمشروع التحرير والعودة، واعتبروها البديل للمشروع العربي، الذي أطاحت به الهزيمة وعجَّلت برسم معالم نهايته.
ومع احتلال قطاع غزة في يونيو 1967، كنت أنا وجيلي من الشباب الفلسطيني ننتمي فكرياً للتيار الناصري، والذي أصيب بطعنة قاتلة جراء الهزيمة، الأمر الذي دفعنا للبحث عن بديل يعمق من انتمائنا الديني والوطني تجاه أرضنا المباركة، ويعزز من حراكنا النضالي في وجه الاحتلال.
في الحقيقة، نشأت مع هذه الانتكاسة والهزيمة العسكرية حالة من الفراغ الوجداني والأيديولوجي بين الشباب، وكان لا بدَّ من العمل على ملئه، حيث إن الطبيعة ترفض الفراغ، فجاء من يتلقفنا بخطاب ديني مشبَّع بعاطفة الحنين إلى الوطن والأيدولوجيا، ويوجهنا لما يراه طريق التمكين والخلاص الوطني.
من هنا، وبعد النكسة مباشرة، كان هناك اقبال شبابي واسع على الفكر الإخواني، وخاصة مع داعية متميز كالشيخ أحمد ياسين (رحمه الله)، والذي بحركيته الدعوية نجح في استقطاب الشباب في معظم أرجاء قطاع غزة، بل امتدت دائرة نشاطه إلى داخل الخط الأخضر، وكذلك مع الإخوة في الضفة الغربية.
كان من بين هؤلاء الشباب الإخوة فتحي الشقاقي وموسى أبو مرزوق وإسماعيل أبو شنب وعبد العزيز عودة وابراهيم المقادمة وآخرون، والذين أعطوا للحراك الدعوي في أوساط الشباب حيوية ورغبة في الانتماء للمشروع الإسلامي، وقد شاهدنا ثمارها في السبعينيات مع المئات الذين ذهبوا للدراسة في مصر، ثم عادوا ليقودوا الحركة الإسلامية في قطاع غزة، ومثلهم كذلك في الضفة الغربية.
كان جلُّ اهتمام الشباب الإخواني يدور في إطار الرؤية الإسلامية العامة، والتي تتحدث عن محطات التمكين وما سيعقبها من توجيه البوصلة باتجاه التحرير بجهد إسلامي أممي عظيم، حيث سيكون الفلسطينيون هم طليعته أو (رأس النفيضة) فيه.
نعم؛ تعاظم الكسب الإسلامي على مستوى الحركة والتنظيم، ولكن الرؤية في مشهد حراك التحرير لم تكن واضحة. من هنا، بدأ الشباب في التململ.. ومع منتصف الثمانينيات، كان أول خروج لمجموعة من هؤلاء الشباب المخلصين قاده د. فتحي الشقاقي، القيادي والمفكر الرسالي، الذي كان – آنذاك - أحد أركان ديناميات العمل التنظيمي، وربما الشخص الأهم من ناحية الوعي وطرح الرؤي والأفكار، والذي أوجد مساحة لإيصال صوته ورؤياه عبر مجلة المختار الإسلامي (المصرية)، ومجلة الطليعة الإسلامية.. وقد نجح د. الشقاقي (أبو إبراهيم) في إيجاد تعاطف جماهيري عربي وإسلامي مع أفكاره، وكان بمثابة الحاضنة التي أمدت توجهاته بالقوة والزخم والشعبية، فقام بتأسيس حركة جديدة تحت اسم "حركة الجهاد الإسلامي". ونظراً لضخامة التنظيم الإخواني، فإن هذا الخروج لم يؤثر كثيراً على الحركة في قطاع غزة، وإن شكل احراجاً كبيراً لها.
انتفاضة الحجارة: شرارة الوعي الإسلامي
مع انتفاضة 87، بدأ الوعي الإسلامي في التحرك بخطوات أسرع باتجاه المواجهة مع الاحتلال، حيث تمكن الإسلاميون أن يكونوا أحد أعمدة الانتفاضة مع إخوانهم في الحركة الوطنية.. لا شك أن اتفاق أوسلو - والذي جرى توقيعه في واشنطن عام 1993 - جاء بدون توافق وطني، وقد أثرَّ بشكل سلبي على علاقات الإسلاميين بالسلطة الوطنية، وحرف بوصلة النضال باتجاه الصراع الداخلي، ومحاولة كل طرف إثبات الوجود، والتأكيد على رؤيته في مشروع التحرير والعودة.
حاول الرئيس ياسر عرفات (رحمه الله) استمالة الإسلاميين إلى جانبه، متخذاً من سياسة العصا والجزرة أداة لذلك، وإن كان أبو عمار (رحمه الله) ميَّالاً أكثر للتعامل بمرونة معهم، ولكنه لم يتمكن من تطويعهم بعروضه لهم للمشاركة أو الشراكة السياسية، مما اضطره في النهاية للدخول في مواجهة معهم عام 1996، الأمر الذي أدَّى إلى توتير الساحة وإضعاف الجميع، وأعطى لإسرائيل كل الذرائع للتهرب من استحقاقات أوسلو، وتحريك "الفتنة" بين أبناء الوطن الواحد، ليدخلوا من خلال التعبئة الخاطئة في موجة من القتل والقتل المضاد.
أدت تلك السياسة القمعية والتصعيد الميداني إلى توتير العلاقة وتأزيمها، ودخلنا في أتون المعادلة الصفرية؛ "إما أنا، أو أنت"!! حيث دفعنا جميعاً كلفة معارك جانبية لم ينتصر فيها إلا المحتل الغاصب، وغابت في سياقات هذا الاحتقان والكراهية أصوات الحكمة، وضاعت مع "يقظة الفتنة" وجنوحها طموحات شعبنا في التحرير والعودة.
الانتخابات التشريعية: محاولة لم تكلل بالنجاح
في 25 يناير 2006، جرت الانتخابات التشريعية، وجاءت نتائجها لتعطي حركة حماس الصدارة التي لم يتوقعها الكثيرون، وكانت الصدمة والذهول لمن هم في مشهد الحكم والسياسة من حركة فتح.
أخذت المناكفات السياسية تتعالى أصواتها، واشتدت وتائر التحريض والقتل!! ومع غياب الوعي بالعواقب والمآلات، جرفتنا الفتنة إلى ارتكاب خطيئة الانقسام، والتي لم نتطهر جميعاً من آثامها بعد.
مرت أكثر من عشر سنوات عجاف على الانقسام، وكان الحصاد هشيماً تذروه الرياح، لم نتداول حواراُ جاداً له علاقة بمشروعنا الوطني، ولا حتى بالمشروع الإسلامي، واستنزفنا الانقسام وأوغر صدورنا وملأها بالحقد والكراهية تجاه بعضنا البعض، وراكم من البغضاء ما يحتاج إلى معالجات نفسية لجيل أصابته أهوال الصدمة بالإحباط واليأس والقنوط.
المشروع الوطني: الورقة الغائبة عن النقاش
في أكثر من مناسبة طرحت حركة حماس أفكارها عن الشراكة السياسية، بل واجتهدت في عرض مبادراتها السياسية للتوافق مع الكل الوطني، ولكن - للأسف - كان يبدو أن لكل من طرفي الانقسام حساباته ومخاوفه تجاه الآخر، حيث غابت الثقة وابتعدت القناعة، وصار الرهان على من يستسلم أولاً أو تتداعى أركان قيادته بضغوط لا تقدر على تحملها.
جاءت الكثير من المبادرات، والتي لم تبخل بها جهة نضالية أو دولة صديقة، وحتى الأوروبيون هم الآخرون لم يترددوا عن طرح المبادرات لإقالة عثارنا السياسي، ولكن دون جدوى!!
وثيقة حماس الجديدة: فرص التقارب والالتقاء
في يونيو 2017، عرضت حركة حماس وثيقتها السياسية الجديدة، والتي ظهر فيها أن رؤية الحركة آخذه في التقارب مع الاطروحة التي يجسدها المشروع الوطني الفلسطيني، وأن ما كان يباعد بيننا في خريطتنا النضالية قد تمَّ جسر الهوَّة حوله، وبالتالي فإن سياقات الشراكة السياسية والتوافق الوطني أصبحت قاب قوسين أو أدنى، وأن المطلوب الآن من الطرفين (فتح وحماس) هو حُسن النوايا والإرادة السياسية الصادقة لكي نضع خلافاتنا جانباً، ونبني في ظل هذا التوافق في الرؤية النضالية مصالحة تاريخية، تمنح بوصلتنا أرضية مستقرة، وبرمجة لا تنحرف مساراتها عما تضمنه المشروع الوطني والرؤية الإسلامية التي تجمعنا؛ باعتبار أن القدس هي عاصمة دولتنا الفلسطينية، والتعبير الوطني عن هويتنا الدينية والسياسية الجامعة.
نعم؛ قد يحتاج الإسلاميون (حماس والجهاد) إلى إلقاء نظرة فاحصة على بنود المشروع الوطني، والذي سيجدون فيه الكثير مما لم تلتقطه عيونهم، بسبب استحواذ ما لديهم من رؤية تضمنتها الخريطة الإسلامية في إطارها الأممي، والتي كانت فلسطين فيها هي مجرد "قضية" في سياق الهمِّ الإسلامي العام، وإن كانت مركزية تلك "القضية" حاضرة بقوة في الفكر الإسلامي وحركيته النضالية.
في الحقيقة، نحن اليوم أقرب للاتفاق على رؤية ركائزها المشروع الوطني، مع تعديلات تناسب تطور حراكنا السياسي بعد أوسلو، ومستجدات فعلنا النضالي السلمي، والتفاعل العالمي مع مسيرات العودة الرافض لمنطق التغول الإسرائيلي والسياسة الأمريكية، التي تجاوزت بانحيازها لإسرائيل كل القوانين والشرائع الدولية، وطعنتنا بأعز ما نملك حين اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقامت بنقل سفارتها إلى هناك.
الإسلاميون: مقاربة سياسية
كما سبق أن أشرت، فإن الكل قدَّم مبادرات لإصلاح ذات البين ووأد الفتنة، وآخرها مبادرة الأمين العام الجديد لحركة الجهاد الإسلامي الأخ زياد النخالة، وهو تطور إيجابي باتجاه حركية الوعي المطلوبة من الإسلاميين.
أعتقد أننا أمام معضلة حقيقية تهدد وجودنا، ولا حلَّ لها إلا بتحرك الأخ الرئيس (أبو مازن) بخطوة إيجابية باتجاه قطاع غزة، حيث ستجد كل المشكلات طريقها للحل.
أتمنى أن يكون اجتماع المجلس المركزي القادم حاسماً في التأكيد على المصالحة وانهاء الانقسام، بعدما تأكد للكل الفلسطيني خسارة الرهان على السلام مع هذا المحتل الغاصب، حيث إننا وبعد مرور ربع قرن على توقيع اتفاق أوسلو، وما آلت إليه الأوضاع السياسية من خيبة وفشل، لم يعد أمامنا إلا أن نستمر في مقاومتنا للاحتلال، واطلاق يد شعبنا في كافة أرجاء الوطن المحتل لممارسة حقه في المقاومة بكافة أشكالها، وخاصة السلمية منها، وإسماع العالم صوت المظلومية الفلسطينية، للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها، وتحقيق حلمنا في دولة فلسطينية مستقلة أو في دولة واحدة لكل مواطنيها، والتي سيجد فيها كل فلسطيني في الوطن والشتات متسعاً لحق العودة والإقامة والعيش الكريم.
نهاية حرب أم عملية سياسية جديدة؟
12 أكتوبر 2025