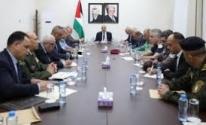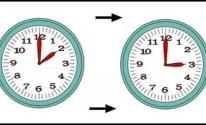كما لا نستطيع تعداد أسماء الأبطال الشهداء، لا نستطيع تعداد أسماء الأسرى الأبطال، وإن كنا نحتفل بهم حين يقدمون نموذجاً في البطولة، وقت توهج بطولاتهم، ثم يتحولون بفعل فاعل إلى مجرد أرقام، فإن التاريخ سيكفل لهؤلاء جميعاً، حقوقهم، واستظهار أدوارهم وتضحياتهم في مسيرة الكفاح من أجل تحقيق تطلعات الشعب. مسألة تذكُّر، وإحياء ذكريات الأبطال، هي قضية بحد ذاتها تغرز الأصابع في عيون كل من يدّعي، أن تكريم الكبار منهم على الأقل، قد استمر كما كان الحال جزءاً من الثقافة الوطنية وجزءاً من التربية الوطنية، وتعبئة الأجيال.
البعض من مقامات المسؤولية الوطنية الفاعلة بات يتعاطى مع هذا الملف، بكل محتوياته، وكأنه ينتمي إلى ثقافة بائدة، لا تصلح في زمن ثقافة اوسلو، وزمن الانقسام والتردّد، والبحث دون طائل عن سلام موهوم.
فيما يخوض الكل في نقاشات تبدو غير مجدية رغم حرارتها، وجديتها، وعمقها، في كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني الراهن، تشخيصاً، وتحليلاً، واستنتاجات، ونصائح، يقدم لنا الأسرى الأبطال نموذجاً آخر، ينطوي على أبعاد قيمية تستحق أن يتمثلها المسؤول قبل المواطن، ذلك أن فيها من الدروس ما يستحق أكثر من مجرد الاحتفال، واطلاق الخطب، والتصريحات.
محمد علان، آخر ما يرد في القائمة التي سبقه فيها خلال الفترة القصيرة الماضية، ولم نعد قادرين على تجاهلهم كان الشيخ خضر عدنان، والعيساوي، الذين قهروا السجّان، وأرغموه على الانصياع لإراداتهم الفذة.
ما يستحق الاستظهار في النماذج التي يقدمها هؤلاء الأبطال، يتجاوز الأبعاد الذاتية الخاصة بكل منهم، إلى قيم مؤهلة للتعميم ليس وسط الحركة الأسيرة وحسب بل والأساس، وسط قيادات الحركة الوطنية، وصناع القرار.
في سابق عقود النضال، سطرت الحركة الأسيرة بالدم والعرق والصمود، والتضحية صفحات ناصعة في تحدي السجان، والصمود أمامه وفي تحقيق العديد من الإنجازات، وكانت في بعض المراحل تقود الشارع الفلسطيني في محطات المجابهة الواسعة مع الاحتلال.
أول الدروس التي ينبغي استخلاصها وتعلمها، قوة الإرادة ووضوح الهدف. الأبطال محدودو العدد الذين خاضوا الإضرابات وقاتلوا بأمعائهم الخاوية، سجلوا أن أهدافهم تتمثل في الحرية وفي قهر إرادة وقوانين السجان، حتى لو أدى ذلك إلى الاستمرار في الإضراب حتى الموت، ما يعكس صلابة الإرادة وقوة التحدي.
لقد قرروا النجاح في تحقيق الأهداف، فكان عليهم أن يعتمدوا أولاً وقبل كل شيء على صلابة إراداتهم، ثم على تضامن الحركة الأسيرة، والحركة الوطنية، والشعب الفلسطيني.
قررت الحكومة الإسرائيلية قانون التغذية القسرية للمضربين لا لأنها فقط، تخشى من استشهادهم، ما يشكل لها فضيحة أخرى، وإنما أيضاً لقهر إراداتهم، لكي لا يتكرر النموذج فيصبح ظاهرة عامة واسعة.
فشلت الحكومة في تجربتها الأولى، بعد غياب طويل لتجربة سابقة كانت أدت إلى استشهاد القائد عبد القادر أبو الفحم، واضطرت إلى الإذعان والانكسار أمام النموذج الحديث الذي يقدمه محمد علان.
تعرف إسرائيل أن سجونها الظالمة، تضم آلاف النماذج مثل محمد علان ومن سبقوه، ولكنها كلما أبدعت في وسائل القهر، أبدع أبطال الحركة الأسيرة في تقديم سبل الرد والتحدي.
أتساءل في كثير من الأحيان عما إذا شهدت حركات التحرر الوطني العالمية، نماذج لإضرابات تتجاوز المدد الطويلة التي أضربها الأسرى الفلسطينيون، وأسأل الأطباء، عن تفسير علمي لهذه الظواهر.
في زمن سابق، خاضت الحركة الأسيرة إضرابات شاملة أدّت أغراضها في حينه، لكن الزمن وتغير الظروف، دفع الأسرى، لابتداع أشكال من النضال تقوم على الإرادة الفردية كوسيلة لإلحاق الهزيمة بسياسة السجّان، وقوانينه ومؤسساته السياسية والأمنية والحقوقية.
في السجون يتعلم الأسرى، ويحصلون على شهادات أكاديمية من كل المستويات، وذلك ليس منّة من السجان، بل انه شكل آخر من اشكال الخضوع لإرادة الأسرى، حققوا خلالها الانتصار في جولات سابقة من المجابهة.
نحتاج إلى من ينبش التاريخ، ونقصد تاريخ الحركات الوطنية التحررية، أو حتى الإنسانية. أين يمكن أن يعثروا على تجربة شبيهة بتجربة الحركة الفلسطينية الأسيرة في مجال التواصل الإنساني مع أهلهم. نقصد هنا الإبداع في تحقيق الإنجاب، من خلال تهريب نطفهم إلى زوجاتهم اللواتي لا يعانين العقم ولكن بسبب غياب الزوج. لسنا أمام تجربة واحدة، وإنما تجاوز العدد الثلاثين حالة، ما يؤكد قدرة الفلسطيني على الإبداع وقهر الظروف وتطويع المستحيلات. والآن اسألوا قيادات العمل الوطني الذين يديرون السياسة الفلسطينية، عما يحتاجونه من مثل هذه القيم، وعما إذا كانوا مستعدين لتمثل هذه النماذج الرائعة.
ما ينقص قيادات العمل الوطني ...
نشر 27 اغسطس 2015 | 09:42