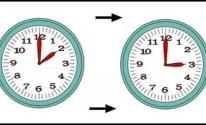يبتهج عشرات الآلاف من الخريجين هذه الأيام بمغادرة مقاعد الدراسة والانتهاء من حياة الجامعة أو الكلية والانطلاق الى واقع الحياة، حيث بدأت مؤسسات التعليم العالي هذه الأيام، احتفالات التخرج من حملة الشهادات في مختلف التخصصات، وبالطبع فإن من حق الخريجين أن يفرحوا بعد الانتهاء من التعب ومن المعاناة خلال سنوات الدراسة.
ولكن ومع الانتهاء من زخم الاحتفال، يبدأ الخريجون إرسال الطلبات الى المؤسسات والشركات والدوائر وحتى الوزارات المختلفة، بحثا عن فرصة عمل، وذلك لترجمة ما تم الاستثمار فيهم، الى سوق العمل المقيد والجامد والخامل، في ظل اقتصاد مقيد وضعيف النمو ويعتمد على الآخرين. وبعد فترة من البحث يكتشف الخريجون، ما هي الإمكانيات والفرص وطبيعة احتياجات السوق وشحة إمكانياته، ليبدؤوا تلمس ومعايشة البطالة والتي ترتفع نسبها في بلادنا.
وتشير الأرقام التي تم نشرها حديثا، إلى ان نسبة البطالة الحالية في فلسطين تبلغ حوالي 26%، أما عند فئة الشباب بالتحديد، فقد تصل نسبة البطالة الى حوالي 41%، وحسب الأرقام او المعطيات، فللحفاظ على النسبة الحالية من البطالة، نحتاج الى استحداث أو فتح حوالي 650 ألف وظيفة خلال العشر سنوات القادمة، أي بمعدل حوالي 65 ألف فرصة عمل سنويا.
ونحتاج كذلك الى نمو اقتصادي سنوي يقدر بحوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك فإذا استمر التصاعد الحالي في نسبة البطالة بنفس الوتيرة، فقد نصل الى أكثر من مليون فلسطيني عاطل عن العمل بحلول العام 2030، وفي نفس المنوال ومن اجل إنقاص البطالة في بلادنا الى نسبة الـ 10%، نحتاج الى خلق أكثر من مليون فرصة عمل منذ الآن وحتى حلول العام 2030
ومعروف أن أحد الأهداف الرئيسة لمؤسسات التعليم العالي في العالم ومن ضمنها بلادنا، من المفترض أن تكون المساهمة في سد حاجة المجتمع وتغطية النواقص المختلفة من خلال رفد القطاعات المختلفة، بالأيادي المتعلمة أو المدربة، من أجل البناء والتنمية والتقدم، وبالتالي من المفترض أن تتداخل فلسفة وأهداف التعليم العالي مع حاجات المجتمع من خلال قطاعاته المختلفة، ويقوم المجتمع بدعم التعليم العالي ويقوم التعليم العالي برفد المجتمع بما يحتاجه من الأيادي المدربة المتعلمة، والتي من الممكن ان تكتسب مهارات الإدارة والقيادة.
ودون شك ان مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني، بمستوى شهاداتها المختلفة، من دبلوم وبكالوريوس وماجستير وفي بعض التخصصات الدكتوراة، وبالتخصصات المتشعبة التي تحويها، من علم الاجتماع الى الهندسة والصيدلة والطب والعلوم والآداب وحتى التربية، والتي نجدها مكررة في معظم الجامعات الفلسطينية، هي الجهة الرئيسة التي تتحمل المسؤولية عن تردي وانحدار وضع كهذا، من حيث ضعف التخطيط والإرشاد وعدم التركيز كأولوية على النوعية أو على مصلحة الطالب من خلال ربطها بحاجات المجتمع.
وقد بات الجميع يعي أن الوضع الحالي للجامعات يهدف بالأساس لاستقطاب المزيد من الطلبة وبالتالي المزيد من الدخل أو الرسوم، واصبح التركيز اكثر على كيفية حل الأزمة المالية التي تعاني منها الجامعات، عن طريق قبول المزيد من الطلبة وبالتالي المزيد من الأقساط، وتم تناسي ان نسبة البطالة عند خريجي العديد من التخصصات تزيد على 50% وربما تصل الى حوالي الـ 80%، وان هذه النسبة تزداد مع الزمن، وتزداد معها مضاعفات عدم إيجاد عمل، سوء أكانت مضاعفات اجتماعية او اقتصادية أو نفسية وغيرها.
وفي خضم اصطفاف عشرات الآلاف من الخريجين من مؤسسات التعليم العالي، فإن من الأخطاء التي ما زلنا نرتكبها، هي النظرة غير الموضوعية الى التعليم المهني او الى التعليم التقني، او الى التعليم غير الجامعي التقليدي او الكلاسيكي، والذي هو من المفترض وفي الوقت الحالي ان يكون أهم واكثر فعالية من التعليم الجامعي التقليدي في بلادنا. وهو الذي تستثمر فيه الدول المتقدمة الجزء الأكبر من الطاقات والأموال، والذي يقبل عليه الكثير في هذه الدول، والذي يجد خريجوه الفرص ويساهمون في تطوير المجتمع وسد حاجات البلد، ورغم الحديث المتواصل عن أهمية التعليم المهني، إلا ان القليل قد تم عمله من اجل تشجيع الإقبال على هذا التعليم او خلق الفرص والإمكانيات، او من خلال تغيير نظرة الناس إليه، من اجل تشجيع الطلبة للتوجه نحوه، ومن ثم ربطه، سواء من حيث الكم او من حيث النوع مع احتياجات المجتمع.
ومع تواصل تدفق آلاف من الخريجين في تخصصات لا نحتاجها، وبالتالي انضمامهم الى أفواج البطالة، فإن هذا يدل ودون شك على عمق الفشل وعلى كل المستويات في ربط الاستثمار في التعليم بأنواعه المختلفة، وبالأخص التعليم العالي، مع متطلبات سوق العمل، وبمعنى آخر هذا يعني خسارة الاستثمار من وقت ومن أموال ومن تعب ومن جهد.
وحسب الأرقام المتوفرة، فإن نسبة كبيرة من الخريجين وبالتالي من العاطلين عن العمل، هم من النساء الفلسطينيات، وهذا يوضح عمق المأساة التي تعيشها المرأة الفلسطينية المتعلمة، مع العلم ان نسبة الطالبات الخريجات في معظم الجامعات الفلسطينية تتجاوز الـ 65%، ولكن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل في بلادنا، ما زالت لا تتعدى نسبة الـ 15% فقط، ولا أدري كم تبلغ هذه النسبة عند الخريجات من مؤسسات التعليم العالي فقط.
وحسب احد الاستطلاعات لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، ارتفعت نسبة البطالة عند خريجي المعاهد والكليات والجامعات الفلسطينية الشباب، من حوالي 42% في العام 2007 الى حوالي 56% في العام 2017، وتصل نسبة البطالة عند خريجي بعض التخصصات الى حوالي 70%، أي ان حوالي 700 خريج من هذه التخصصات من مجموع 1000 خريج لا يجدون عملا، وبالإضافة الى ذلك أشار جهاز الإحصاء الى أن حوالي 30% من الشباب يعيشون تحت خط الفقر المتعارف عليه، وهذه الأرقام وغيرها مقلقة بكل المقاييس.
وبات من الأوضاع المؤلمة والمحبطة وبالأخص للخريجين المتحمسين للعمل، والذين نشاهدهم بعشرات الآلاف هذه الأيام، هو عدم إيجاد فرصة للعمل، سواء في القطاع الخاص وهو القطاع الواعد والذي يعول عليه في بلادنا وفي الكثير من بلدان العالم، أو في القطاع العام المثقل والخامل والراكد، الذي لا يستوعب من الموظفين الجدد إلا بقدر ما يغادره من موظفين سواء بسبب التقاعد أو غير ذلك من الأسباب، وفي ظل اقتصاد محدود ومقيد وتتلاعب فيه وفي إمكانية ومستوى نموه، الكثير من مصالح الأطراف الدولية والإقليمية وحتى المحلية، تتعمق مأساة الخريجين وفشل الجهات الرسمية.
وحتى في ظل حالة عدم الاستقرار والخوف عند رأس المال الخاص، والذي فقط يعمل وكما تشير أرقام الهيئات المختصة، على تكديس الملايين في البنوك بدلا من استثمارها وخلق فرص للعمل، أملا بأن تتغير الأوضاع ليتم ضخها الى الأسواق، في ظل كل ذلك أليس من الأجدر اتخاذ مبادرة أو مبادرات على الصعيد الوطني من أجل إنشاء مظلة حاضنة وبعقل إداري عصري يتلاءم مع الاحتياجات المحلية والعالمية، لإقامة مشاريع صغيرة إنتاجية مستدامة، سواء لشخص أو لمجموعة من الأشخاص، وقادرة على إبعاد شبح وتداعيات البطالة أو عدم العمل، من كافة النواحي.
حيث ان هناك العديد من المؤسسات، ومن ضمنها الدولية والإقليمية، تقوم بالعمل على محاربة أو الحد من البطالة، من خلال دعم تطبيق فلسفة «المشاريع الصغيرة الإنتاجية المستدامة»، أي المشاريع التي لا تنتهي مع نضوب الدعم او المنح، بل تستمر من خلال ناتجها الذاتي، وبل تنمو وتكبر وتتوسع، سواء من ناحية الكمية، او النوعية أي تتفرع الى أعمال أخرى، قد يكون لها علاقة ما بالعمل الأصلي او قد لا يكون.
واستراتيجية الدعم هذه، يمكن ان تتم من خلال الدعم المادي المباشر، أو من خلال التدريب، أو من خلال دراسات الجدوى، أو من خلال المساعدة في التخطيط والتقييم، أو من خلال كل هذه الأعمال معا، وهذه الاستراتيجية هي ما نحتاجه في بلادنا، إما لمحاربة الفقر، او للحد من البطالة، ومن المعروف انهما مترابطان.
وفي دول عديدة في العالم، وبالإضافة الى الأموال او الجهود المخصصة لمشاريع الحد من الفقر والبطالة، هناك صناديق استثمارية، سواء من أموال القطاع العام أو أموال القطاع الخاص، حيث تبحث هذه الصناديق عن الأفكار والأشخاص المبدعين او المحتاجين وتجذبها، وتوفر لهم الأموال اللازمة والبيئة الملائمة للنجاح واكثر من ذلك، وبالطبع هناك الحوافز التي يجب ان توفرها الجهات الرسمية، سواء أكانت تتعلق بالبنية التحتية او الضرائب او التسهيلات اللوجستية والمالية من اجل البدء بمشاريع الريادة، ولا داعي للذكر ان مشاريع الريادة هي بشكل عام مشاريع تتسم بالمغامرة.
وبالتالي علينا ان نهتم اكثر بالكفاءات البشرية التي تبحث عن فرصة للبدء بمشروع، وان نقدم لها التسهيلات، بدءا من المكان والبنية التحتية، وكذلك تخصيص الصناديق لذلك، ليس فقط للبدء بالمشروع ولكن كأحد الضمانات في حال الفشل، ولا يعني هذا ان الدعم والتشجيع يقع على الحكومة فقط، ولكن هناك دورا مهما للقطاع الخاص، ولمؤسسات الدعم العامة، في رعاية ودعم وتشجيع الإبداع والابتكار والريادة، والاهم اعتبار المشاريع الريادية الإنتاجية الصغيرة، وبصرف النظر عن حجمها او أهميتها إحدى الركائز المهمة لمكافحة البطالة وتداعياتها، سواء أكان خلال المدى القصير او الطويل، وسواء أكان ذلك للخريج الحالي أو لغيرهم من الخريجين الذين يحملون شهادات من شتى الأنواع والدرجات.
عن موسم الخريجين ومخرجات التعليم وسوق العمل
نشر 03 يوليو 2021 | 09:28