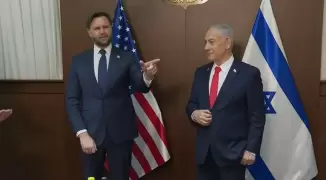يحلو لباحثين وكُتّابٍ كثيرين، ونحن منهم، أن يتناولوا، في مطلع كل عام، الأوضاع الفلسطينية المتقلقلة بالتأمل والتوقع، وتلفيق التنبؤات أحياناً. ومع أن دوران الوقائع في الزمان، في مثل هذه القضايا الشائكة، لا يخضع للمواقيت التي تعارف عليها الناس كرأس السنة الميلادية أو الهجرية، بل يخضع لتفاعلات الميدان السياسي وللمجال الجيو – استراتيجي وللإرادات السياسية معاً، إلا أنّ هذه المطالعة ستحاول أن تتقدّم بتقدير موقف في شأن قضية فلسطين في عام 2022، يتجنب الخضوع للمحطات الزمنية والسياسية، كالانتخابات الأميركية التي باتت محطّة مرذولة تُبنى عليها التوقعات والتنبؤات بصورة تكرارية لا خيال فيها ولا علم. ولا بأس في أن نضع قضية فلسطين في العام الجديد تحت الأنوار الكاشفة، لعلنا نتمكّن من تحديد المسارات التي يُحتمل أن يسلكها الفلسطينيون في معمعان هذا العالم المضطرب والمتلاطم والسديمي. وكلامي هذا لا يشبه ألبتة كلام العرّافين والعرّافات الذين تكاثروا خلال العقد المنصرم بصورة فِطرية، وملأوا شاشات التلفزة بطرائق مهينة للعلم وللتفكير العلمي وللإعلام الراقي معاً. ولعلني لا أتجاوز الحدّ إذا قلتُ إنني أقدّم هنا قراءة متبصرة ومختصرة إلى حد بعيد للخيارات التي سار عليها الفلسطينيون في الحقبة السابقة، وفي الخيارات التي يمكن أن تسلكها قضية فلسطين في المرحلة المقبلة.
لن أضيف أي جديد أو مفيد إذا كرّرت القول إن حال قضية فلسطين في عام 2022 ستكون مثل أحوالها في الأعوام السابقة مثل 2021 أو 2020؛ فهذا بديهي، لأن قضية فلسطين ما برحت تراوح في مكانها منذ عام 2014، حين توقفت المفاوضات مع إسرائيل، وهي لا تتقدّم إلى الأمام البتة. وأعني بـِ “التقدم” هنا المعنى الاستراتيجي، لا اليومي المتبدّد. إننا، في هذا الميدان، نهتز ولا نخطو، نكسب نقاطاً لكننا نعجز عن تحويلها إلى أوراق سياسية رابحة. ومن مفارقات هذه الحال أن الميدان الفلسطيني حيويٌّ جداً، ومفعمٌ بالإرادة والتحدّي بحسب ما نشهده في الخليل وفي القدس كالشيخ جراح وحي سلوان والمسجد الأقصى، علاوة على الصدامات اليومية مع المستوطنين، غير أن السياسات الفلسطينية “عويلة” وباهتة وغير مقدامة، بحيث يبدو كأن ليس لدينا من أوراق القوة غير صمود الشعب في أرضه، واستمرار مقارعته الاحتلال. وهذه الأوراق القليلة لا تسمح بتغيير موازين القوة بيننا وبين الاحتلال الإسرائيلي، لا في سنة 2022 ولا بعدها.
حركة حماس، خلافاً للصوت العالي الذي لا تنفك رافعة إياه، لا تمتلك غير ورقة “الأسرى الإسرائيليين”، وهي ورقة لا يعوّل عليها، خصوصاً أن اثنين من الجنود الإسرائيليين أشلاء، وواحد من الفلاشا، وواحد عربي بدوي. وهذا يعني أن قصة هؤلاء الجنود الأربعة لم تتطوّر إلى قضية رأي عام ضاغط بإلحاح على الحكومة الإسرائيلية. والسلطة الفلسطينية التي تمتلك ختم الشرعية لم تتمكّن، منذ انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن، من إرغام إسرائيل على العودة إلى طاولة التفاوض بالشروط التي اعتمدتها، وهي مرجعية اللجنة الرباعية (أميركا وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي)، لا مرجعية الولايات المتحدة وحدها؛ ووضع جدول زمني للمفاوضات، بحيث لا تكون مفتوحة إلى أمد غير معروف؛ وأن تكون الغاية من التفاوض متفقاً عليها سلفاً أي التوصل إلى دولة فلسطينية حرّة ومستقلة بحسب منطوق اتفاق أوسلو. ويبدو أن الوعود الأميركية التي كُشف عنها قبيل انتخابات الرئاسة الأميركية، كافتتاح قنصلية أميركية في القدس الشرقية، وافتتاح مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، واستئناف المساعدات المالية الأميركية للسلطة الفلسطينية ولوكالة غوث وتعليم اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والضغط على إسرائيل لإعادتها إلى طاولة المفاوضات، إنما هي وعود عامة لا تُنتج أي قيمة سياسية مضافة لمصلحة السلطة الفلسطينية، ولا تزحزح ميزان القوة عن موقعه، ولو قليلاً.
في السنوات العشر الأخيرة، منذ بدأت حركة الاحتجاجات العربية، صعدت الجماعات الاسلامية، ولا سيما الإخوان المسلمون، بقوة إلى مواقع الحكم، وصعدت معها وإلى جانبها، وعلى نقيضها أحياناً، جماعاتٌ إسلامانيةٌ إرهابية من طراز همجي راعب. لكن، لم يطل الأمر كثيراً حتى راحت تلك الجماعات تتهاوى بالتدريج وتتساقط، بعدما فشلت في الاحتفاظ بالسلطة بين يديها حتى قبيل أن تتمكّن من تطبيق برامجها ورؤاها، فسقط محمد مرسي في مصر لمصلحة الجيش، وانتهى عهد جماعة الإخوان المسلمين، وسقطت حركة النهضة في تونس لمصلحة الجيش ومصالح الأمن، وسقط حزب العدالة والتنمية في المغرب جرّاء سياسته الفاشلة بعدما قاد عملية التطبيع مع إسرائيل تجاوباً مع أوامر القصر الملكي. وفي ليبيا، انحسرت أدوار القوى الاسلامية، ولولا الدعم التركي المباشر لانطفأت تماماً.
قصارى القول، استناداً إلى سمات الواقع العربي التي عرضناها أعلاه، إن ما كانت تسمّى “جبهة شرقية” ما عادت موجودة على الإطلاق منذ زمن بعيد، وما عاد ثمة جيوش عربية في مواجهة إسرائيل. وحل في محل ذلك كله سياسات التطبيع المباشر التي تقاطرت على إسرائيل من المغرب والسودان والإمارات والبحرين خلال سنة واحدة، وتكاثر عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس ليصل إلى 900 ألف مستوطن، وهذه معضلة خطيرة جداً ستكون حاضرة بقوة في أي مفاوضات مقبلة، علاوة على أنها تشكل تحولاً قاتلاً في تقرير مستقبل القدس والضفة الغربية.
تجري التحولات في الميدان الدولي، للأسف، بمعزل عن قضية فلسطين. وهذه التحولات إنما هي مسارات منفصلة في أسبابها، لكنها متداخلة في نتائجها. وتحوطنا اليوم ثلاثة مسارات رئيسة هي: روسيا و”الناتو” والهجوم المضاد في أوكرانيا؛ الصين وصراعها مع الولايات المتحدة في جنوب شرق آسيا وفي المحيط الهادي؛ إسرائيل والولايات المتحدة والبرنامج النووي الايراني. المسار الثالث هو الذي يهمنا بالدرجة الأولى، لأنه يؤثر فينا مباشرة، وتنعكس عقابيله على قضايانا بقوة. وفي سياق هذا المسار، تبدو قضية فلسطين غير حاضرة بجدّية البتة، بل يكاد حضورها يماثل الشبح في التصورات الحكائية. وخلافاً للكلام بالصوت العالي، لا تشكل الفصائل المقاتلة في غزة إلا تهديداً محدوداً لإسرائيل في أي مواجهة محتملة بين إيران وإسرائيل. وتستطيع إسرائيل احتمال المخاطر الناجمة عن التقاصف الإسرائيلي – الفلسطيني كما حدث في حُزم الصواريخ التي انطلقت بغزارة من غزة في 10/5/2021 وما بعده، فتحمّلت إسرائيل 12 قتيلاً فقط، بل إن اسرائيل مستعدّة لإحتمال آلاف القتلى في أي حربٍ مع إيران، إذا كانت تلك الحرب تندرج في إطارالحرب الوجودية، وهي حربٌ مستبعدةٌ إلى حد الاستحالة. أما التهديد الجدّي لإسرائيل فيأتيها من جنوب لبنان، أي من حزب الله. وهذا التهديد إنما هو مشتق Derivative من الصراع الإيراني – الإسرائيلي الذي تجري وقائعه في ميادين بلادنا. ولهذا، حسابات الصراع في هذا الميدان مرتبطة عضوياً بالأمن القومي الإيراني وبالأمن القومي الإسرائيلي. ومن غير المقبول تعليق قضية فلسطين على موجبات الأمن القومي الإيراني، حتى لو تطابقت هذه مع التناقض التاريخي الفلسطيني الإسرائيلي. ويمكن أن تضاف إلى ذلك تحولات مؤلمة في الميدان، مثل تطور علاقات إسرائيل بالهند والصين وروسيا إلى درجةٍ وثقى جداً وكذلك ببعض الدول الأفريقية، بعدما كانت أفريقيا ملعبنا المأمون، وخزّان التصويت المؤيد لفلسطين في الأمم المتحدة، وكانت الهند والصين وروسيا، فضلاً عن باكستان، تشكل الأسوار المنيعة التي صدّت إسرائيل عن آسيا، وها هي تلك الأسوار تتداعى وتنهار.
من المحال تحقيق إنجاز تاريخي للقضية الفلسطينة في غمار تلك التحولات. وكل ما يمكن القيام به هو الحفاظ على الذات، والإبقاء على جذوة التحرر الوطني متقدة، وهو ما لن يتحقق إلا بدعم الشعب الفلسطيني ليبقى كريماً في أرضه، وقوياً في مواجهة الاحتلال، وشجاعاً في مقاومة المستوطنين.
هنا يبدو النظام السياسي الفلسطيني غير قادر بدوره على اتخاذ قرارات حاسمة. حتى الانتخابات التشريعية عجز النظام السياسي عن ابتداع بدائل مقبولة منها، ولم يجرؤ على اختيار بدائل ممكنة لا تنتقص من قضية القدس ومن مفهوم السيادة عليها، غير أن تحميل النظام السياسي الفلسطيني وحده تبعات الواقع الفلسطيني الراهن أمر غير صحيح، وغير عادل على الإطلاق؛ فهذا النظام ارتضاه الجميع عند تأسيسه في البدايات، وعند صوغ نصوصه الدستورية. وليس من الحكمة البتة أن يُدعى إلى تحطيم هذا النظام وإنهاء مفاعيله. أما التذرع بتركُز القرارات كلها في مكتب رئيس دولة فلسطين، فهو شأن نشأ بالتدريج، وتطور على هذا النحو جرّاء تغير الأحوال التي عصفت بالسلطة الفلسطينية بعد همود الانتفاضة الثانية واستشهاد الرئيس ياسر عرفات والانشطار السياسي والجغرافي الذي صنعته حركة حماس في سنة 2007. فإذا صار رئيس دولة فلسطين الذي هو نفسه رئيس حركة فتح ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيساً للمجلس التشريعي، فالسبب أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد حلّت المجلس التشريعي، وبالتالي صار من مهمات الرئيس حُكماً، بحسب النظام الأساسي، إصدار مراسيم لها قوة القانون. وهذه الحال ليست من سمات الدكتاتورية، كما يحلو لبعض المتكلمين أن يتكلموا (دكتاتورية تحت الاحتلال؟)، بل من عقابيل الميدان السياسي الفلسطيني الفريد. ومهما يكن الأمر، فإن هذه الحال مؤقتة، وفي الإمكان تعديل نتائجها بالتوافق الوطني العام وبإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. ومن الطبيعي، عندئذٍ، أن يكون رئيس حركة فتح من فتح وليس من الجبهة الشعبية. أما رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فليس بالضرورة أن يكون من حركة فتح، لكن التقليد درج على أن يكون من التنظيم الأعرق والأكبر. وستقرّر الانتخابات مَن يتولى رئاسة السلطة الفلسطينية. وهذا التغيير يتيحه، بكل سلاسة، النظام السياسي الفلسطيني نفسه في حال التوصل إلى التوافق الوطني العام. وهنا، بالتحديد، تكمن عقدة النجار.