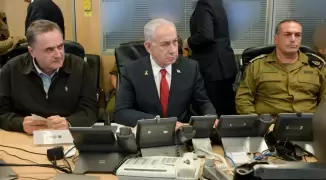انقضى شهر رمضان الذي حسبت له دولة الاحتلال حساباً استثنائياً في إجراءاتها الأمنية، في محاولة لإخماد الهبة الجماهيرية (بل قل الانتفاضة الجماهيرية) في القدس وأنحاء أخرى من الضفة الفلسطينية، ما أدى إلى سقوط 18 شهيداً أردتهم قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين بالرصاص الحي.
حافظ الفلسطينيون الشجعان على قداسة وطهارة مقدساتهم الدينية المسلمة والمسيحية، وأرغموا سلطات الاحتلال على التدخل لمنع المتطرفين اليهود من تحويل الأقصى إلى معبد لهم، يقدمون فيه أضحياتهم في الفصح اليهودي، كما أرغموا قوات الاحتلال على تقييد (نسبياً) تحركات المتطرف بن غفير، الذي آل على نفسه أن يشعل نار الفتنة ويزرع الموت أينما ذهب.
واستطاع الفلسطينيون الشجعان، في صمودهم البطولي، في القدس وأنحاء الضفة الفلسطينية، وتأهبهم النضالي في مناطق الـ48، واستعدادهم القتالي في قطاع غزة، وبسالتهم المشرفة في الشتات، أن يرغموا المجتمع الدولي، بكل أطرافه العربية والإقليمية والغربية، أن يعلن عن قلقه مما يحصل، وأن يوجه رسائله إلى إسرائيل، يدعوها إلى تحمل المسؤولية عما يجري في المناطق الفلسطينية المحتلة، حتى أطراف «اتفاق أبراهام»، التي عاشت مع دولة الاحتلال شهر عسل، في التطبيع والتحالف، وحدت نفسها مرغمة، بقوة ضغط الشارع الفلسطيني وصموده وبسالته، لتوجيه النقد والإدانة العلنية لدولة إسرائيل، عما تقترفه من جرائم بحق الفلسطينيين.
حتى الصحافة الإسرائيلية التي تقدم نفسها معتدلة، عبر بعض الأقلام اليهودية المعروفة بمواقفها المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، شاركت في إدانة سلوك السلطات الإسرائيلية وغطرستها في معالجة الأوضاع في القدس والضفة الفلسطينية.
وحدها؛ اللجنة التنفيذية في م. ت. ف. والقيادة السياسية للسلطة الفلسطينية، كانت الغائب الأكبر. خرجت من المشهد، وغابت عن السمع، وبحث عنها المراقبون فلم يجدوا لها أثراً.
منذ أن تشكلت اللجنة التنفيذية الجديدة (القديمة) في م. ت. ف، عقدت اجتماعاً واحداً، ناقشت فيه السبل والآليات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي في قطع العلاقة مع دولة الاحتلال، ووقف العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو، وكل التزاماته واستحقاقاته. وفي حركة التفافية على القرارات، قررت اللجنة التنفيذية أن «تمهل» المجتمع الدولي ثلاثة أسابيع، تجري خلالها اتصالات مع العواصم المعنية، عرباً وأجانب، بما في ذلك أميركا اللاتينية، لوضعها أمام مسؤولياتها، وتبلغها بقرارات المجلس المركزي المنوي تنفيذها، وتداعياتها السياسية والأمنية المرتقبة.
قرارات اللجنة التنفيذية أن تجتمع مرة أخرى بعد ثلاثة أسابيع لدراسة حصيلة الاتصالات، ثم دعي إلى اجتماع قيادي فلسطيني (بعد مرور ثلاثة أسابيع وأكثر) لدراسة الموقف، ثم بلا مقدمات أعلن عن تأجيل (إلغاء) الاجتماع المقرر، دون تحديد موعد بديل، في الوقت الذي كانت فيه النيران تشتعل فيه من القدس إلى أنحاء الضفة الفلسطينية.
وهكذا طار الاجتماع، وطارت معه اللجنة التنفيذية، وطارت معها قرارات المجلس المركزي، وبقي السؤال معلقاً: أين هي القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية؟! ...
وبدا الأمر وكأن القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية تستعيد مرة أخرى ذات السلوك الذي سلكته إبان انتفاضة القدس ومعركة سيف القدس في رمضان الماضي، حين غابت عن الفعل، واكتفت بقرار تشكيل لجنة «لدراسة» ما يتوجب فعله. ولم تتشكل اللجنة، وبالتالي غاب فعل القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية، ووصف سلوكها بأنها تخلفت عن توفير الحماية السياسية والمعنوية لشعبها في مواجهته لقوات الاحتلال. وقد أدى ذلك إلى إضعاف ثقة الشارع (أو ما تبقى منها) بالقيادة السياسية للسلطة، خاصة وقد اعترف بعض رموزها أنها عاشت عزلة سياسية خانقة، حتى على المستوى العربي إبان المعارك التي شهدتها فلسطين في جغرافيتها كاملة.
فهل نحن الآن أمام مشهد مماثل لمشهد العام الماضي؟
■ ■ ■
مما لا شك فيه أن قيادة السلطة الفلسطينية تعيش أزمة سياسية، أعمق من كونها غابت عن أي فعل إبان شهر رمضان وثورته الشعبية، إذ أدت التطورات الدولية إلى صناعة حقائق جديدة، وضعت القيادة السياسية للسلطة أمام استحقاقات سياسية جديدة لم تكن في الحسبان. أضف إلى ذلك حالة التناقض الواضحة في سلوك القيادة السياسية للسلطة بين مواقفها اليومية، وبين قرارات الشرعية الفلسطينية ممثلة بالمجلس المركزي في دورته الأخيرة. إذ ما زالت القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية تتصرف وكأن قرارات المجلس المركزي لم تكن، حتى البيانات السياسية الناطقة باسم الرئاسة، ما زالت خارج الالتزام بقرارات المجلس المركزي، فما زالت تتحدث عن «الربط» بين «الحل الاقتصادي والأفق السياسي للحل» في موقف لا يرفض الحل الاقتصادي، ولا يتوقف عن الرهان على حل سياسي متوازن، ومقبول فلسطينياً مع حكومة إسرائيل.
أما بشأن المقاومة الشعبية، فقيادة السلطة تجد نفسها على الدوام في مأزق، فهي من جهة تدعو لما تسميه المقاومة الشعبية السلمية، ومن جهة أخرى لا تتقدم لتوفر الغطاء السياسي للمقاومة الشعبية، كما تشهدها المناطق المحتلة، وبدلاً من أن تعكف على العمل لتنشيط هذه المقاومة، تتوجه إلى ما تسميه «المجتمع الدولي» تدعوه للضغط على إسرائيل، وإن كان هذا يعبر عن شيء فهو يعبر عن إفلاس سياسي، خاصة عندما تتوجه الخارجية الفلسطينية بنداء الاستغاثة إلى واشنطن تحديداً تدعوها للضغط على إسرائيل.
ولعل القيادة السياسية للسلطة تدرك جيداً أن أزمة أوكرانيا، والمتغيرات في العلاقات الدولية، أطاحت بمشروع الحل على يد الرباعية الدولية، بل وأطاحت بما يسمى «حل الدولتين»، وقيادة السلطة الفلسطينية وإن كانت تجدد تمسكها بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، فإنها في الوقت نفسه لا تقدم أية رؤية، أو أي مشروع، للوصول إلى مثل هذا الهدف، فلا هي إلى جانب المقاومة الشعبية بكل أشكالها وليس في الأفق بالمقابل، ما يبشر بإمكانية استئناف المفاوضات مع إسرائيل.
وتعبر القيادة السياسية للسلطة عن أزمتها، حين تتبنى خطاباً ترفض فيه الأمر الواقع، وحين تواصل من جهة أخرى، التعاون العميق مع دولة الاحتلال، لترسيخ هذا الواقع، بما في ذلك عقد الاجتماعات على أعلى المستويات مع المراجع الأمنية الإسرائيلية، أحياناً في العلن، وأحياناً كثيرة في الخفاء.
سؤال أخير: ما الذي تنتظره القيادة السياسية للسلطة؟
هل تنتظر انقشاع دخان المعارك في أوكرانيا، لتعيد قراءة الوضع الدولي. وبناء عليه تتخذ القرارات المناسبة؟ الكل يدرك أننا أمام وضع استثنائي قد يطول نسبياً، فما هو البديل إلى حين انتهاء هذا الشوط؟
وهل تنتظر القيادة السياسية للسلطة وضوح الحالة في إسرائيل ومعرفة مصير حكومة بينيت؟ حتى هذه القضية، كما نعرف، تستوجب وقتاً طويلاً إلى حين إعادة تنظيم الحالة في إسرائيل، فماذا ستفعل السلطة إلى حين الفراغ من ذلك؟
هل تراهن القيادة السياسية للسلطة على نتائج المؤتمر القادم لحركة فتح؟ هل من المتوقع أن يخرج المؤتمر في قراراته عن الاجماع الذي شكله المجلس المركزي في دورته الأخيرة، لصالح العودة إلى التزامات أوسلو.
هل تراهن القيادة السياسية للسلطة على الوقت بحيث يصيب الوهن الحالة الشعبية فتخمد نار مقاومتها للاحتلال، وتستعيد الضفة الفلسطينية الهدوء. التجربة تقول أننا منذ العام 2015 أمام هبات متجددة، وبالتالي هذا رهان خاسر.
ماذا تنتظر القيادة السياسية للسلطة وما هي رهاناتها؟! ...