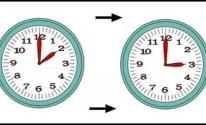إلى جانب العامل الذاتي، يؤثر على مسارات القضية الفلسطينية عاملان مهمان، يتداخلان مع «الذاتي» ومع بعضهما البعض ضمن علاقة جدلية لا تقبل الانفصام؛ هما العامل العربي الإقليمي، والعامل الدولي. وهذان العاملان هما اللذان خلقا المشكلة الفلسطينية أساسا، وهما اللذان أوجدا إسرائيل وأمدّاها بأسباب البقاء، وهما اللذان يمتلكان أدوات ومفاتيح الحل، ولكن بالطبع باتجاهات وتأثيرات مختلفة ومتباينة. والجدير بالذكر أن هذين العاملين لم يكونا دوماً ضد الفلسطينيين وبشكل مطلق، ولم يكونا بالتأكيد لصالحهم. لن نتطرق هنا للعامل الذاتي (رغم أهميته)، ذلك لأنه أُشبع بحثا، ولدينا آلاف المقالات والدراسات التي ركزت عليه، جزء كبير منها انتقد بشكل موضوعي وبنّاء، واستعرض أهم جوانب الخلل والتقصير والأخطاء التي ارتكبتها القيادة، وجزء كبير أيضا مارس النقد مع التهويل والمبالغة، أو باحثا عن الأخطاء للتصيد بانتهازية سلبية، وأحيانا بافتراءات مكشوفة، أو كجزء من ممارسة اعتادت تحميل القيادة مسؤولية كل شيء (لتبرأة الذات).
ولأن المقال لا يتسع للحديث بشكل موسع عن قضية معقدة كهذه؛ سنتناول فقط أهم الأحداث العربية والإقليمية التي أثرت سلبا على مسار القضية الفلسطينية، وكانت من بين أبرز الأسباب في إخفاق الثورة الفلسطينية، وإعاقتها، والحيلولة دون تحقيقها غايتها، أو إحرازها الهدف الذي انطلقت لأجله .. بعد الإنطلاقة مباشرة، شكّلت الأردن نقطة الإرتكاز الأولى للفدائيين، ولكن ولأسباب عديدة (لا مجال لذكرها هنا) حصلت أحداث أيلول المؤسفة؛ الأمر الذي أدى لخروج قوات الثورة من الأردن، بالتالي فقدانها أطول خط مواجهة، وتدهور العلاقات بين الجانبين (والتي احتاجت سنوات عديدة لإعادة ترميمها).
أما لبنان التي أصبحت المحطة الثانية؛ فسرعان ما نشبت فيها الحرب الأهلية، وقد فشلت كل محاولات الثورة البقاء على الحياد، فبعد استهداف المخيمات، وتعرض القيادة لضغوطات من القوى الوطنية بأن تقف إلى جانبها في مواجهة الانعزالين والكتائب، وجدت نفسها في خضم حربٍ لم تخطط لها ولم تسعى إليها. وهذه الحرب كلفتها الكثير، وحرفتها عن مسارها.
ومع ذلك، بعد أقل من سنة من بدء الحرب، كادت القوات المشتركة (اللبنانية الوطنية والفلسطينية) أن تحسم الصراع وتنهي الحرب، بعد أن بسطت سيطرتها على معظم لبنان، لولا التدخل السوري الذي قلب الموازين لصالح الكتائب (وما رافقه من أغتيال كمال جنبلاط ووقعت مجزرة تل الزعتر)، وفي المحصلة تمددت الحرب الأهلية حتى بداية التسعينات.
أما مصر؛ والتي كانت أهم حائط يستند إليه الفلسطينيون في زمن عبد الناصر، فقد دخلت في مفاوضات ثنائية مع إسرائيل أسفرت عن معاهدة كامب ديفيد، وعقد اتفاق سلام بين البلدين (1978)، الأمر الذي تسبب بخروج مصر عن الصف العربي، وبالتالي خسارة العرب وفلسطين لأهم ركيزة أساسية كان يمكن لها أن ترجّح موازين القوى. ومع بداية الثمانينيات، لم يعد الجنوب اللبناني الذي طالما شكل القاعدة الارتكازية للثورة، يحتمل بقاء الفدائيين، خاصة مع تصاعد العمليات الانتقامية الاسرائيلية بعد كل عملية فدائية، وبعد انتصار الثورة الإيرانية، التي أوجدت واقعا جديدا في كل لبنان.
وفي العام 1982 واجهت القوات الفلسطينية الاجتياح الإسرائيلي للبنان بمفردها، ولم تقدّم لها الدول العربية أي دعم أو مساندة، فانتهت الحرب بخروج الثورة من لبنان، وفقدانها آخر قاعدة ارتكازية في دول المواجهة، وتشتتها في سبع دول عربية. وبعد سنة بدأت قوات الثورة بالعودة إلى البقاع، لكن النظام السوري بعد اعتقاله كوادر فتح، وطرده قيادتها من سورية، ونجاحه في شق الحركة؛ تمكن من إخراج القوات التابعة لمنظمة التحرير نهائيا من لبنان (1983)، ولم يكتف بذلك؛ فقد استمرت محاولاته في الهيمنة عى القرار الفلسطيني؛ فشكّل ما عرف حينها بِ»جبهة الإنقاذ»، ثم دعم حركة «أمل» في حربها على المخيمات (1985 ~ 1987)، ودعم «القيادة العامة» و»فتح الانتفاضة» للسيطرة على المخيمات الفلسطينية في لبنان (1988)، تحت ذريعة محاربة العرفاتيين.
ومرة أخرى في بداية التسعينات أنشأ «تحالف الفصائل العشر» في مواجهة منظمة التحرير، وكبديل عنها. العراق بدوره، في بداية السبعينات دعم تنظيم «صبري البنا» المنشق عن فتح، وقد ظل على علاقة متوترة مع المنظمة حتى العام 1985، لكنه في هذه الأثناء كان مشغولا بحربه المجنونة مع إيران، والتي لم تكد تنتهي حتى دخل مغامرته العسكرية باحتلال الكويت، الأمر الذي أدى إلى انقسام العالم العربي، وفي المحصلة خسرنا العراق نفسه كدولة ذات قوة عسكرية مهمة، وخسرنا دول الخليج بدعمها المادي والسياسي، من جراء حرب لم نقرع طبولها، ولم يكن لنا فيها أي مصلحة. وحتى إيران، والتي كان «ياسر عرفات» أول من زارها، وحاول نسج تحالف إستراتيجي معها، سرعان ما انقلب موقفها، ثم ساءت العلاقات بين الطرفين، حتى وصلت القطيعة، وطبعا هي التي شجعت ورعت الانقسام الفلسطيني (2007).
بالمختصر، حسْم الصراع مع إسرائيل، أو حتى إحداث أي اختراق حقيقي فيه، أو فرض تسوية عادلة يتطلب استنهاض القوة العربية بكامل عناصرها، بل وقوة العالم الإسلامي معها، مع بناء تحالفات دولية جديدة على أساس هذه القوة، بحيث تغير المعادلة السياسية برمتها. وعدى ذلك؛ فإن أقصى ما يمكن للفلسطينيين أن يعملوه (حتى لو كانوا كلهم على قلب رجل واحد) هو الصمود فوق أرضهم، وإبقاء جذوة المقاومة متقدة، لإدامة الصراع وإبقاء ملف القضية مفتوحا، إلى حين تغيّر موازين القوى. ربما استعرضنا أبرز الأحداث (وغيرها الكثير)، وقد اتضح لنا أن الدول العربية بدلا من أن تشكل جبهة مساندة، كانت على العكس؛ تدفع الفلسطينيين نحو مسارات لا يريدونها، مسارات استنزفت قواهم .. فلولا «كامب ديفيد»، ولولا الحرب الأهلية اللبنانية، ولولا هزيمة العراق وخروجه مبكرا، ولولا السياسات السورية العقيمة، ولولا الضعف والتواطؤ العربي الرسمي، ربما كانت «أوسلو» بالنسبة لنا مجرد عاصمة بعيدة في دولة باردة، قد نرغب بزيارتها للسياحة.