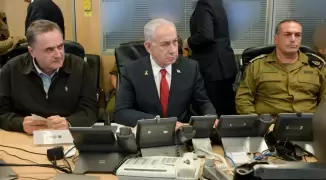أتت الأخبار عن اكتشاف محاولة انقلابية بواسطة القوة في ألمانيا (84 مليون نسمة)، على أيدي أفراد يمينيين (جماعة "مواطني الرايخ")، يحنّون إلى زمن الإمبراطورية الألمانية، ولا يعترفون بحدود ألمانيا الحالية (357 ألف كلم2)، ولا بالدولة المدنية، ولا بالنظام الديموقراطي، ولا بالدستور الألماني، مفاجئة وصادمة ومدهشة، لأن الحديث يتعلق بالدولة الأهم في القارة الأوروبية.
وأهمية ذلك الحدث أيضاً أن ألمانيا هي بمثابة القاطرة للاتحاد الأوروبي، وللتطورات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية في أوروبا (ناتجها 4.2 تريليونات دولار سنوياً)، فهي الدولة الثالثة أو الرابعة في العالم لجهة قوتها الاقتصادية والتصديرية، بعد الولايات المتحدة والصين مع اليابان. وفوق ذلك فهي دولة تعيش استقراراً سياسياً ينبع من التعددية الحزبية فيها (ثمة ثلاثة أحزاب في الائتلاف الحاكم لها أكثر من 400 نائب من 736 في البرلمان)، ومن نظامها الديموقراطي، القائم على الفصل بين السلطات، وتداول السلطة، بواسطة الانتخابات.
وللتوضيح أكثر، فإن حجم الاقتصاد الألماني، الصناعي أساساً، هو ثلاثة أضعاف الاقتصاد الروسي (1.7 ترليون دولار)، رغم أن عدد سكان روسيا هو ضعف عدد سكان ألمانيا، وأن مساحة روسيا تساوي 50 ضعفاً من مساحة ألمانيا، مع كل ما في ذلك من غنى وتنوع في الثروة المعدنية في الأراضي الروسية الواسعة؛ علماً أن القوة التصديرية لألمانيا هي ضعفا القوة التصديرية لروسيا، رغم أن الأخيرة تعتمد على النفط والغاز والحبوب والأسمدة في ثلثي صادراتها، فيما تشكل الصادرات من الأدوات الالكترونية والكهربائية، والآلات ووسائل النقل ومستلزمات الصناعة معظم الصادرات الألمانية (نحو تريليون دولار).
ثمة مسألتان تمكن ملاحظتهما في هذا السياق، كخلفية لتلك المحاولة الفاشلة، الأولى تتعلق بالأزمات التي تعاني منها أوروبا، أكثر من بقية العالم. والثانية، تتعلق بذلك التوتر بين حدي الليبرالية والديموقراطية.
في المسألة الأولى، واضح أن البلدان الأوروبية، وخاصة ألمانيا، تعاني أزمات، رغم أنها حاولت التخفيف منها، أو إيجاد حلول لها، أهمها:
أولاً، جائحة كورونا التي أثرت اقتصادياً ومعيشياً في مواطني البلدان الأوروبية، نتيجة الإغلاقات، وتراجع فرص العمل، والتضخم النقدي، وانخفاض مستوى النمو الاقتصادي، وهي أزمة لا تزال آثارها باقية، رغم أن الحكومة الألمانية عملت الكثير، ومن ضمنه تخصيص اعتمادات بعشرات مليارات اليوروات، للتخفيف من ثقل الأزمة عن كاهل المواطنين، والشركات الصغيرة.
ثانياً، مشكلة اللاجئين السوريين (والعرب عموماً)، التي بدأت منذ عشرة أعوام، وقد أضيفت لها مشكلة اللاجئين من أوكرانيا، بعد الغزو الروسي لذلك البلد (منذ شباط/ فبراير الماضي)، حيث ثمة مليون منهم في الأراضي الألمانية، وقد تحملت ألمانيا العبء الأكبر (بين البلدان الأوروبية) في احتضان اللاجئين (وفقاً لقوانينها)، وتقديم شبكة الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية لهم، وهذا بالتأكيد يعني أن ثمة فاتورة باهظة يتم تقديمها في هذا المجال.
ثالثاً، دق الغزو الروسي لأوكرانيا ناقوس الخطر في ألمانيا، تبعاً لمخاوف من التجارب التاريخية السابقة، الأمر الذي تُرجم باتخاذ موقف حاسم بعمل كل شيء من أجل عدم السماح لبوتين بالفوز بأوكرانيا، لأن ذلك قد يفتح شهيته على مناطق أو بلدان أخرى، ويأتي ضمن ذلك تقديم الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا لتمكينها من الصمود وإفشال الغزو، كما تضمن ذلك زيادة الاعتمادات العسكرية للجيش الألماني (100 مليار يورو في اليوم الثالث لغزو روسيا لأوكرانيا)، ورفع موازنة الجيش إلى 2 في المئة من الدخل الإجمالي السنوي لألمانيا.
رابعاً، أدى الغزو الروسي لأوكرانيا أيضاً إلى فك الارتباط الألماني (والأوروبي عموماً) بإمدادات النفط المتأتية من روسيا، في سياق العمل على معاقبتها وعدم مدها بالأموال اللازمة لتمويل حربها في أوكرانيا، رغم أن ذلك دفّع الاقتصاد الألماني ثمناً باهظاً، ومن ضمنه شراء النفط أو الغاز، من بلدان أخرى، بأسعار عالية، اضطرت الحكومة للتخفيف منها على المواطنين وعلى الشركات الصغيرة عبر وضع اعتمادات مالية كبيرة (أخيراً بنحو مئة مليار يورو).
إلى ذلك، فإن تلك الأزمات أدت إلى خلق حالة من التوترات في المجتمع الألماني، الأمر الذي ربما كان في اعتبار تلك المجموعة، التي قد تكون رأت في الظروف الحالية، الداخلية والخارجية، بمثابة فرصة لها للقيام بعمل ما، رغم قلة عددها، ورغم أنها مجموعة محدودة.
أما المسألة الثانية، المتعلقة بذلك التناقض بين حدي الليبرالية والديموقراطية، فهي أن النظم السياسية في البلدان الغربية تأسست على الليبرالية، التي تعنى بحقوق المواطنة، والحريات، والمساواة بين المواطنين، في علاقتهم بالدولة وببعضهم بعضاً، هذا من جهة. ومن جهة ثانية على الديموقراطية، التي تعنى بشكل الحكم، أو النظام السياسي، بالاحتكام إلى الانتخابات، أي إلى الشعب، في تعيين التوازنات السياسية، كما تعنى بالفصل بين السلطات، وتداول السلطة. وهكذا فحيث إن الليبرالية تكفل حق المواطن بالحرية، ومن ضمنها حرية القول والتعبير والتنظيم، فإن ذلك يعني أنه بإمكان أي فرد أو مجموعة التطرف بأخذ الأمر إلى حد يتجاهل رأي الأكثريات، أو يعاديها، وهذا يتنافى مع الديموقراطية. وبالمثل، فحيث في الديموقراطية يخشى من طغيان الأكثرية على الأقلية، لأي سبب كان، فإن تلك الثغرة/التناقض، التي يفترض أن الدستور يضع حلولاً لها، هي التي تفتح مجالاً للبعض لاستغلالها والنفاذ منها، وهذا ما يتجلى في ظهور جماعات ذات طابع يميني مع شطحات فاشية، أو عنصرية، على نحو ما ظهر في مجموعة "مواطني الرايخ"، التي سكت عنها النظام الألماني طويلاً ما دامت في حدود التعبير عن الرأي.
والفكرة هنا أن ذلك النظام، المحتكم إلى نظام الليبرالية الديموقراطية والفصل بين السلطات، لا يتسامح مع ثلاث ظواهر، الأولى، وهي انتهاك الدستور، باعتباره الوثيقة العليا لإجماع المواطنين في البلد، والمعبر عن سيادة الشعب في بلده. والثانية، الأفكار العنصرية أو التمييزية، وطبعاً من ضمنها النازية. والثالثة، محاولة أي فرد أو جماعة أو تيار توسل القوة لفرض أفكاره/ا على الآخرين.
طبعاً، ثمة في خلفية ما جرى في ألمانيا، الإرث الثقيل الناجم عن تجربة صعود النازية، ففي 1923 قام هتلر بمحاولته الانقلابية الأولى، وفشل، وحكم عليه بالسجن، ثم أفرج عنه، وهي المحاولة التي كررها في الثلاثينات، وتمكن فيها من الاستيلاء على الجيش والدولة، ما أدى إلى كارثة لألمانيا، وأوروبا كلها.