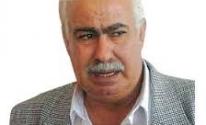من يتابع وسائل الإعلام، خاصة منصات التواصل الاجتماعي، سيلاحظ بسهولة أنَّ جميع الآراء المؤيدة لـ»حماس» بلا تحفظ تكاد تكون محصورة في أهلنا في الأردن.. يقابلها موقف رافض ومنتقد لأهلنا في غزة.. مع استثناءات في الأماكن الأخرى بين تأييد متحفظ أو انتقاد معين أو اختلافات في الرأي هنا وهناك.
قد يكون التفسير البسيط والأولي لهذه الظاهرة في المثل الشعبي: «اللي إيده في المي مش زي اللي إيده في النار»، ولكن بالغوص أكثر في الظاهرة سنجد تفسيرات أعمق وأدق.
لنبدأ في السؤال: لماذا في الأردن بالذات جميع التظاهرات التي خرجت كانت تأييداً «للمقاومة»، ونصرة لـ»حماس» تحمل صور قادة «حماس» وتهتف لرموزها.. ولم نسمع هتافاً ولم نشاهد يافطة تُشعر بآلام ومعاناة الغزيين، أو تشير إلى محنتهم الإنسانية، أو تدعو لإيقاف العدوان.. خلافاً للتظاهرات العالمية التي كانت استنكاراً لجرائم إسرائيل، مع دعوات لوقف الحرب وإدخال المساعدات، والتركيز على الجانب الإنساني للمأساة؟!
لماذا الرأي العام في الأردن يكاد يكون متفقاً وبالإجماع على أن ما يحدث في غزة ليس حرب إبادة بل مقاومة ضد الاحتلال وأن «حماس» هي التي تقود وتمثل هذه المقاومة، مع يقين لا يتسرب إليه الشك بأنَّ هذه المقاومة ستهزم إسرائيل في القريب العاجل، مع تقبل تام لفكرة فناء أهل غزة جميعهم مقابل انتصار «حماس»، ولا بأس بفناء أهل الضفة وتدميرها كما حدث في القطاع، وأنّ كل هذه الخسائر في الأرواح والبنية التحتية خسائر عادية ومقبولة، وأنَّ أهل غزة منذورون للحرب، ومستعدون للفداء، وسعداء بتضحيتهم بحياتهم وممتلكاتهم ومستقبلهم.. وأن من ينادي بوقف العدوان، أو ينتقد «المقاومة»، أو يشير إلى حجم الخسائر.. إما خائن أو مرجف؟!
مثل هذه الآراء تحملها شرائح اجتماعية عديدة في معظم بلدان الدنيا (ليس في الأردن فقط)، لكن في كل البلدان والمجتمعات ستجد تبايناً في الآراء وتعدداً في وجهات النظر.. بينما في الأردن تكاد لا تسمع إلا صوتاً واحداً، وأي صوت مخالف، سيكون خروجاً عن الإجماع، سيتم نبذه ومقاطعته واتهامه بالعمالة والتطبيع والجبن.
ومن الواضح أن مجمل هذه الآراء والشعارات شعبوية، شكلت تياراً شعبوياً هيمن على المجتمع بشكل يفوق سائر المجتمعات الأخرى.
وهذه ظاهرة غريبة وتستحق الدراسة، ولا أزعم أني أمتلك إجابات شافية.
بتحليل سمات وخصائص الشعارات والآراء التي يحملها النشطاء والمؤثرون في الشارع الأردني، سنجد أنها سطحية، وذات صبغة عاطفية، متأثرة بإرث حقبة الستينيات وشعاراتها، وبالخطاب الديني الغيبي بل ومبنية عليه، وتعتمد على الحمولة الوجدانية والعاطفية المتقدة للشعب الأردني تجاه فلسطين والمقدسات ومشاعر العداء ضد الاحتلال.
وبصرف النظر عن إمكانية تفنيد العديد من تلك الشعارات بقليل من التعقل والتفكير، ما يعنينا هنا محاولة فهم كيفية نشأتها، وجذورها التاريخية والسياقات السياسية والاجتماعية التي أحاطت بظروف تشكلها.
إذا اعتبرنا أن الكتلة السكانية الأكبر تتركز في العاصمة والمدن القريبة منها، سيكون مفيداً لفهم الظاهرة دراسة تطورها السوسيولوجي، ولأن نطاق المقال لا يحتمل التوسع، سأكتفي بالإشارة إلى أن تلك المدن طرأ عليها تغير ديموغرافي كبير بعد النكبة 1948، بسبب تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين، الذين حملوا الجنسية الأردنية، وصاروا جزءاً طبيعياً من التركيبة السكانية، التي ضمت أيضاً مجموعات سكانية من منابت وأصول مختلفة، شكلت معاً ما بات يُعرف بالمجتمع الأردني والهوية الأردنية.
التغييرات الأخرى (وهي مهمة أيضاً) حدثت خلال العقود الخمسة الأخيرة؛ بعد الحرب الأهلية اللبنانية، وبعد حرب الخليج الأولى والثانية، وبعد ثورات الربيع العربي، حيث تدفقت أعداد كبيرة من جنسيات مختلفة، وعودة نسبة من المغتربين، الأمر الذي ظل يغير من الطبيعة الديموغرافية، ومن الطابع المعماري والمديني والمجتمعي لتلك المدن، بحيث نمت وتطورت بصورة مشوهة وعلى شكل قفزات عشوائية لا تتناسب مع التطور الثقافي العادي كما يحدث في سائر المجتمعات.. لأنها لم تكن مهيأة لامتصاص واستيعاب تلك التطورات، بحيث تنشأ فيها معارضة وطنية حقيقية، أو تخرج أصوات حرة وإبداعية، أو تتشكل حالة تنوع فكري وتعددية سياسية. ربما بسبب ضعف السياق الثقافي المدني أصلاً لعمّان مقارنة مع عواصم عريقة مثل بغداد ودمشق والقاهرة وغيرها من الحواضر العربية.
وهذه المدن نمت في ظل أزمات اقتصادية متتالية (أو هي أزمة اقتصادية مزمنة) نجمت عنها بطالة وفقر ومناطق مهمشة وما يشبه العشوائيات، أدت إلى استشراء ظواهر سلبية مثل أعمال النصب والاحتيال، والتحايل على المجتمع والنظام، وظهور مجموعات خارجة عن القانون.. وهذه الحالات ظلت ظواهر معزولة ومحدودة ومنبوذة، وعلى هامش المجتمع. لكن الظاهرة الأشمل تمثلت في التدين الشكلي والتطرف، وهما نتاج الأزمة الاقتصادية ومناخات القمع ومظاهر الفساد وضعف العدالة الاجتماعية.. وأي مجتمع يختبر تلك الظروف سيتشكل لديه عقل جمعي شبه مغلق، لأنها ستحفز نزعاته البدائية، وتثير فيه مشاعر الخوف والقلق، فيبدأ البحث عن خلاص متوهَّم يخفف من حدة التأزم، ويريح الناس بشعارات غيبية فضفاضة منفصلة عن الواقع، ستكون بالضرورة متطرفة، سيما أن ترديدها لا يشتمل على مخاطر ودفع أثمان.. وبيئة كهذه لا تحفز على التفكير النقدي الحر، بل تقمع أي استقلالية أو تفرد في الأفكار والتوجهات، وستعتبرها خروجاً عن الإجماع (خروج عن ثقافة القطيع).
بصورة عامة، تلعب الأحداث والصراعات دوراً أساسياً في تشكيل وعي المجتمع، وإنضاجه وتطويره، فبعد أن يتعرض للضغط المباشر ويعاني من أهوال الحروب وصدماتها يغدو تفكيره أكثر واقعية وعقلانية.. ولحسن الحظ لم يتعرض المجتمع الأردني لحرب أهلية، ولم يخضع لاحتلال مباشر ولا لحصار مطبق، ولم يخض حرباً حقيقية، وظل ينعم بالأمن.
في الخمسينيات شهدت الساحة الأردنية ظهور ثلاثة تيارات سياسية: الإسلامية، والقومية، واليسارية. وقد نشطت أحزابها بشكل كبير واستقطبت أعداداً لا بأس بها من الناس.. ورغم أفول نجمها وتراجع شعبيتها إلا أنها ظلت حاضرة ومؤثرة بأيديولوجيتها وخطابها وشعاراتها، لدرجة أن التظاهرات ظلت تردد الشعارات القديمة ذاتها بعد كل تلك العقود، ورغم كل التغييرات العميقة التي ضربت المنطقة والعالم.
بالإضافة لأثر الأيديولوجيات التقليدية، ثمة مؤثر آخر ما زال حاضراً ومؤثراً، وهو مناخ عقود من الأحكام العرفية، فرغم التحول الديمقراطي والحياة الحزبية والانتخابات وأجواء الحرية التي يعيشها الأردن الآن، ما زالت العقلية الأمنية حاضرة ولو بصورة كامنة في اللاوعي، سواء لدى الجماهير والأفراد، أو في المؤسسات والأحزاب.
سنتابع أثر الواقع الاقتصادي والسياسي وظاهرة التدين الشكلي.
«تسونامي» الاعتراف، و»تسونامي» الرأي العام
25 سبتمبر 2025