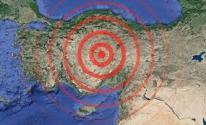لا يخفى على أحد أن الولايات المتحدة الأميركية تكثف جهودها لتوسيع نفوذها في بحر الصين الجنوبي، كما هو الحال مع الصين التي تسعى هي الأخرى إلى تعظيم حضورها العسكري والسياسي والتجاري في هذه المنطقة من العالم.
تكمن أهمية بحر الصين الجنوبي في كونه واحدا من أهم شرايين التجارة الدولية، وتقدر التجارة فيه أكثر من 3.5 تريليون دولار، أي حوالى ثلث التجارة البحرية العالمية، بالإضافة إلى أن المنطقة غنية جداً بالطاقة والثروة السمكية وتشكل خزانا استراتيجيا عالميا للتجارة العابرة للقارات.
ثم إن البحر يقع بين الصين وطرق الملاحة المؤدية إلى المحيطين الهندي والهادئ، وأي سيطرة على هذا البحر تعني التحكم في حركة الأساطيل البحرية العالمية والطائرات العسكرية بين المحيطين، ولذلك يشكل بحر الصين الجنوبي خط المواجهة الأول بين واشنطن وبكين.
مبكراً، وقبل أكثر من عشرة أعوام، لاحظت الولايات المتحدة الأميركية أن الصين تتوسع شيئاً فشيئاً في بحر الصين الجنوبي، وتبني الجزر الاصطناعية والقواعد العسكرية في مسعى للسيطرة على قلب آسيا البحرية، ما دفع القيادتين السياسية والعسكرية الأميركية لتحويل الاهتمام الاستراتيجي إلى هذه المنطقة.
طوال السنوات العشر الماضية خُصصت مبالغ في ميزانية الدفاع الأميركية لتحديث الأسطول البحري وتطوير صواريخ هجومية ودفاعية يمكنها إحداث تحولات في مسار أي صراع محتمل في بحر الصين الجنوبي.
واليوم مع إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون سياسة الدفاع السنوي بقيمة 892 مليار دولار، يلحظ أن قسما كبيرا من هذه الميزانية مخصص للجاهزية العسكرية ومواجهة التحديات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
اللافت للأمر أن واشنطن التي استخدمت المُسيرات في عمليات الاغتيال باليمن وأفغانستان، تتطلع إلى بناء أسطول من هذه الطائرات الحديثة وإدخالها بقوة في جيشها، استناداً إلى الدور المهم والحساس الذي لعبته هذه الطائرات في الحرب الروسية - الأوكرانية.
كذلك حينما يُطلب في الميزانية بناء 19 سفينة حديثة وصيانة الأسطول البحري وتحديثه، واستثمارات في الذخائر طويلة المدى والصواريخ الفرط صوتية، فهذا يعكس رغبة واشنطن في تعزيز حضورها العسكري في بحر الصين الجنوبي.
وحينما يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بتحويل وزارة الدفاع إلى الحرب، فكأنما يقول للصين وروسيا تحديداً، إن أميركا في عهده تعود إلى نهج القوة والمواجهة، وإنها ماضية في توسيع نفوذها للبقاء متربعة على عرش النظام الدولي.
صحيح أن هناك سباق تسلح محموما بين بكين وواشنطن لتعظيم وجودهما وتأمين نفوذهما في بحر الصين الجنوبي، لكن لا أحد منهما يرغب في مواجهة مباشرة قد تكون تكاليفها مدمرة عليهما، لأنهما قوتان نوويتان تمتلكان قدرات عسكرية واقتصادية هائلة.
ثمة سيناريوهات محتملة لما يحدث في بحر الصين الجنوبي، لكنّ أصوبها حرب باردة بين الطرفين تتضمن سباقاً محموماً لتطوير قدرات وأنظمة عسكرية تحقق الردع، وإتباع سياسة «التوسع الهادئ» في بحر الصين الجنوبي دون إحداث ضرر كبير ومباشر.
في حالة بكين، يمكن القول، إنها ماضية في بناء الجزر الاصطناعية لتحويل البحر إلى بحيرة صينية، يشمل ذلك إدخال معدات تسلح متطورة وبناء غواصات نووية تحمل صواريخ ليزرية موجهة وطائرات شبحية وأنظمة تعمل بنظام ملاحة وتحديد موقع خاص بها يسمى «بايدو» كبديل ومنافس لنظام «جي بي اس» الأميركي.
على الجانب الآخر، نجد أن واشنطن تعزز نفوذها العسكري في الدول الحليفة القريبة جغرافياً من الصين، مثل اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين وتايوان، بالإضافة إلى دول أخرى لديها اتفاقيات تعاون عسكري مشترك مع واشنطن مثل استراليا والهند وسنغافورة.
واشنطن تطوق الصين بهذه الدول، والهند على سبيل المثال مهتمة جداً في عملية الردع العسكري وتشكل حزاماً إقليمياً لمواجهة النفوذ الصيني في المحيطين الهندي والهادئ، ناهيك عن حضور أميركي في قواعد عسكرية منتشرة حول الصين وفي البحر الجنوبي.
هذا عدا الحرب التجارية المفتوحة بين البلدين التي بدأتها واشنطن بهدف إضعاف الصين تجارياً واقتصادياً، وفي المقابل توطين الصناعات الأميركية العابرة للحدود. كل هذه الإجراءات تدفع واشنطن لمنع تنامي النفوذ الصيني وإزالة أي تهديدات مرتبطة بالتنافس على ترؤس النظام الدولي.
تدرك بكين أن الوقت مبكر للوقوف في وجه الولايات المتحدة، فهي - واشنطن - لا تزال الاقتصاد الأقوى في العالم والقوة العسكرية التي لا تضاهيها دولة، ولذلك تلجأ الصين إلى سياسة الصبر وفي الميدان تستعجل امتلاك المعرفة بمفهومها الشامل وتوظيفها لخدمة مصالحها في التحول إلى دولة مصنعة لكل شيء.
تصنيع الطائرات المدنية والذهاب إلى الفضاء واستخدام نظام ملاحة وتحديد موقع صيني بصناعة صينية من الألف إلى الياء، سيعني أن بكين تنين حقيقي يسعى للمنافسة ويهدف إلى مقاسمة واشنطن على «كعكة» العالم.
بحر الصين الجنوبي والحرب الباردة
نشر 13 سبتمبر 2025 | 11:02