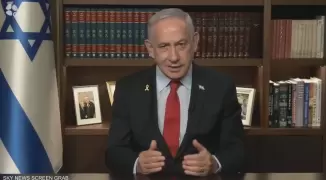قد يكون دونالد ترامب رجلا ناجحا في مجال إدارة الأعمال التجارية، وذلك بالنظر إلى جعله «منظمة ترامب» واحدة من اكبر شركات العقارات الأميركية، أما في مجال السياسة، فهو يبدو أقل نجاحا رغم فوزه بمنصب رئيس الولايات المتحدة مرتين، تنافس فيهما مع امرأتين، هما هيلاري كلينتون وكامالا هاريس، وعلى ما يبدو أن الصدفة لعبت دورا مهما للغاية في دخول ترامب عالم الشهرة أولا وعالم السياسة ثانيا، فقد بدأت شهرته عند ظهوره في برنامج «ذا أبرينتس» العام 2004، وكان له من العمر 58 سنة، حيث قدم نفسه خلال البرنامج كمحترف في إدارة الأعمال، رغم انه قبل ذلك بعدة أعوام وتحديدا في العام 2000 ترشح للانتخابات الرئاسية عن حزب يسمى حزب الإصلاح الأميركي، أي أنه حتى ذلك الوقت لم يكن منتسبا للحزب الجمهوري، بل لم يدخل عالم السياسة بشكل جدي، أو احترافي بعد.
وبعد 15 عاما بالتمام والكمال، عاد ترامب لعالم السياسة ليدخله من بابه الواسع، حين دخل البيت الأبيض رئيسا للولايات المتحدة، الدولة التي تقود العالم بأسره، رغم أن ذلك الدخول كان إشكاليا، فقد فاز بأصوات المجمع الانتخابي، في الوقت الذي خسر فيه التصويت الشعبي، بينما ترافق ذلك مع تدخل روسي أثبته المستشار الخاص روبرت مولر، وكان لافتا إلى أن فوز ترامب تبعته احتجاجات عديدة، بسبب إدلائه بالكثير من التصريحات الكاذبة وترويجه لنظرية المؤامرة خلال حملته الانتخابية، ثم كانت ولايته ما بين عامي 2016 ــ 2020 مثيرة للجدل بسبب جملة القرارات الداخلية التي اتخذها، وكان منها حظر السفر على مواطني الدول المسلمة، والفصل العائلي للمهاجرين، وخفض الضرائب على الأفراد والشركات، والقرارات الخارجية بناء على شعار «أميركا أولا» حيث انسحب من العديد من الاتفاقيات الدولية كان أهمها اتفاقية المناخ والاتفاق النووي مع إيران، إلى أن كانت خسارته في انتخابات التجديد، ورفضه الإقرار بالهزيمة، وهذا تقليد أميركي.
في هذا العام، يكون ترامب قد أمضى عشرة أعوام في ميدان السياسة المركزي، أمضى نفسها داخل البيت الأبيض، ونصفها الآخر ساعيا له، أي انه لم يعرف تفاصيل السياسة في الشارع ولا في أروقة صنع القرارات داخل المؤسسات، فهو لم يكن يوما لا عضوا في مجلس بلدي أو عمدة لمدينة ما، ولم يكن حاكما لولاية، ولا حتى عضوا في الكونغرس، لا في مجلسه النيابي ولا في مجلس الشيوخ، ولم يقترب من البيت الأبيض بالتدريج، كأن يتولى منصب وزير أو حتى منصب نائب للرئيس، أو ما شابه، لكل ذلك فإنه بتقديرنا يعتبر رئيسا إشكاليا، مختلفا عمن سبقه من الرؤساء، بصرف النظر إن كانوا ديمقراطيين أو جمهوريين، فهو لم يصنع داخل المؤسسات التي تصنع القادة ورجال السياسة، ونقصد بالتحديد الحزبين الحاكمين أو المتحكمين بالنظام السياسي الأميركي بكل تفاصيله، بل إن دخوله المسرح السياسي من أوسع أبوابه، فتح الباب لدخول «البزنس» وسلطة المال، على سلطة الحكم بشكل مباشر، بعد أن كان ذلك يجري من وراء الكواليس، ولعل ظاهرة إيلون ماسك، تعتبر تأكيدا على هذا المنحى، الذي قد يستمر كظاهرة في السياسة الأميركية أو يتوقف عند حدود تجربة ترامب.
والحقيقة أنه عند إجراء مقارنة بين ترامب في ولايته الأولى وترامب في ولايته الثانية، يمكن ملاحظة العديد من الفوارق أو الاختلافات، ففي ولايته الأولى، ظهر حيويا أكثر، واظهر إصرارا اكثر على تغيير بوصلة السياسة الأميركية، وصحيح انه اطلق الكثير من التصريحات الكاذبة داخليا، خاصة خلال الحملة الانتخابية، وظهر رئيسا قويا بالمجمل، حيث بدأ ولايته بالدخول في مساجلة مع «كيم جونغ أون» لكنه سرعان ما تراجع، ثم أصر على اتخاذ قرارات غير مسبوقة فيما يخص ملف الشرق الأوسط، بدأها بالخروج من الاتفاق النووي مع إيران، ثم بالاعتراف بالضم الاستعماري الإسرائيلي للجولان، كذلك نقل السفارة الأميركية إلى القدس، ثم حاول فرض «صفقة القرن»، وحين فشل عقد «اتفاقيات أبراهام»، أما في ولايته الثانية، فقد اختلف المنحى، وظهرت عدائيته تجاه الآخرين في الداخل بنفس ما كانت عليه في ولايته الأولى فيما يخص المهاجرين، وفي الخارج، بتحويل البوصلة من حقل القوة الأميركية العسكرية إلى حقل القوة الأميركية الاقتصادية.
وظهر ترامب هذه المرة كرجل أعمال أكثر منه كرجل سياسة، وهو حاول أن يحقق شعار «أميركا أولا» وشعار «ماغا» عبر التفوق الاقتصادي، ودخل في متاهة إشكالية سرعان ما تراجع عنها، بسبب عدم واقعيتها، ومع مرور اقل من عام، لم يعد احد يتحدث عن تعرفاته الجمركية التي اعلن فرضها بعد دخوله البيت الأبيض مباشرة، وكان الغريب هذه المرة، انه بدأ يقدم نفسه كرجل سلام، ربما لأنه حريص دائما على إظهار انه نقيض خط «أوباما ــ بايدن» السياسي، الذي وجد نفسه خصما له خلال ولايتيه الناجحتين ومحاولته الفاشلة بينهما، وهو اعتبر بأن بايدن هو من فتح الباب للحرب الروسية الأوكرانية، بينما أوباما هو من وقع الاتفاق النووي مع إيران، وربما أيضا لأنه يعرف بأن الولاية الثانية هي الأخيرة، رغم أن عقله قد سوّل له بالتفكير بالترشح لولاية ثالثة، رغم عدم دستوريتها، ورغم انه تقدم في السن، وهذا أمر طالما أخذه على سلفه بايدن.
وكل ما اطلقه من تصريحات عقب دخوله البيت الأبيض مطلع هذا العام، اكد بأنه عاد ليكون رجل الأعمال، والتاجر في السياسة، ولا نشير بهذا إلى ما اتخذه من قرارات فيما يخص التعرفة الجمركية ضد معظم دول العالم وحسب، بل إلى إعلانه بأنه يفكر في ضم كندا، والسيطرة على غرينلاند، كذلك السطو على قناة بنما، وصولا إلى إعلانه عن تهجير سكان قطاع غزة، وتحويل القطاع بعد تدميره بالكامل، وطرد كل سكانه إلى ريفيرا شرق أوسطية لتقديم الرفاهية لأثرياء الشرق الأوسط، وذلك من قبل إدارة أميركية تستأجر القطاع لمدة عشر سنوات، فيما قد تكون هذه الإدارة تابعة للدولة أو للقطاع الخاص، حيث «ينال» هو شخصيا حصة الأسد.
بقي أن نشير إلى أن أسوأ ما ظهر على ترامب خلال ولايته الحالية، هو التأثير الشخصي على قراراته ومواقفه السياسية، وهذا أمر ضار جدا بمصالح الدولة الأميركية، لذا فإن تدخل أركان إدارته، خاصة نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، قد ظهر واضحا، واكثر مما يظهر عادة مع رؤساء أميركيين اكثر توازنا ونضجا وخبرة، ورغم انه بدأ ولايته بنرجسية هائلة، بسبب فوزه المفاجئ، ونجاحه في العودة مجددا بعد خروجه من البيت الأبيض، وهذا أمر غير مسبوق، وقد ظهر هذا لكل من تابع سلسلة تصريحاته المتغطرسة، ومنها ادعاؤه وقفه لسبع حروب في مناطق مختلفة من العالم، بعد أن كان يدعي بأن حرب روسيا ــ أوكرانيا ما كانت لتقع لو كان رئيسا، وانه سيوقفها بمجرد دخوله البيت الأبيض، ولأجل ذلك، أي لأنه وضع حدا لسبع حروب فهو جدير بجائزة نوبل، وكان هذا أمرا غريبا، فلم يسبق لأي سياسي في العالم أن اعلن عن رغبته في تلك الجائزة، أو انه اتبع سياسة ما من أجل هذا الهدف بالتحديد، وكل من نالها، منحت له الجائزة لأنه حقق لشعبه أو دولته سلاما جنبه أو جنبها ويلات الحروب.
وحتى بيل كلينتون الذي رعى اتفاق أوسلو لم يحصل على نوبل، بل إن من حصل عليه، كان الثالوث الذي صنعه: ياسر عرفات، شمعون بيريس واسحق رابين، ولعل «تشدق» ترامب الممض يظهر جليا حين يقول إنه وضع حدا لصراع مدته ثلاثة آلاف عام، بالإشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار على غزة، وهذا يجعل من طريق ترامب للسلام، حيث اعتبر أن ذلك الاتفاق هو مدخل سلام إقليمي، شاقا وصعبا ووعرا وليس مضمونا ولا بأي شكل، ذلك أن خطة ترامب ذات النقاط العشرين، قد تكون نسخة عن اتفاق يناير، أي تتوقف عند حدود مرحلة تبادل الأسرى والمحتجزين، ووقف مؤقت لإطلاق النار، ولا تضع حدا للحرب، لأن احتمال تجدد الحرب يبقى قائما، ما لم يواصل ترامب طريقه نحو نقيضها أي السلام، وحيث إن ذلك الطريق يبدو متعثرا، بالنظر إلى غموض تلك الخطة، والتي كانت كذلك لأن ترامب جمع فيها المتناقضات، فكان البند الأول واضحا، وعلى غير ذلك كانت البنود الأخرى، ولأن ترامب عقد تلك الاتفاقية ما بين نتنياهو من جهة وقادة الشرق الأوسط من جهة ثانية، فإنه بات يواجه قادة محنكين في السياسة: نتنياهو، أردوغان، السيسي، كما هو حاله مع بوتين، وهكذا يصطدم حتى في مجلس الأمن بمشروع القرار الروسي، الذي يحقق مهمة جذب مشروع القرار الأميركي نحو القرارات الأممية.
طريق ترامب الطويل نحو السلام
نشر 18 نوفمبر 2025 | 10:10