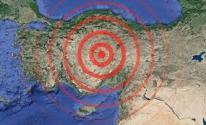لم يكن متوقعاً أن تكون تركيا أفضل لو أن الانقلابيين نجحوا في إسقاط نظام حكم العدالة والتنمية التركي، فهم إذا كانوا من أتباع الداعية فتح الله غولن الأميركي الجنسية، فإن النتيجة ستفضي إلى حرب أهلية، وتدمير الكثير من الإنجازات الهامة التي جعلت تركيا واحدة من الدول القوية على المستوى العالمي.
فوق ذلك، فإن حصول غولن على الحماية والدعم الأميركي كان سيذهب بتركيا بعيداً في الخضوع للسياسات والمصالح الأميركية على الرغم من أن تركيا قبل الانقلاب الفاشل وبعده، هي عضو نشط في حلف الناتو، وهي دولة بذلت جهداً مضنياً وطويلاً لاكتساب الهُويّة الأوروبية عَبر الانضمام الذي لم يتحقق والأرجح أنه لن يتحقق للاتحاد الأوروبي.
وبالنسبة للقضية الفلسطينية فإن تركيا الأمس واليوم، تقيم علاقات جيدة، واسعة ومتنوعة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وإن كانت، أيضاً، تعتمد سياسة تقوم على تأييد الحقوق الفلسطينية كما تقرها الأمم المتحدة. وإزاء الأوضاع المتفجرة في الجوار العربي كان لتركيا دور هام في دعم وتأجيج الصراعات الدامية الجارية في سورية والعراق دون أن تدرك ما هي مصلحتها في تغيير الأنظمة القائمة وفي تعرض البلدين العربيين لانقسامات جغرافية ذات أبعاد طائفية، من شأنها أن ترفع التطلعات القومية للأكراد بما في ذلك أكراد تركيا، إلى إقامة الدولة الكردية الكبرى.
ولكن وعلى خط مواز، فإن فشل الانقلاب، والآثار المترتبة عليه، من شأنها أن تضع تركيا "الجديدة" التي قال الرئيس رجب طيب اردوغان أنها ستكون غيرها القديمة، أمام تغيرات جذرية واسعة على مختلف الصعد.
ردود الفعل الداخلية على محاولة الانقلاب الفاشلة، والتي تؤشر إلى أن النظام بصدد حملة تطهير واسعة للمعارضة تبدأ بالمتهمين بمحاولة ومناصرة الانقلاب، وقد لا تتوقف قبل أن تشمل المعارضة التي أدانت الانقلاب، ونقصد المعارضة التقليدية.
من الواضح أن عملية التطهير تشمل فئات ونخباً واسعة من الجيش إلى الشرطة، والأجهزة الأمنية والمحافظين، والأوقاف، والمعلمين، والقضاة، والسلك الدبلوماسي ضمن عملية إقصاء وإحلال، لتحقيق التماثل بين الحزب والدولة.
خلال الساعات الأولى للمحاولة الانقلابية نهض بعض المتشككين بأسئلة تتهم النظام الحاكم بتدبير ما اعتبروه مسرحية الانقلاب، لتوفير مبرر قوي، للانقضاض على ما تبقى من نخب ومظاهر الدولة العلمانية، وتعديل الدستور بما يمنح الرئيس صلاحيات واسعة، في اطار بلورة الهُويّة الدينية للدولة والمجتمع.
في الواقع فإن التاريخ يقدم شهادات متعددة لدعم مثل هذه النظرية أي نظرية المؤامرة، لكن الأمر قد يكون مختلفاً في حالة تركيا، فالثابت هو أن المخابرات والرئاسة يعلمون أن محاولة انقلاب ستقع، وذلك قبل خمس ساعات من ساعة الصفر. هذا اعتراف رسمي تركي وليس تكهناً أو تحليلاً، وقد جاء بعد أن أدلى بعض المسؤولين الأوروبيين بتصريحات توحي بأن القوائم التي تشتمل على أسماء وصفات المعتقلين قد كانت معدّة مسبقاً. والسؤال هو إذا كانت السلطات الحكومية والمسؤولين يعرفون بأن انقلاباً سيقع قبل خمس ساعات فلماذا لم تبادر السلطات، لمنع وقوعه قبل أن يقع وتحصل كل هذه الدربكة وكل هذا الاضطراب، والضحايا؟
لا شك أن ثمة محاولة جادة لاستغلال حدث الانقلاب الفاشل، ما يعني أن السلطة كانت تنتظر هذه الذريعة أو غيرها لكي تقوم بما تقوم به من عملية تطهير واسعة، تمهد لتغيير في طبيعة النظام والصلاحيات، في اطار رؤية مختلفة لتركيا.
يعود بنا التاريخ إلى الانقلاب الذي قام به الزعيم مصطفى كمال اتاتورك عام 1922، وفي العام التالي أي عام 1923، اعلن قيام الدولة التركية الحديثة، بدءاً بدستور جديد أنهى مرحلة نظام السلاطين، إلى عملية إصلاح واسعة فتحت الأبواب واسعة أمام تطور تركيا الجديدة بهُويّة علمانية مختلفة.
هل يتطلع الرئيس اردوغان بعد ثلاثة عشر عاماً من حكم العدالة والتنمية، إلى انقلاب على العلمانية، وإعادة صياغة هُويّة الدولة التركية إلى زمن ما قبل الأتاتوركية، ولكن بلباس الحداثة، خصوصاً وأن الزمن لا يسمح بعودة عهد السلاطين بمواصفات القرن الماضي؟
لا شك أن ردود الفعل الدولية، خصوصاً من الاتحاد الأوروبي كاتحاد ودول ومن الولايات المتحدة الأميركية، ومن روسيا، وهي ردود فعل سلبية وحذرة إزاء ما يحصل في تركيا، كل ذلك يشكل مؤشراً، على ما سيأتي، وتحذيراً مما سيأتي في دولة كبيرة تشكل الجسر بين الشرق والغرب الأوروبي.
في عهد العدالة والتنمية حققت تركيا إنجازات كبيرة، خصوصاً في المجال الاقتصادي، حتى أصبحت بين أقوى خمس عشرة دولة في العالم، فهل يمكن لها أن تواصل هذا التقدم في ظل المرتقب من التحوّلات الداخلية، التي ترافقها تغيرات كبيرة على مستوى علاقاتها الدولية، وعلاقاتها بالمحيط الإقليمي، وفي ضوء أنواع وأشكال الصراعات المتفجرة والقابلة للانفجار في الأوضاع الداخلية؟ من الواضح أن تركيا قد أصبحت واحدة من الدول التي تحظى باهتمام وتركيز إعلامي وسياسي إلى أمد ليس قريباً.
هآرتس: حماس تتجه للموافقة على خطة ترامب مع بعض التعديلات
01 أكتوبر 2025