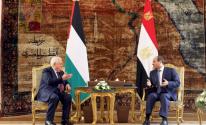يَعرِف تاريخ الأدب والفن نوعا من الحركات أو الأنماط التي تسود في مرحلة ما؛ فتجد أكثر من أديب يتبنى نمطاً أدبياً معيناً، لتنشأ مدارس أو تيارات، كالرومانسية والواقعية وغير ذلك. ويحدث هذا في الرسم، وحتى في الهندسة المعمارية، فيصبح هناك نوع من "الموضة" الأدبية والفنية والفكرية. ويكفي أن تنظر للتاريخ الفلسطيني المعاصر، لتعرف الارتباط بين السياسي والوطني من جهة، والفن والأدب من جهة أخرى.
بعد حرب الخليج الثانية العام 1991، وبدء مؤتمرات ومفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، دخل المغنون والموسيقيون الذين كرسوا غناءهم لفلسطين، في حالة كمون تام تقريباً. ذهب مارسيل خليفة اللبناني للموسيقى والأوركسترا، وذهب سميح شقير، السوري، ليصدر شريطاً غنائياً ساخراً من تهافت الموسيقى ومحدثي النعمة وأمور أخرى لا علاقة لها بالوطن. ودخل أحمد قعبور، اللبناني، في حالة كمون، مركزاً على أعمال موسيقية منوعة في موضوعات شتى. وانتهت الفرق الفلسطينية تقريباً، مثل فرقة "العاشقين".
قرب العام 2010، صدرت عدة أعمال موسيقية جديدة؛ فغنى شقير أسطوانة من كلمات محمود درويش، إحياءً لذكراه، وغنى أحمد قعبور رائعته "شمس الأغاني"، ضمن ألبوم جديد "بدي غني للناس". وعمل الإنسان الوطني الفلسطيني، مالك ملحم، على جمع شتات فرقة "العاشقين" وإعادة إطلاقها، بتمويل ذاتي منه.
كانت تلك الأعمال نوعا من التبشير بنَفَس جديد يطل على العالم. ولم يَحدُث شيء فلسطينياً، ولكن عربياً كان "الربيع العربي"، قصير العمر. وغنى شقير للثوار في سورية "قربنا يا الحرية"، وغنى قعبور لذات الثورة. وكل ذلك قبل ظهور "داعش" وغيره.
موضوع هذه المقالة هو عن ملاحظتين في الرواية الفلسطينية، وتساؤل عن معناهما. الأولى، تتصل بالتاريخ. والثانية بالجغرافيا. فمن إبراهيم نصرالله، إلى سحر خليفة، إلى يحيى يخلف، إلى إلياس خوري، ظهر الذهاب إلى التاريخ غير المعاصر في أعمال أدبية.
ذهب نصرالله إلى العصر العثماني في "زمن الخيول البيضاء"، وذهبت خليفة إلى ثورة 1936 وثورة عزالدين القسّام وما قبلها في رواية "أصل وفصل"، وذهب يحيى يخلف في روايته "راكب الريح" إلى أساطير يافا القديمة، والعصر العثماني والقرن الثامن عشر، وأرسل بطل روايته لدمشق والهند ليتعلم التأمل والتخاطر، وكيف يستخدم الطاقة الكامنة في الإنسان ليأتي بأعمال شبه إعجازية في مواجهة التسلط العثماني، ومواجهة جيوش نابليون بونابارت. أما إلياس خوري، فوصل في روايته "أولاد الغيتو.. اسمي آدم"، حتى الأمويين وقصة الشاعر "وضّاح اليمن"، وكيف "ربما" دفنه الخليفة الوليد بن عبدالملك، في دمشق، وهو في صندوق بعد أن اكتشف أو شَكَّ أن زوجته "أم البنين" (روضة)، تخفي الشاعر اليمني الذي تعشقه في صندوق في غرفتها، فطلب منها الصندوق، ولم يفتحه بل أمر عبيداً له أن يحفروا بئراً عميقة في مجلسه. ولم يفتح الصندوق ليتأكد من حديث الوشاة، بل "دعا بالخدم وأمرهم بحمله، حتى انتهوا به إلى مجلسه"، ثم إنه "دعا بالصندوق، فقال: يا هذا إنّه قد بلغنا شيء، إن كان حقّاً فقد كفّناك ودفناك ودفنّا أثرك إلى آخر الدهر. وإن كان باطلا فإنا دفنا الخشب، وما أهون ذلك!". وبعد هذا انطلق خوري، من القصة ذاتها، يتحدث عن وضع الفلسطينين الذين بقوا في مدن فلسطين المحتلة العام 1948، وخصوصاً في اللد ووادي النسناس في حيفا، وغيرهما.
غير الذهاب للتاريخ، ذهب الروائيون الذين كتبوا عن فلسطين مؤخرا، وهم من جنسيات عربية عدة، إلى البحث عن الفلسطينيين في أوروبا والغرب.
فكتبت رضوى عاشور عن مجزرة الطنطورة منذ ما قبل العام 1948. ولكنها لحقت أهل الطنطورة إلى كندا وكتبت عنهم هناك. كما ينتقل بطل رواية إلياس خوري سالفة الذكر من اللد وحيفا إلى نيويورك. وكتبت جنى الحسن أيضاً عن بطل رواية ينتقل من صبرا وشاتيلا إلى الطابق 99 في نيويورك. وكتبت سامية عيسى عن اللاجئين في كوبنهاغن.
هل هذا هروب إلى التاريخ أو أماكن مختلفة حول العالم، لأنّ الحاضر وحياة الفلسطينيين الراهنة في فلسطين ومخيمات اللاجئين، صارت بلا معنى؟ أو أصعب من أن تروى؟
ربما هي دمجٌ للفلسطينيين في تاريخ أبعد، وجغرافيا أوسع، حتى يتحولوا لقبيلة عالمية مليئة بالأساطير، تمهيداً لانطلاقة طير الفينيق (العنقاء) الفلسطيني مجددا.