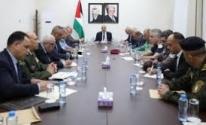بعد مرور أكثر من 10 سنوات على وقوع الانقسام، وبالرغم من الاتفاقات والمبادرات التي لا تنقطع، لا يزال الانقسام مستمرًا، ويتعمق أكثر وأكثر، لدرجة أنه تمأسس، وأصبحت هناك بنية كاملة تعززه، فبتنا أقرب إلى الانفصال وأبعد عن الوحدة.
السؤال الذي سأحاول الإجابة عنه في هذا المقال: لماذا تفشل جهود ومبادرات المصالحة بالرغم من وجود حاجة فلسطينية ملحة لتحقيقها، مستمدة من أن الاستعمار الاستيطاني الاحتلالي الإحلالي يستهدف الفلسطينيين دون تمييز بينهم؟
هناك من يقول إن اختلاف البرامج والمصالح هو ما يمنع تحقيق الوحدة، على أساس أن حركتي فتح وحماس تسيران في خطين متوازيين ولن تلتقيا. وآخر يقول إن قرار الوحدة ليس بيد الفلسطينيين، حتى وإن أرادوا، وإنما تتحكم به إسرائيل والأطراف العربية والإقليمية والدولية.
أوحت "ملحمة القدس"، والتصريحات الإيجابية التي صدرت إبانها من طرفي الانقسام (وهذا تعبير صحيح رغم احتجاج الطرفين)، ولقاء وفد من "حماس" في الضفة مع الرئيس محمود عباس، و"نداء القدس" الصادر بمبادرة من "وطنيون من أجل إنهاء الانقسام"، وزخم الوسطاء وأصحاب المبادرات؛ أنّ ملف الوحدة قد تحرك، ولكن سرعان ما بدا أن ذلك أضغاث أحلام، فالرئيس كما أعلن بعظمة لسانه ماضٍ في إجراءاته العقابية مع أنها أدت إلى نتائج عكسية، ومتمسك بمبادرته ذات النقاط الثلاث التي تهدف إلى استعادة قطاع غزة من خلال رضوخ "حماس" لشروطه، وانضوائها تحت مظلة السلطة الواحدة.
في المقابل، "حماس" ماضية في خطتها الرامية إلى الاحتفاظ بسيطرتها الانفرادية على القطاع، ومراكمة إنجازات جديدة، حيث أصبحت مسألة رواتب موظفيها قضية القضايا.
ضمن هذا الفهم نعتبر أن مطالبة طرف بحل اللجنة الإدارية أولًا، ومطالبة الطرف الآخر بوقف الإجراءات العقابية أولًا مجرد ذرائع، بدليل أن الانقسام مستمر قبل تشكيل اللجنة وتطبيق الإجراءات، لذا فإن سحب هذه الذرائع على أهميته لا يحل شيئًا، فقد كنّا في وضع أفضل بكثير وانهار، عندما تم تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد توقيع "اتفاق مكة"، وتشكيل حكومة وفاق وطني بعد "إعلان الشاطئ"، ما يعني أن إعادة إنتاج الوصفات السابقة، حتى لو انتهت إلى تشكيل حكومة جديدة متفق عليها، لن يكون مصيرها أفضل من سابقاتها. فالمخرج واضح وضوح الشمس، ويكمن في تجسيد الشراكة في السلطة والمنظمة بين مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي على أساس أن تتخلى "حماس" عن سيطرتها الانفرادية على القطاع مقابل أن تتخلى "فتح" عن هيمنتها على النظام السياسي.
إذا كانت الوحدة مستبعدة - رغم أنها ضرورة - حتى إشعار آخر، فما الحل إذًا؟ الحل يكمن في ظهور طرف ثالث يحمل رؤية وبرنامجًا، وعابر للفصائل، ومنتشر في جميع أماكن تواجد الشعب الفلسطيني (ليس حزبًا جديدًا وإنما تيار وطني عريض)، يضم كل المتضررين من استمرار الانقسام والحريصين على حماية القضية والشعب والأرض، ويشكل أداة ضغط تكبر إلى حد يمكن فرض إرادة ومصلحة الشعب بإنجاز الوحدة، ويكون هدفه إنقاذ القضية قبل فوات الأوان. فليس صحيحًا أن الوحدة لا يمكن أن تتحقق بإرادة الفلسطينيين مع إدراك التأثير الهائل للأطراف الخارجية، خصوصًا أنها لا تتخذ موقفًا واحدًا وإنما هناك تنافس مستعر بين محاور مختلفة عربية وإقليمية ودولية، ويمكن توظيفه إذا توفرت القناعة والإرادة الفلسطينية.
إذا نظرنا إلى خارطة الوضع الفلسطيني، نجد أن الرئيس وطرفي الانقسام يتحملون المسؤولية الأساسية عن وقوعه، كل بحسب الصلاحيات والإمكانيات، وبعد ذلك تتحمل الأطراف والفصائل الأخرى قسطها من المسؤولية.
وهنا سنتوقف أمام فشل الداعين إلى إنهاء الانقسام، بما يشمل فصائل وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني وغيرها من المؤسسات والشركات والأفراد والنشطاء والشخصيات الاعتبارية، فالمبادرون والوسطاء "أكثر من الهم على القلب"، ومع ذلك تأثيرهم محدود للغاية، والانقسام بدلًا من أن يتراجع يتفاقم، لدرجة أن الخشية تكبر من امتداده إلى مناطق أخرى، فهو مثل النار التي إذا لم تحاصرها تمهيدًا لإطفائها ستأكل الأخضر واليابس.
لقد فشل هؤلاء جميعًا لأن طرفي الانقسام لا يزالان يحصلان مجتمعَين على النسبة الأكبر من التأييد وعناصر القوة والمال والإعلام والحلفاء، إلى جانب أن أقسامًا من هؤلاء تدور في فلك هذا الطرف أو ذاك.
كما فشلوا لأن حدة الاستقطاب تتفاقم ووصلت إلى حد أنهم يقومون بدورهم، وبمن فيهم شخصيات اعتبارية، كوسطاء وليسوا شركاء، فهم يقومون بمساعٍ حميدة للتوفيق بين طرفي الانقسام، عبر تقديم اقتراحات وسطية متوقع أن يقبلها المنقسمون، لذلك تأتي حمّالة أوجه يفسرها كل طرف كما يحلو له، ما يعني أن ما يمكن أن يحدث في أحسن الأحوال بفضل هذه الوساطة تقاسم الحصص والمكاسب، في حين أن المطلوب إنهاء الانقسام في سياق إحياء القضية الوطنية وإعادة بناء الحركة الوطنية في إطار منظمة التحرير بوصفها المؤسسة الوطنية الجامعة، لتكون قادرة على الاستجابة للتحديات والمخاطر وتوظيف الفرص.
إضافة إلى ما سبق فإن دعاة الوحدة غير موحدين، بل مستنزفون في صراعات ومنافسات فردية وفئوية على المصالح والمكاسب والوظائف المتبقية، وتلك التي يمكن الحصول عليها من أحد الفريقين أو من كليهما، إذ بات همهم الاحتفاظ بالمواقع القليلة التي حصلوا عليها في السلطة والمنظمة والمجتمع والمخصصات الشهرية لفصائلهم، ورمي كل منهم لمسؤولية عدم التحرك الفاعل والضاغط لإنجاز الوحدة على الطرف الآخر.
لا يمكن أن نسقط من الحساب، ونحن نتحدث عن فشل جهود ومبادرات الوحدة، أن هناك فئات تريد إنهاء الانقسام مكتفية بترديد هتاف "الشعب يريد إنهاء الانقسام" وكأنه وقع كصاعقة في سماء صافية وليس بسبب جذوره وأسبابه وأطرافه التي عملت على وقوعه وتعميقه، لذا لا بد من الاتفاق أولًا على أي أساس يجب أن يتم إنهاء الانقسام، حتى لا تعيد الوحدة المفترض تحقيقها من خلال هذا الطريق إعادة إنتاج الوضع الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه.
كما أن هناك مجموعات أو أفراد يريدون تصفية حسابهم مع الحركة الوطنية و"حماس" و"الجهاد" وكل قوى الثورة والمقاومة، سواء لأنهم من أحزاب أخرى، أو لأنهم من جماعات مصالح الاحتلال والانقسام التي ازدادت ثروة ونفوذًا بصورة لم تكن تحلم بها، لذلك يريدون المحافظة على الوضع الراهن، ومنهم من يسعى إلى ترتيب أوراقه في الوضع الجديد استعدادًا لما هو قادم.
يوجد رأي قوي لا يزال يراهن على الوضع القائم بمكوناته، لأنه يخشى من التغيير والمجهول القادم، ومن غياب البدائل الفضلى، ورأي آخر يائس تمامًا من القوى القائمة ويسعى إلى تغييرها أو دفنها، والانطلاق مجددًا بعيدًا عنها دون أن تنضج مقومات البديل، متجاهلًا أن سقوط القديم من دون بديل أفضل منه سيفتح الباب لما هو أسوأ، فالجديد يولد من رحم القديم. وتغيير الواقع يكون من خلال التعامل معه لتغييره وليس لتكريسه أو القفز عنه.
كل ما سبق نتيجة طبيعية لتقادم القوى والهياكل السياسية الفلسطينية لفترة طويلة دون تغيير وتجديد وإصلاح، وفشلها في تحقيق أهدافها مع اختلاف الأسباب وتفاوت المسؤوليات، بحيث لم يعد المشروع الوطني واضحًا ولا متفقًا عليه، وانتشار مقولات محبطة مثل "إنقاذ ما يمكن إنقاذه"، والإمساك بالعصفور الذي في اليد، وهو السلطة، أفضل من العصافير التي على الشجرة، مع اتضاح أن ما في اليد ليس عصفورًا، وإنما فخ بحاجة إلى كسر قيوده وإعادة بنائه من جديد.