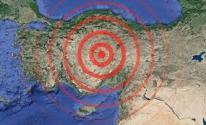الحدث التركي حافل بالرسائل المهمة التي تستحق الدراسة والاعتبار.
(1)
لن ينُسى منظر التركي الذي سجله شريط الفيديو حين خرج بسيارته في منتصف الليل وعرقل بها سير دبابة تابعة للانقلابيين، ولا ذلك الذي تمدّد على الأرض أمام عجلات دبابة أخرى ليوقف تقدّمها، ولا أولئك الذين تجمّعوا حول الدبابات والمدرعات واعتلوها رافعين الأعلام التركية، ومعلنين رفضهم للعملية الانقلابية. أما الحشود التي خرجت إلى الشوارع والميادين بثياب النوم وتلك التي تجمّعت في المساجد، فإنها شكلت حالة استنفار شعبي نادر، أغلب الظن أنه فاجأ الانقلابيين وأسهم في إحباط محاولتهم.
أما موقف الأحزاب الرئيسية الذي رفض المحاولة، وفي المقدمة منها تلك التي عارضت أردوغان وتصارعت مع ممثلي حزب «العدالة والتنمية» في البرلمان، فدلالته من الأهمية بمكان. إذ لا يكفي تفسير كل ما سبق أن يُقال إنه يعبر من ناحية عن مدى شعبية أردوغان، كما أنه يعبر من ناحية ثانية عن حرص الأحزاب على استمرار العملية الديموقراطية. ذلك أن ثمة خلفية خاصة بالمجتمع التركي أزعم أنها تكمن وراء الاستنفار الجماهيري ووقفة الأحزاب المناهضة للانقلاب. آية ذلك أن الأتراك وأحزابهم لهم خبرات عديدة ومريرة مع انقلابات العسكر وحكمهم.
إذ منذ أول انقلاب في العام 1960 وخلال الانقلابات الثلاثة التالية (خلال السنوات 1971 و1980 و1997، إضافة إلى نصف الانقلاب الذي أطاح بحكومة نجم الدين أربكان زعيم حزب «الرفاه» الإسلامي)، فإنهم أدركوا أن الانقلابات العسكرية لا تدمّر السياسة فحسب، لكنها أيضاً تضع الدولة على عتبات الاستبداد والفاشية. يضرب المثل في ذلك بانقلاب العام 1980 الذي قاده الجنرال كنعان إيفرين وكانت حصيلته كالتالي: اعتقال 650 ألف شخص، إصدار أحكام بالإعدام على 517 شخصاً وتنفيذه في خمسين منهم، فصل 30 ألف شخص من وظائفهم، تجريد 14 ألفاً من الجنسية التركية، ترحيل 30 ألفاً إلى خارج البلاد، وفاة المئات تحت التعذيب وتعرُّض العشرات للاختفاء القسري، حبس عشرات الصحافيين، ومنع أكثر من 900 فيلم.
(2)
إن أي متابع لتاريخ تركيا الحديث يدرك أن الجيش له مكانته الجليلة في المجتمع التي تكاد ترفعه إلى مرتبة التقديس. إذ إلى جانب أنه يطلق عليه «جيش محمد» (عليه الصلاة والسلام)، فإن بعض المؤرخين يصفون الدولة العثمانية بأنها كانت «عسكرية جهادية» في المقام الأول. ثم إن دوره في إنقاذ الدولة من الهزيمة والانهيار في الحرب العالمية الأولى رفع عالياً مكانته وعمّق من الاعتزاز به لدى الجميع. إلا أن إنجازاته الكبيرة في الحرب دفاعاً عن الوطن ظلت في كفة، وأداءه في السياسة وإدارة البلد في كفة ثانية. والأولى بقيت في صالحه على طول الخط، أما الثانية فقد حوّلتها معاناة الخبرة التركية إلى خط أحمر، ولم يكن ذلك إقلالاً من دور الجيش بطبيعة الحال، لكنه كان اقتناعاً بأن خوضه في السياسة وتحوّله صانعاً لها بمثابة سحب من رصيده المقدر وتوريط له في ما لا يجيده. في هذا الصدد، يحسب للرئيس رجب طيب أردوغان أنه أخرج الجيش من السياسة وأعاده إلى موقعه الطبيعي لكي يصبح خاضعاً لها وليس صانعاً لها.
وإذ يُسجل للرئيس أردوغان من الناحية التاريخية أنه ردّ للسياسة اعتبارها في تركيا، وطوى صفحة حكم العسكر بإعادتهم إلى موقعهم الطبيعي في حماية حدود الوطن، فإنه ينبغي أن يُحسَب للنخبة وللأحزاب السياسية وللجماهير التركية أنها ارتقت بوعيها على نحو ظهر جلياً في موقفها إزاء المحاولة الانقلابية. إذ يعلم كثيرون أن معارضة النخبة والأحزاب بوجه أخصّ تزايدت في الآونة الأخيرة، وأن التحفظات على سياسة الرئيس أردوغان تعالت مؤشراتها خلال تلك الفترة. مع ذلك، فإن خصوم الرجل وناقديه كانوا بين الذين خرجوا معارضين للانقلاب حين ذاع خبره مساء يوم الجمعة 15/ 7. وليس دقيقاً القول بأن المظاهرات كلها كانت مؤيّدة لأردوغان، لأن منها ما كان معارضاً له، لكنه رافض حكم العسكر ومؤيد للديموقراطية كما سبقت الاشارة. إذ أدركت الأحزاب والنخب المعارضة أن مخاصمة الرئيس لا ينبغي أن تعالج بتسليم الحكم للعسكر، وأن الذي جاء بانتخابات ديموقراطية يجب ألا يرحل أو يُنحّى إلا من خلال الانتخابات الديموقراطية، خصوصاً أن خبرة السبعين سنة الأخيرة أقنعتهم بأن الوضع السياسي إذا كان سيئاً فلا ينبغي له أن يُعالج بما هو أسوأ. فضلاً عن أنهم لم يكونوا بحاجة لمن يقنعهم بأن حكم العسكر هو الأسوأ في تاريخهم السياسي، وأن الاستبداد على فرض وجوده ينبغي ألا يعالج باستدعاء الفاشية، لأن العور في أسوأ حالاته يظل أفضل من العمى. وتلك هي الرسالة الأهم في الحدث التركي.
(3)
برغم أن الصورة لم تتبلور تماماً أو لم يُتح لنا أن نتعرف على خلفيات ما جرى، فإن القدر الذي ظهر منها إلى العلن يستدعي ملاحظات أخرى في مقدمتها ما يلي:
ـ أن حظوظ الانقلابات في تركيا تتراجع بمضي الوقت، إذ من متابعة الانقلابات التي توالت منذ العام 1960، نلاحظ أن الثلاثة الأولى تكللت بالنجاح بمعدل انقلاب كل عشر سنوات (1960 ــ 1971 ــ 1980)، أما الرابع فقد وقع بعد 17 سنة (العام 1997)، وكان نصف انقلاب لم يُسفر عن أي ضحايا، ومن ثم وصف بأنه انقلاب أبيض أو ما بعد حداثي. إذ اكتفى العسكر فيه بإجبار رئيس الوزراء نجم الدين أربكان على الاستقالة، ثم مارسوا إجراءات قمعية ضد رموز التيار الإسلامي تراوحت بين المصادرة والاعتقال. أما المحاولة الخامسة والأخيرة فقد تمّت بعد نحو عشرين عاماً من الرابعة وباءت بالفشل تماماً.
ـ إن ما جرى جاء دالاً على أن التآمر على تركيا الديموقراطية لم يتوقف. وأن القوى المتربّصة بالديموقراطية أو بالهوية الإسلامية للبلد لا تزال كامنة وتتحيّن الفرصة للانقضاض كلما وجدت ثغرة استطاعت النفاذ منها. وبرغم أن توجيه الاتهام إلى فتح الله غولن المقيم في أميركا وجماعته التي وصفت بالتنظيم الموازي، فإنه لم تتوافر لنا أدلة كافية تقنعنا بحقيقة الأطراف التي وقفت وراء المحاولة. ذلك الانقلاب على نظام قوي في بلد كبير مثل تركيا يتطلب تخطيطاً محكماً تشارك فيه أطراف عدة في الداخل والخارج، وإلا تحوّل إلى مغامرة طائشة وحماقة كبرى.
• أن الأحزاب التركية أثبتت حضوراً قوياً ورؤية رشيدة وثاقبة، والموقف المسؤول الذي اتخذته إزاء المحاولة الانقلابية اتسم بنضج يستحق الحفاوة والتقدير لو أثبتت أنها ليست مجرد لافتات بغير مضمون أو جمهور، كما أنها نجحت في تنحية خصومتها للرئيس أردوغان ونظامه جانباً، وأعربت عن انحيازها للديموقراطية وللمصلحة العليا للبلد.
ـ أن الرئيس رجب طيب أردوغان الذي أعرب أكثر من مرة عن ضيقه بحملات وتسريبات مواقف التواصل الاجتماعي لم يجد وسيلة لمخاطبة الرأي العام التركي بعد استيلاء الانقلابيين على التلفزيون الرسمي سوى باللجوء إلى تطبيق ـ «فيس تايم»، أي أنه استخدم الأسلوب نفسه الذي سبق أن لجأ إليه معارضوه لمناكفته.
ـ أن موقف الأوروبيين من المحاولة الانقلابية كان واضحاً فيه منذ وقت مبكر الانحياز إلى الديموقراطية، أما الموقف الأميركي فقد كان متراخياً ومراوغاً في البداية، ولكنه انحاز إلى جانب الديموقراطية والشرعية في تركيا حين بدا أن الانقلاب لم يسيطر تماماً على السلطة في أنقرة.
(4)
بقيت عندي كلمتان إحداهما تتعلق بنا في العالم العربي، أما الثانية فتخص أسئلة المستقبل في تركيا. ذلك أن صدى الانقلاب في العالم العربي جاء كاشفاً لخرائطه السياسية وفاضحاً في بعض جوانبه. إذ إن المنابر المعبرة عن قوى الثورة المضادة والمعارضة للديموقراطية ولـ «الربيع العربي» هللت لمحاولة استيلاء العسكر على السلطة، وسارعت إلى التبشير بنجاح الانقلاب. أما الإعلام المصري فقد كان موقفه في مجمله محزناً وبائساً، عبر عن ذلك بعض مقدمي البرامج في القنوات التلفزيونية الذين لم يخفوا فرحتهم وشماتتهم. حتى أن أحدهم بدا مبتهجاً وبشر المشاهدين بأن محاولة استيلاء العسكر على السلطة هو ثورة وليست انقلاباً. أما أغلب الصحف فقد أبرزت في عناوين طبعتها الثانية شيئاً واحداً، هو أن الجيش أطاح بأردوغان وهو ما عبرت عنه «الأهرام» و«المصري اليوم» و«الوطن»، والأخيرة ذكرت في أحد عناوينها أن الرئيس التركي طلب اللجوء إلى ألمانيا. وحدها صحيفة «الشروق» لم تقع في الفخ وصاغت الخبر بأسلوب مهني ومحتشم، حين تحدثت في عنوانها الرئيسي عن «محاولة انقلاب في تركيا وأردوغان يعلن إحباطها». وكانت حصيلة تلك الإشارات دالة على أن وسائل الإعلام المصرية وبعض القنوات العربية شُغلت بتصفية الحساب مع الرئيس أردوغان بأكثر مما شغلت برصد الحقائق كما تفاعلت على الأرض.
الكلمة الثانية تتعلق بسياسة الرئيس رجب أردوغان في المرحلة المقبلة، ذلك أني أفهم أن يحاسب الضالعين في المحاولة وأن يوقع عليهم العقاب الذي يستحقونه، لكني تمنيت أن يتصرف باعتباره رئيساً لدولة ديموقراطية وليس باعتباره أسداً جريحاً. أعني أتمنى أن يحتكم إلى القانون وإلى قيم العدل ومبادئ حقوق الإنسان، لا أن يستسلم للانفعال ويعمد إلى الانتقام من معارضيه وملاحقتهم. وبرغم أن شبهات كثيرة مثارة حول دور معارضه اللدود فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، إلا أني لم أسترح إلى المسارعة لاتهامه من دون دليل وقبل أن تثبت التحقيقات ذلك. وتساورني الشكوك ذاتها إزاء القرارات المتعجّلة التي أدّت مثلاً إلى فصل 2700 قاضٍ من وظائفهم بسبب الشبهات التي أثيرت حول موقفهم من العملية الانقلابية. ولأن الوعي بقيمة الديموقراطية كان من العوامل المهمة التي أسهمت في إفشال الانقلاب، فإني أضمّ صوتي إلى مَن قال إن أردوغان خرج من التجربة أكثر قوة، وأتمنى عليه أن يصبح أكثر ديموقراطية
أهم رسائل الانقلاب الفاشل في تركيا
نشر 19 يوليو 2016 | 10:41