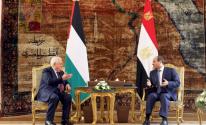مع الأنباء عن تنسيق وعمل عسكري مشترك محتمل يجمع الروس والأميركيين في سورية، لا تختلط حسابات مؤيدي موسكو والنظام السوري وحسب، بل وحتى بعض معادلات علم العلاقات الدولية. ويمكن لمزيد من توضيح المسألة أن نرى بجانب التنسيق الروسي-الأميركي، موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، غير مبالية بفكرة بروز الاتحاد الأوروبي كحلف، تقوده ألمانيا، بما يضر بمصالح لندن.
لقد تبلورت عبر الزمن، وخصوصاً منذ الحرب العالمية الثانية، وظهور ما يسمى النظرية الواقعية في العلاقات الدولية على يد هانز مورغنتاو، في كتابه "السياسة بين الأمم"، وغيره الكثير من الباحثين، مسلمات منها أنّ الدولة تسعى دائماً إلى القوة، وإذا حققتها سعت إلى الهيمنة على محيطها الإقليمي، ومن ثم إلى مدّ الهيمنة قدر الإمكان. ومن هنا مثلا، نجد بعض الواقعيين، مثل جون ميرشايمر، يسخر من فكرة أنّ الصين مثلا يمكن أن تصبح قوة اقتصادية عظمى من دون أن تفكر في التحول لقوة سياسية وعسكرية في محيطها الإقليمي على الأقل، ومنع الولايات المتحدة من التمدد هناك، وبالتالي حدوث تنافس عالمي بين الصين والولايات المتحدة.
ومن الأفكار التي يبلغ عمرها آلاف السنوات، والتي أعادت النظرية الواقعية توظيفها، مسألة توازن القوى، وأنّ الدول تخشى دائماً من تعاظم قوة الدول الأخرى، وتدخل في تحالفات، أو تخرج منها وتعيد تشكيلها، لتتوازن ضد دولة أو أحلاف تتزايد قوتها بما يخل بالتوازن.
أحد الأسباب التي تفسر عدم خشية الولايات المتحدة من التمدد أو الدور الروسي في سورية، هو التفاوت الهائل في القوة بين الطرفين. وإذا أخذنا المتغير الاقتصادي على سبيل المثال، نجد أن الاقتصاد الأميركي هو الأكبر عالمياً، فيما الاقتصاد الروسي في المرتبة الثانية عشرة (بحسب أرقام العام 2015). ويبلغ الدخل القومي الأميركي نحو أربعة عشر ضعف الاقتصاد الروسي. وعلى الصعيد العسكري، وفي الشرق الأوسط على سبيل المثال، تنتشر قواعد عسكرية أميركية وقوات، بينما لا تمتلك روسيا شيئا تقريباً عدا ما يوجد في سورية. ولكن هناك سبب آخر هو أولوية الاعتبارات المحلية الداخلية.
في حالة بريطانيا، لنا أن نتخيل لو أننا عشية الحرب العالمية الثانية، وهناك "اتحاد" يضم ألمانيا وفرنسا، ومعهما خمس وعشرون دولة أوروبية، فما هي حالة الخوف أو الغضب البريطاني المتوقعة حينها؟!
لقد كان انسحاب بريطانيا مبرراً بالرغبة في آلية صناعة قرار أكثر سرعة واستقلالية عن باقي الأوروبيين، وحرصاً على عدم الخضوع للمعايير الأوروبية في قبول المهاجرين، سواء من الشرق أوسطيين، أو -وربما هو الأهم في حالة بريطانيا- الآتين من جنوب وشرق أوروبا نفسها. وبالتالي فإن الاستقلالية الداخلية، والمعايير الداخلية، كان لها الأفضلية على حسابات موازين القوة العالمية، وعلى مسألة النفوذ الدولي.
الاعتبارات الداخلية هي أيضاً جزء أساسي من قرار إدارة باراك أوباما تقليص التدخل الأميركي في سورية، والخوف من التورط في حرب جديدة تحتاج لإمكانات مالية وجنود. وبدلا من ذلك، يجري التعاطي بإيجابية مع الدور الروسي، بما يشبه الشعور بالقدرة على تسخير موسكو لخدمة المصالح الأميركية، مع الاطمئنان إلى فجوة القوة الهائلة بين البلدين، وإلى أنّ القوى الأوروبية والكبرى الأخرى، مثل الصين، ليست في وارد التحالف مع موسكو، لأسباب منها أنّ أولوية هذه الدول هو البعد الداخلي ولاسيما الاقتصادي والتنموي، ولأنّ لهذه الدول مصالح كبيرة اقتصادية مع الولايات المتحدة، لن تضحي بها.
إذن، هناك ثلاثة متغيرات أساسية، لا يمكن فهم دور أي منها من دون ربطه بالمتغيرين الآخرين. أول المتغيرات، أنّ مدّ الهيمنة الخارجية من دون سقف ومن دون تحفظ ولو على حساب الإمكانات المتوفرة داخلياً، لم يعد هو الخيار الأول للدول، بما فيها الكبرى، فالاعتبارات الداخلية لها أهمية كبرى. والمتغير الثاني، أنّ فكرة التحالفات الدولية باتت تأخذ معنى مختلفا، فلم يعد تجمع أي دولتين يُرى بأنه موجه لطرف ثالث، أو يؤثر بطرف ثالث. والمتغير الثالث، أنّ العولمة وحرية التجارة والمصالح المتبادلة، قلّصت الحاجة للهيمنة عبر القوة العسكرية، والنفوذ المباشر عبر التواجد المادي.
هذه متغيرات تحتاج لأخذها بالاعتبار عند تحليل العلاقات الدولية في المرحلة الراهنة.
عن الغد الاردنية
تغيّر أهداف الدول العظمى؟
نشر 21 يوليو 2016 | 09:50