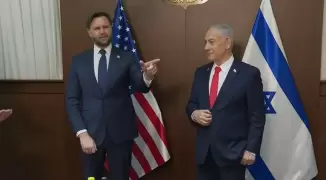دخلتْ المنطقة العربية والإقليم، منذ عقد ويزيد، مرحلةً جديدة، أكثر ما يميّزها، صعود قوى متطرّفة دموية إرهابية داعشية تدّعى الإسلام، إضافة إلى أن المشهد أصبح، في أتون عملية التحوّل، ملتبِساً على الجميع، وعمّت الفوضى والدمار ، وكذلك تسارع التطبيع العربي الرسمي المجّاني مع دولة الاحتلال، ما يعني تجاوز ما عُرف “بخطة السلام” التي شكلت نقطة إجماع للسياسة العربية، بعد أن تشتت وتفسخ الاجماع العربي على غير مسألة وقضية، وتغيّرت المعادلات السياسية الاقليمية والدولية، واختلفت التحالفات، بعد أن أنتجت القوى العظمى،خاصة الولايات المتحدة، نوعاً جديداً من التحالف، لا يستند إلى وحدة الأُمّة والتاريخ، بل إلى وحدة المخاوف، فانتجت تحالف الخائفين، مستفيدة من لحظة الانهيار العربي وتفكّك مقومات الوحدة الداخلية للدولة القُطرية، بعد أن دخلت عدة دول عربية إلى أتون الحروب الداخلية، فَوصِفت دول عربية بالفاشلة، وزحفت دولٌ على بطونها إلى بوابة البيت الأبيض، حفاظاً من حكّامها وعلى بقاء عروشهم، فانهار مفهوم التضامن العربي، ودخل مفهوم الوحدة العربية إلى قاموس الأماني المؤسوف عليها، الأمر الذي أطاح بالوزن السياسي للمنظومة العربية والوزن العربي بشكل عام، وأفقَد فلسطين حلفاءها التقليديين، بعد أن أصبح أشقاؤها حلفاءَ أعدائها، وأصدقاؤها طابورَ انتظارٍ على بوابة صداقة دولة الاحتلال.. الأمر الذي جعل دولة الاحتلال تسارع وتُصعّد وتضاعف إجراءاتها في الإحلال والقمع وأسْرلة كل فلسطين واستيطانها، ورفض أيّ صيغة للتفاوض،وإعلاء جدار الانغلاق أمام أي تسوية مع الفلسطينيين.. في لحظة ظلّ فيها الانقسام سيّد الموقف، ما يعرّض القضية الفلسطينية برمّتها إلى الشطب والفناء،فضلاً عن تعرّض المنقسمين للابتزاز وفرض شروط الاحتلال على الجميع. وبالمقابل فإن الثورة -منظمة التحرير الفلسطينية – التي دخلت أزمة بنيوية وأخرى ظرفية صعبة يبدو أنها تعبر إلى عتمة أزمة وجودية، ما يدفعنا إلى التبؤّر فيما يعترضها وينهكها، وما يتطلّبه الأمر من خطوات. لذا أصبحت فالثورة مقصدَ الأعداء حرباً واستهدافاً. وعندما استعصى على المحتل تدميرها وإقصائها عن المشهد السياسي خاصة بعد الخروج من بيروت، بدأت بالبحث عن صيغ أخرى لتطويعها أو تغيير وظيفتها، مستفيدين من حرب الخليج وسقوط العراق في براثن المحتلّ الأمريكي، وتواجد الحليف الأقوى لإسرائيل على بوابة معظم العواصم العربية، ليطلّ مشروع التسوية السياسية ويحلّ مكان مشروع التحرير، ولتصبح الثورة بعد أوسلو ليست كما قبلها.. يعني أن الثورة سارت بقدميها وقطعت المسافةَ ما بين “لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف” إلى ما سُمّي “سلام الشجعان والتطبيع مع المحتلّ والاعتراف به وبما احتلّه وهو أربعة أخماس مساحة فلسطين” دون ثمن ملموس! إن هذا الإنجرار بلا يقين ودون الاحتفاظ بأدوات النضال والثورة، وتقديم مهمة على أخرى، وتبديل فكرة التحرير ، بفكرة الدولة، ضيع الفكرتين معاً، التحرير والدولة، أي لم نحقق التحرير، ولم نحصل على الدولة المستقلة ذات السيادة، ولم يعد اللاجئون، ولم تصبح القدس عاصمة حرّة لنا، ولم تعترف إسرائيل بحقوقنا! وظهرت السلطة في أحسن صورها تقدّم خدمات بلدية وتجمع الرواتب! ولا نستطيع السيطرة على أيّ معبر أو على بوصة واحدة، لنقيم عليها ضاحية أو مشروع تنمية، إلا بموافقة الاحتلال! وباتت إسرائيل هي المُتَحَكِّم الأقوى في الحالة الفلسطينية. وأضحينا جسراً للتطبيع ما بين إسرائيل والأنظمة العربية وغيرها -على اعتبار أن أصحاب الشأن(الفلسطينيين)قد صالحوا إسرائيل- وبتنا، فعلياً، نحول دون رفع السلاح في وجه إسرائيل.. أو لنقل لم نعد قادرين على ذلك وبكيفية موجعة واستراتيجية.واتّسعت هوامش الاحتكار والفساد والتكلّس والاستزلام والشعبوية.وضاقت هوامش الحرية.وانفرطت النُخب والقوى الفلسطينية، وانكفأ بعضها، فيما ذهب البعض منها إلى خيارات مضادّة ومناكفة. وفَقدنا التخطيط الشامل لمواجهة الأسئلة الوجودية الحارقة التي تتقدّم نحونا. ورأينا حال منظمة التحرير المترهّل والعاجز، إلّا لفظياً!
وتحوّلت التسوية السياسية إلى فخّ خطير، بات يهدّد كل ما أنجزته الثورة الفلسطينية والشعب الفلسطيني طيلة مسيرة النضال، قدّم شعبنا خيرةَ أبنائه شهداء وجرحى وأسرى. وأخطر ما في الواقع هو غياب إرادة حقيقية للتغيير، واستمراء مكوّنات الحُكم والنفوذ في منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية،للبقاء في الحكم على حساب التحرير، وغموض الأهداف الحقيقية لمشروع المقاومة، الذي تمارسه الفصائل خارج منظمة التحرير، خاصة حركة حماس، التي باتت تستفرد بالحكم في قطاع غزة، وتخوض جولات من الموجهات المتقطّعة مع دولة الاحتلال، على قاعدة تعزيز صيغة الردع المتبادل”إن عدتم عُدنا” ، دون أن تسعى إلى تحويل منجزاتها لمنجزات سياسية أو وطنية. فحركات التحرر لا تلجأ لمفهوم الردع والردع المتبادل، لأنّ هذا يعطّل المقاومة التي مهمتها التأزيم المستمر وليس الردع. وربما يكون من الآثار الجانبية لسياسات طرفي المعادلة الفلسطينية (فتح وحماس).
كانت منظمة التحرير الفلسطينيية واحدة من أهم الانجازات التي تحققت، لتضع الحصان أمام العربة، على الرغم من أن المنظمة أوجدها النظام الرسمي العربي لتكون مدخلاً لنفوذ العرب وهيمنتهم على الشعب الفلسطيني، إلا أنها شكّلت بساط الريح الذي حمل المشروع الوطني طيلة سنوات النضال، ويخشى أن الثورة ،أو على الأصح قيادتها الرسمية، وتحت ضغط اللحظة الملتبسة في ظل اتفاق سياسي بات يقيد أدوات الفعل والنضال الوطني، أصبحت تُطوِّع المنظمة لخدمة التسوية السياسية التي أفرغها الاحتلال من كل ما كان يتوقع من مخرجاتها، بل ووضعتها في خدمة الحفاظ على مكوّنات الحُكم بعيداً عن الانتخابات والديمقراطية، وتكاد تحجبها خلف ظلّ السلطة الثقيل، وتستخدم مؤسساتها لتغطية سياسات الحكم، الأمر الذي يهدد، بشكل خطير، وحدانية تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني.
***
وكان الشعب الفلسطيني بعد حرب النكسة عام 1967، قد اكتشف أن النظام العربي لم يمنعه فقط من تحرير أرضه المحتلة عام 1948، بل حال دون إمتلاكه قدرات المقاومة للمحافظة على ما تبقى من أرضه في الضفة الغربية وغزة والقدس. ولهذا ظلّت الثورة مستهدفة منذ البدايات ، فخاضت معارك للدفاع عن نفسها أكثر مما خاضت معارك ضد الإحتلال، وأعتقد أن قوى الاستعمار والصهيونية ، وبالذات في الغرب، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية،عبر ذيولها، قد استطاعت -للأسف الشديد- دفعَ الظاهرةَ الفلسطينية والحالة التي مثّلتها الثورة، استطاعت أن توصلها إلى النقطة التي تريد، أي إلى طاولة التفاوض مجردة من كل عناصر القوة، وبغير شروط الثورة. كما استطاع الغرب وأذرعه الرجعية والمكرّسة لخدمته، محاصرة المشهدَ الفلسطيني في مربّع، يضيق تدريجياً، إلى حدّ أننا أصبحنا محاصرين، في عدد من السجون الكبيرة (المدن والبلدات والقرى والمخيمات). وتفتت وحدة الشعب وتفتت المشروع الوطني، فأصبحت أولوية الشتات هي العودة ، وأولوية الفلسطينين في أراضي 1948 المساواة بالحقوق ضمن دولة الاحتلال، بينما يُلحِف شعبنا في الأراضي المحتلة العام 1967 على الاستقلال وإقامة الدولة “المجزوءة”، عداك عن الشرخ العميق والمؤذي بين الضفة والقطاع، وسيطرة سلطات الاحتلال على الكثير من تفاصيل حياتنا، لا سيما في القدس.
وهذا لا يعني أنني أغضّ الطرف أو أنسى أن الشعب الفلسطيني قد قطع شوطاً مضنياً وطويلاً على طريق تأكيد ذاته واستعادة هويته والمحافظة على شخصيته الوطنية والثقافية، وجعل من منظمة التحرير وطناً سياسياً ، رغم كل استطالات النفوذ العريي داخلها، هذا الجهد المتواصل، الذي لن يموت ولن يتوقف، ويبقى يصطدم مع نظرية متواصلة وداهمة، تحاول ردّه على أعقابه، والقضاء على ما حققه، والعودة به إلى نقطة الصفر. وهي نظرية مدفوعة بإرادة الإلغاء والشطب والنفي الصهيونية الغربية الرجعية، تواجهها إرادة التحدّي والبقاء الفلسطينية. وأعتقد أن هذا الصراع بين الإرادتين سيتواصل، إلى أن يبلغ شعبنا أهدافه ويتمّم أحلامه، وسيبقي الصراع صراعاً وجودياً وشمولياً.
وباختصار؛ فإن هناك ثلاثة أخطاء استراتيجية اقترفتها قيادة المنظمة، وهي:
الأول: أن المنظمة انتزعت تمثيلها للشعب الفلسطيني بشرعية البندقية المقاوِمة، ولكنها بالمقابل خسرته ،نسبياً، أو تخّلت عنه نسبياً مقابل النفوذ المالي.
الثاني: أنها أقدمتْ على أكبر مغامرة سياسية يمكن لحركة تحرر وطني أن تُقدِم عليها، وهي قبولها التفاوض مع التخلّي عن أداتها الكفاحية، ويمكن، هنا، مقارنة موقف قيادة المنظمة من المفاوضات بموقف القيادة الفيتنامية.
الثالث: بعد الخروج من بيروت وافتقاد القاعدة الآمنة.. تحوّلت القيادة من خندق محاربة التطبيع إلى منصّة توظيف التطبيع.
وثمّة أخطاء أخرى منها، التقليل من أهمية المحافظة على الوحدة الوطنية. والأخطاء المتعلّقة بقوانين مواجهة الاحتلال (اللّا تعايش مع الاحتلال). وقبول تحويل المؤقّت إلى دائم. وتضخيم الانجازات الرمزية واعتبارها انتصارات. وربط الاقتصاد الفلسطيني بالاحتلال، واستخدام نظام الاقتصاد الحرّ في مرحلة التحرّر،واستبدال مفهوم التحرر الوطني بالتنمية الوطنية.
والحقيقة الصادمة، وبكل المقاييس، أن السلطة أصبحت أكبر العوائق أمام مسيرة التحرير، لأن مكوّنها ووظيفتها هي وظيفة مُعطِّلة للتحرير، سواء على مستوى المكوِّن الأمني أو المدني، لأن الأمني في خدمة الأمن الذي يريده الاحتلال، والمدني أعفى الاحتلال من كل مسؤولياته، وجعله أرخص احتلال في التاريخ، واحتلال بلا ثمن! حتى أن هذا الاصطلاح تستخدمه السلطة من رئيسها إلى رئيس قسمها.. دون العمل وفق دلالاته.
قد يكون الاستنتاج صادماً، أيضاً، لكنه الحقيقة التي يحيد الكثيرون عن الاعتراف بها. والأخطر فيها أنها جعلت سؤال “ما البديل” و”ما العمل” سؤالاً مُستعصياً، لأنها حوّلت شعباً بأكمله من صاحب مصلحة في التحرير إلى صاحب مصلحة في التعايش مع الواقع الثقيل. وبكل بساطة لدينا 350 ألف(راتب) موظف ومتقاعد، تقريباً، مرتبطون بهذه الكينونة التي تشكّل عائقاً حقيقياً أمام التحرير.. عداك عن البنوك والمؤسسات والالتزامات والمنظمات غير الحكومية – المواليين والمعارضين - الذين هم،أيضاً، أصبحوا أصحاب مصلحة في التعايش.
باختصار لقد كانت السلطة زمن الرئيس عرفات ومع بداياتها، رغم كل القيود والملاحظات، تذهب في سياق مهمّة التحرير، لأنها كانت “عامل تأزيم”، وبحثت عن كل المخارج، وواجهت أزمات.. حتى دفع الرجلُ حياتَه ثمناً لذلك.
لكن السلطة، بعد سنوات، وبعيداً عن الأشخاص والاتّهامات، أصبحت “عامل تهدئة” ومنحت الاحتلال استقراراً من حيث الكيفية والزمن.. لم يتوقّعه منذ إقامة دولته الغاصِبة.
إننا لا نميل إلى انتقاد الأشخاص وتحميلهم المسؤوليات، بغض النظر عن كل الملاحظات وسوء الأداء أو تميّزه، فالموضوع أكبر من ذلك بكثير، لكن ذلك لا يعفينا ولا يعفيهم من مواجهة الواقع والحقيقة الصادمه، أن هذا المشروع قد فشل ووصل إلى نهايته. ولا يحقّ لأحد، كائناً مَن كان، أن يوهِم نفسَه أو غيره أنه يمتلك معجزة ستأتي بِحَلٍّ سحريّ من جعبة الحاوي، لأن هذا ببساطة هو بيعٌ للوَهمْ، ولم يعد شراء الوقت ممكناً أو مفيداً، لأن المسافة بين أهدافنا، التي نسعى لتحقيقها، بالحرية والاستقلال والدولة والعودة والقدس، قد ضاقت إلى حدّ مفجع، ولا يمكن مدّها زمنياً أو موضوعياً. وإذا ما استمرّت القيادة في نهجها الحالي.. عندها، لا مناص من أن نقول إنهم سيتحمّلون المسؤولية عن المصير المظلم الذي دُفِع إليه شعبنا، وسنتحمل معهم مسؤولية الصمت.. إنْ رضينا بذلك.
***
وأرى أن مهمة المركزي هي البحث عن استراتيجية جديدة ترتكز إلى الكينونة التي حملت مشروعنا، وامتلكت أدوات التحرير، وضمّت أطياف الشعب وقواه وفصائله، التي هي منظمة التحرير الفلسطينية، التي يبقى عليها أن تضمّ باقي الفصائل الفلسطينية وتنجز الوحدة الوطنية.
إن الاستراتيجية التي نتحدث عنها، من المهم أن تتصدّى لتحديات السؤال ” كيف نستعيد أدوات التحرير” وكيف نتخلّص من المعيقات التي تشكّلها كينونة السُلطة،و كيف نعيد الشعب ليصبح صاحب مصلحة في التحرير.
وإن الانقسام لا يقلّ خطورة عن المعيقات آنفة الذكر، وإن حركة حماس تتحمّل المسؤولية بالدرجة نفسها إذا ما بقيت متمترسة وراء “مشروعها” ومصالحها، وتبحث عن شروط “تحسين الحياة” في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه بالقوة.
وتكاد سياسة الأمر الواقع في قطاع غزة تتقاطع استراتيجياً مع حالة السلطة الوطنية في الضفة الغربية، من حيث “الردع والردع المتبادل”، و”فكرة التهدئة مقابل تحسين شروط الحياة في غزة وتخفيف الحصار”.. بديلاً لموضوعة التحرير، ما يوحي أن طرفيْ المعادلة في الضفة والقطاع مشغولان بموضوعة الحُكم أكثر من انشغالهما في موضوعة التحرير.
***
ونعترف؛ بأن ثمة أخطاء قد وقعت، وأن تجاوزات قد حدثت، وأن خروجا جارحاً واضحاً قد تمّ على مبادئ الثورة واستراتيجياتها التي كانت تتغيّاها.. لهذا لا بدّ من المكاشفة والمصارحة، على قاعدة النقد الذاتي المسؤول والحريص المنتمي.
والأخطاء،التي يجب مواجهتها، عديدة متنوّعة، كبيرة إلى حدّ الخطيئة، وصغيرة إلى درجة الّلمم. وأعتقد أن أكبر أخطاء الثورة تمثّل في التنازل عن حقوق غير قابلة للتصرّف (78بالمئة من أرض فلسطين) والهبوط بالثوابت (دولة في الضفة والقطاع)، وعدم اعتماد مبدأ المأسسة،والسماح باستشراء الفساد بكل صوره،والاعتراف بالقاتل قبل نيل الحقوق. أما ما تبقى فهي أخطاء، تبدأ ولن تنتهي.. لكن أبرزها، الآن، يتمثّل في: عدم تحرير المنظمة من قيود السلطة.
وقد بات من المُلِحّ والضروري الخروج من المنطقة الرمادية التي حكمت مواقف ورؤى المنظمة خلال أكثر من عقدين من تماهيها مع السلطة، وتوضيح موقفها من التسوية والمفاوضات والشرعية الدولية والمقاومة واللاجئين والمصالحة ودول الجوار، على قاعدة الالتزام بالثوابت والحقوق الوطنية التاريخية. وليس على حسابها أو اللعب على الحدود الحمراء لهذه الثوابت والحقوق والمساومة عليها، حتى كتكتيك ومناورة، كما لا يجوز دفن الرأس بالرمال.
وعلى الرغم من وجود خلافات داخل المنظمة، فإنها ما زالت الجسد الأكبر والأكثر تماسكاً. وكل ذلك لا يمنح شرعية دائمة وثابتة لها، ولا يعطيها الأسبقية دائماً على غيرها من القوى والحركات السياسية. المنظمة تحتاج – بالإضافة إلى ما سبق كي تستحق وتتصدّر المشهد السياسي النضالي والتعبير عن نبض الشعب وتطلعاته والاستمرار في قيادة المشروع الوطني – إلى ثورة داخل الثورة، إلى النهوض من جديد وإعادة تفكيك وتركيب، وإعادة الاعتبار إلى دورها كحركة تحرر وطني، تنسلّ من القيود التي تكبّلها، ومن وَهْم التسوية مع المحتلّ، لتتقدم خَطَّ المقاومة والثورة، ضد الاحتلال، على طريق الحرية والاستقلال.