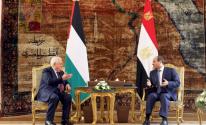منذ أشهر عديدة والقيادة الفلسطينية تبذل كثيراً من الجهود لإعادة وضع القضية الفلسطينية على رأس جدول الأعمال الدولي، من مدخل استئناف العملية التفاوضية، وبواسطة تكثيف الضغط السياسي والديبلوماسي على إسرائيل، في قضايا القدس والمستوطنات والإفراج عن المعتقلين، وضمن ذلك تأتي جهودها لعقد مؤتمرات دولية، في باريس (كما حدث منذ يومين)، ولاحقاً في موسكو التي زارها مؤخراً صائب عريقات.
معنى ذلك أن هذه القيادة أضحت تدرك الوضع الحرج الذي باتت تجد نفسها فيه نتيجة تغيّر المناخات الدولية والإقليمية والعربية، وظهور أولويات أكثر إلحاحاً، تفرض ذاتها، أو تغطي على قضية الفلسطينيين.
طبيعي أنه ينبغي التعاطي بإيجابية مع الجهود الفلسطينية المذكورة، بيد أن المشكلة تكمن في قصور رؤية القيادة الفلسطينية للمعطيات المحيطة، وللوضع الذي أسهمت هي في الوصول إليه، وضمن ذلك مثلاً، لا مبالاتها إزاء ما يجرى في المشرق العربي، بخاصة مع زعزعة دوله وتقويض وحدة مجتمعاته، وتحوله إلى ساحة للصراعات والتدخلات الخارجية، ولا سيما الإيرانية والتركية والروسية (فضلاً عن الأميركية طبعاً). ففي ظل هذه الأوضاع الكارثية التي تمر بها مجتمعات سورية والعراق، مع تشريد الملايين، من الصعب بداهة الحديث عن اهتمام عربي أو إقليمي أو دولي جدي بالقضية الفلسطينية، وبالأخص يصعب الحديث عن تسوية منصفة، ولو بالحد الأدنى للفلسطينيين، فما الذي يضغط على إسرائيل في هذه الظروف والمعطيات كي تقوم بإبداء ما تعتبره «تنازلات» للفلسطينيين؟
من ناحية ثانية، يبدو أن القيادة الفلسطينية ما زالت لا تدرك أنها بتحولها إلى مجرد سلطة في الضفة وغزة، بموجب اتفاق أوسلو (1993)، وتهميشها منظمة التحرير، وارتهانها لخيار المفاوضات، أسهمت في التشويش على التعاطف العربي والدولي مع قضية الفلسطينيين، وسهّلت على إسرائيل تجاهل هذه القضية، وخفّفت من الضغوط عليها، وأظهرت كأن الخلاف يدور فقط على متر هنا ومتر هناك. طبعاً، ثمة عوامل أخرى فاقمت من ذلك، ضمنها الانقسام الفلسطيني بين سلطتي الضفة (حيث «فتح») وغزة (حيث «حماس»)، وتهميش دور مجتمعات اللاجئين في العملية الوطنية، وتآكل مكانة منظمة التحرير، وكلها تتحمل مسؤوليتها الطبقة السياسية الفلسطينية السائدة، في السلطة والمنظمة والفصائل.
أيضاً، ومن ناحية ثالثة، فإن القيادة الفلسطينية هي المسؤولة عن تجزئة قضية الفلسطينيين، بتحولها من الصراع على ملف 48 إلى الصراع على ملف 67، بل وبتحولها من ملف انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة (1967) المستمد من الشرعية الدولية، إلى القبول بتجزئة القضية، والبحث في كل مظهر من مظاهرها على حدة، ومن دون أي مرجعية، على نحو ما يجرى في طرحها قضايا الاستيطان والقدس والمعابر والتنسيق الاقتصادي والعلاقات الأمنية والانسحاب من هذه المنطقة أو تلك، وهو النهج الذي تم تأسيسه في اتفاق أوسلو. هذا من دون التقليل من النجاحات المتعلقة بتقديم أوراق الاعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب (2012) بموافقة 134 دولة، أو الدخول في إطار المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، أو صدور قرارات مهمة عن مجلس الأمن الدولي، مثل القرار 2334 (في 23/12/2016) الذي دان في شكل واضح النشاط الاستيطاني الإسرائيلي.
ولعل أهم ما ينبغي للقيادة الفلسطينية إدراكه، في هذه المرحلة، أن مسألة التسوية مع الفلسطينيين لم تعد تعني شيئاً بالنسبة الى إسرائيل (كحكومة وكمجتمع)، إذ لا يوجد ما يضغط عليها، أو ما يدفع بها نحو هذا الأمر، لا سيما بعد أن أضحت المقاومة الفلسطينية في أضعف أحوالها، وباتت تقتصر على مجرد ردات فعل ظرفية، أو عمليات فردية. وبديهي أنه لا يمكن إحالة هذا الأمر، فقط، إلى مجرد غطرسة إسرائيل وتعنّتها، وثقتها بقواها العسكرية، وبضعف إرادة المجتمع الدولي في الضغط عليها، وإنما يمكن إحالته، في شكل أساسي، إلى هشاشة الأوضاع العربية، وضمنها الأوضاع الفلسطينية.
هكذا، ففي الصراعات السياسية لا يمكن لطرف أن يتنازل لطرف آخر من دون توافر الشروط والمعطيات وموازين القوى، الدولية أو المحلية، التي تضطره إلى ذلك، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بدولة من طبيعة استيطانية - احتلالية، تبرر نفسها بالأساطير الدينية، كإسرائيل؟
وإذا كان العجز والتفتت العربيان واضحين تماماً، في مجال مواجهة التحدي الذي تفرضه إسرائيل (من النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية)، فإن الوضع الفلسطيني ليس أحسن حالاً. والحال، فقد استنزَف الفلسطينيون، طوال العقد الماضي، جلّ طاقتهم في صراع غير محسوب مع إسرائيل، من دون الوصول إلى النتيجة المتوخّاة، وهي دحر الاحتلال، ونيل الاستقلال، وإقامة الدولة المستقلة في الضفة والقطاع.
لا يقف الأمر عند هذا التدهور المريع في مجال عمل المقاومة المسلحة، ذلك أن الفلسطينيين، بسبب تخلّف إدارتهم لصراعهم مع عدوهم، وفوضاهم، وانقساماتهم، وجدوا أنفسهم، فوق ما تقدم، أمام واقع جديد، فثمة جدار يقطّع أوصال الضفة الغربية، ويفصلها عن المناطق الإسرائيلية والكتل الاستيطانية. وفوق ذلك ثمة انتشار سرطاني للنقاط الاستيطانية. أما قطاع غزة فقد حوله الإسرائيليون إلى نوع من سجن لمليون ونصف مليون فلسطيني.
يستنتج من كل ذلك أن إسرائيل نجحت في تقليص احتكاكها بالفلسطينيين، إلى أقصى درجة، وقللت من تأثيرهم فيها في كل النواحي. وكان المحلل الإسرائيلي ألوف بن من أبرز من شرح هذا الوضع، قبل عامين، باعتباره أن الإسرائيليين «مقطوعون عن النزاع مع الفلسطينيين ولا يحتكّون بهم. فهم يرونهم شخوصاً غير واضحة في الأخبار... تبعد نابلس ورام الله نحو أربعين دقيقة بالسيارة عن تل أبيب، والمدينتان موجودتان في نظر الناس الذين يعيشون في تل أبيب كأنهما في كوكب آخر... المستوطنون وراء جدار الفصل هم الإسرائيليون الوحيدون الذين يقابلون الفلسطينيين... من خلال نافذة السيارة في الشوارع المشتركة... يمكن السفر إلى المستوطنات الكبيرة مثل معاليه ادوميم واريئيل من دون رؤية الفلسطينيين تقريباً... تزيد العزلة الفرق بين شكل رؤية الإسرائيليين لدولتهم وشكل رؤية العالم لها... بسبب العزلة وعدم الاكتراث، لا يوجد ضغط عام على الحكومة للانسحاب من «المناطق» ولإقامة دولة فلسطينية».
المؤلم أكثر أن خيبة الفلسطينيين لا تتجلى، فقط، في ضعف قدرتهم على إضعاف الاحتلال ورفع كلفته، وإنما هي (للأسف) تتجلى، أيضاً، في إخفاقهم في بناء كياناتهم ومؤسساتهم السياسية، كما في تشوّه صورة حركتهم الوطنية التي تحولت (أو انحرفت) من حركة تحرر وطني إلى سلطة تصارع من أجل بقائها، في الضفة وغزة، على حساب التصارع مع الاحتلال، ما نجم عنه شيوع نوع من التخصيص (من خصخصة) للمجال العام، وبروز مظاهر الفساد، بأنواعه (السياسي والمسلكي).
هذا الوضع البائس هو الذي يشجع نتانياهو على تجاهل نحو ربع قرن من عملية التسوية، والتعامل مع الفلسطينيين ومع العالم، وكأن هذه العملية بدأت اليوم، ملقياً اللوم على الفلسطينيين، لمجرد رفضهم التفاوض المباشر، قبل وقف الاستيطان. وهو الوضع ذاته الذي يدفع نتانياهو الى وضع سلسلة من الشروط لتسيير عجلة التسوية، مثل الاعتراف بيهودية الدولة، ونزع سلاح الفلسطينيين. هذا طبعاً إضافة إلى شروط الإجماع الإسرائيلي، التي تشمل أيضاً عدم العودة إلى حدود 1967، وضم الكتل الاستيطانية، والحفاظ على القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل، ورفض حق العودة للاجئين الفلسطينيين! ومعلوم أنه في نظر نتانياهو وحكومته، وبعيداً عن كل المناورات، ليس ثمة ما يضطر إسرائيل، لا بوسائل الضغط السياسي ولا بواسطة القوة، لتقديم «تنازلات» للفلسطينيين في عملية التسوية. وبالنسبة الى نتانياهو وحكومته فإن الحفاظ على إسرائيل قوية أهم من عملية التسوية. وبرأيهم أن من شأن عملية التسوية أن توهن إسرائيل، وأن تخلق الشقاق في المجتمع الإسرائيلي، وأن تضعف صدقية الصهيونية، وأن تشجع الآخرين على استمرار تحديها.
جيد أن تواصل القيادة الفلسطينية معركتها الديبلوماسية والسياسية مع إسرائيل، لكن من المفيد أن تبتعد عن الأوهام، بأن تدرك أيضاً أن عقد مؤتمرات في موسكو أو باريس أو أي عاصمة أخرى لن يجدي نفعاً، من الناحية العملية، لأن الاستثمار السياسي في مثل هذه المؤتمرات غير مسموح به، أو غير ممكن، في ظل الأوضاع الراهنة في المشرق العربي، وفي ظل هذا التردي في وضع الفلسطينيين وحركتهم الوطنية.
عن الحياة اللندنية