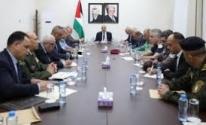قاتل الأميركيين في أورلاندو بايع "داعش"، وأضاف ما لا يحصى من أصوات الناخبين إلى رصيد دونالد ترامب، في الولايات المتحدة، ورصيد زعماء فاشيين وقوميين متطرفين في بلدان أوروبية مختلفة. "داعش"، إذاً، يعيد صياغة العالم بقدر غير مألوف، ولا معروف، من البشاعة، ولا ينبغي التفكير في مُنجزات الديمقراطية الليبرالية، بعد جحيم الحرب العالمية الثانية، في مجال المواطنة، والمساواة، وحقوق الإنسان، باعتبارها آمنة ومضمونة.
وعلى الرغم من حقيقة أن أكثر من قابلة، ومربية، وحاضنة، تعهّدت "داعش" الفكرة، والوحش، بالرعاية، وعلى الرغم من تعدد جغرافيته، وإمكانية العودة بزمن ولادته إلى قرون مضت، إلا أن التفسيرات التي يتداولها محللون عرب وعجم، في هذا الشأن، تظل ناقصة ما لم تأخذ في الاعتبار أن "داعش" مشكلة عربية، وأنه من تجليات علاقة العالم العربي، وقد أصبح رجل العالم المريض، بنفسه وبالعالم، وأن العدوى أصابت العالم.
وهذه المشكلة تظل عصية على الفهم ما لم نأخذ في الاعتبار أنها نجمت، في المقام الأوّل، عن إحساس مفاجئ بالقوة، لم يتوفّر للعرب منذ قرون. كان الظلم الواقع على العرب على مدار ثلاثة أرباع القرن العشرين أشد قسوة مما أصابهم في ربعه الأخير، ولكن ثروة النفط هي التي قلبت الميزان، وهي التي وضعت مشروع أسلمة العالم على جدول الأعمال، ودعمته بمليارات الدولارات، والبنوك، والشركات، والجمعيات، والاتحادات، والمؤتمرات، وكلها عابرة للجغرافيا والقوميات.
لماذا لم يظهر "داعش" في زمن حرب التحرير الجزائرية، مثلاً، ولماذا لم يظهر بعد سقوط المسجد الأقصى في يد الإسرائيليين، وحتى بعد إحراقه؟ لأن ثروة النفط لم تكن قد تجلت بكل جبروتها بعد. كان احتلال المسجد الأقصى إهانة لمشاعر المسلمين، في أربعة أركان الأرض، ولم تخرج مظاهرات، ولم تُرتكب أعمال عنف، توازي ما حدث كردة فعل على الرسوم الكاريكاتورية المسيئة، التي وقعت في زمن الإحساس بالقوّة.
لماذا لم تظهر تجليات داعشية في حرب التحرير الفيتنامية (يعني "داعش" على طريقتهم)، وقد فعل الأميركيون بالفيتناميين عشرة أضعاف ما فعلوه بالأفغان والعراقيين؟ الفيتناميون لم يرسلوا الانتحاريين لقتل الناس في المطاعم والقطارات والأسواق في واشنطن، وبقية عواصم الغرب. الظاهرة الداعشية في جنوب شرقي آسيا، هي الخمير الحمر، وقد كانت محلية تماماً.
المقصود أن الدكتاتورية، والاستبداد، وانسداد أفق المشاركة السياسية، عوامل أسهمت في الاحتقان، وفي زيادة مبررات ودوافع العنف في العالم العربي، ولكنها تظل عوامل مساعدة، إذا ما قورنت بما نجم من تداعيات إحساس مفاجئ بالقوّة ولّدته ثروة النفط، وترجمة القوّة المفاجئة في مشروع للأسلمة. واللافت صعود المشروع بعد نصر أكتوبر، لا بعد هزيمة حزيران. والحاسم تنازل مصر عن دورها، في العالم العربي، بعد أكتوبر، وانخراطها كشريك صغير في المشروع.
لذلك، إذا تناولنا الظاهرة الداعشية بالتحليل انطلاقاً من فرضية أنها نجمت عن رعونة القوّة لا عن مهانة الضعف، وأنها وثيقة الصلة بثروة النفط، ومن نتائج مشروع للأسلمة، نكون قد تحررنا من أعباء فرضيات سائدة ومُضللة ينسخها محلل عن آخر، وكأنها حقيقة لا تقبل الشك. والواقع، أيضاً، أن أطرافاً مختلفة، ولأسباب مختلفة، تستفيد من "حقيقة" كهذه.
هذا لا يعني أن الوحش الداعشي، بصورته الحالية، وبعدما انقلب على أسياده الماليين، والأيديولوجيين، كان ما أراده أصحاب المشروع، بل يعني أن للمشروع (ككل مشروع للهندسة السياسية والاجتماعية والأيديولوجية) حياة مستقلة وخاصة، ومُخرجاته لا تتطابق، بالضرورة، مع الوصفة الأصلية في المعمل، وإن حملت كل مكوّناتها، وعلاماتها الفارقة. ألا تعيد المُخرجات تذكيرنا بماري شيلي، ورواية فرانكنشتاين، الذي أردا بعث الحياة في المادة فخلق، في المعمل، مسخاً مخيفاً، تحوّلت صورته، مع مرور الأيام، إلى مجاز للتجارب الفاشلة في الهندسة الاجتماعية. المفارقة أن فرانكنشتاين شعر بالندم بعد موت صانعه، وهذا مُستبعد في حالة الوحش الداعشي.
إذاً، إذا وضعنا في الاعتبار أن "داعش" نجم عن إحساس بالقوّة، وفي زمنها، وأنه من مُخرجات مشروع للأسلمة، يمكن التفكير في أسباب رواجه، بالمعنى الأيديولوجي، ونجاحه في تجنيد القريب والبعيد، وإقناع شبّان في مقتبل العمر بتفجير أنفسهم في مطاعم وأسواق وحانات. والواقع أن ثمة أكثر من سبب:
توهّم القاعدة والطالبان أنهم هزموا الإمبراطورية السوفياتية في أفغانستان، وهذا الوهم وثيق الصلة بمحاولة إعادة سيرة الإسلام الأوّل، الذي هزم كسرى وفارس. المزاوجة بين وهم الانتصار الأفغاني، وإعادة سيرة الأوّلين، تعني الانخراط في تاريخ مقدّس، ولا يمكن تحقيق أمر كهذا دون إحساس قناعة بقرب نهاية الأيام. وهذه القناعة هي الدينامو العاطفي والرمزي لكل الحركات (الميسيائية) الخلاصية على مر التاريخ.
يمكن التفكير في سبب آخر يعود الفضل في اختزال دلالاته للفرنسي أوليفيه روا، الذي أطلق على حاضر البشرية هذه الأيام تسمية "الجهل المقدّس"، وعلامته الفارقة انفصال الأديان في ظل العولمة عن خصوصياتها الثقافية وتاريخها الحضاري، واختزالها في إيمان بلا ثقافة.
وأخيراً، وُلد الوحش الداعشي على دفعات، وتجلى في أكثر من جسد، وتحت أسماء وثياب مختلفة. وبينما انخرطت شعوب آسيوية، وأفريقية، ولاتينية، في مشاريع قومية للتحديث والتنمية، في الربع الأخير من القرن العشرين، تصادف أن مصالح الأميركيين، وحلفائهم في أوروبا الغربية، والعالم العربي، أصبحت في هذه المرحلة بالذات: حماية أمن إسرائيل، حماية مصادر الطاقة، وحماية طرق التجارة الدولية، ومعاهدات السلام، وهذا ما استدعى، ضمن أمور أخرى، تحقيق "الاستقرار"، وتصفية النزعات القومية واليسارية، والاستثمار في مشروع الأسلمة كضمانة لتحقيق وتثبيت الأمر الواقع، ولم يفكر أحد، في حينها، في ولادة الوحش على دفعات، ولا حتى في عدوى قد تصيب العالم.
وعلى الرغم من حقيقة أن أكثر من قابلة، ومربية، وحاضنة، تعهّدت "داعش" الفكرة، والوحش، بالرعاية، وعلى الرغم من تعدد جغرافيته، وإمكانية العودة بزمن ولادته إلى قرون مضت، إلا أن التفسيرات التي يتداولها محللون عرب وعجم، في هذا الشأن، تظل ناقصة ما لم تأخذ في الاعتبار أن "داعش" مشكلة عربية، وأنه من تجليات علاقة العالم العربي، وقد أصبح رجل العالم المريض، بنفسه وبالعالم، وأن العدوى أصابت العالم.
وهذه المشكلة تظل عصية على الفهم ما لم نأخذ في الاعتبار أنها نجمت، في المقام الأوّل، عن إحساس مفاجئ بالقوة، لم يتوفّر للعرب منذ قرون. كان الظلم الواقع على العرب على مدار ثلاثة أرباع القرن العشرين أشد قسوة مما أصابهم في ربعه الأخير، ولكن ثروة النفط هي التي قلبت الميزان، وهي التي وضعت مشروع أسلمة العالم على جدول الأعمال، ودعمته بمليارات الدولارات، والبنوك، والشركات، والجمعيات، والاتحادات، والمؤتمرات، وكلها عابرة للجغرافيا والقوميات.
لماذا لم يظهر "داعش" في زمن حرب التحرير الجزائرية، مثلاً، ولماذا لم يظهر بعد سقوط المسجد الأقصى في يد الإسرائيليين، وحتى بعد إحراقه؟ لأن ثروة النفط لم تكن قد تجلت بكل جبروتها بعد. كان احتلال المسجد الأقصى إهانة لمشاعر المسلمين، في أربعة أركان الأرض، ولم تخرج مظاهرات، ولم تُرتكب أعمال عنف، توازي ما حدث كردة فعل على الرسوم الكاريكاتورية المسيئة، التي وقعت في زمن الإحساس بالقوّة.
لماذا لم تظهر تجليات داعشية في حرب التحرير الفيتنامية (يعني "داعش" على طريقتهم)، وقد فعل الأميركيون بالفيتناميين عشرة أضعاف ما فعلوه بالأفغان والعراقيين؟ الفيتناميون لم يرسلوا الانتحاريين لقتل الناس في المطاعم والقطارات والأسواق في واشنطن، وبقية عواصم الغرب. الظاهرة الداعشية في جنوب شرقي آسيا، هي الخمير الحمر، وقد كانت محلية تماماً.
المقصود أن الدكتاتورية، والاستبداد، وانسداد أفق المشاركة السياسية، عوامل أسهمت في الاحتقان، وفي زيادة مبررات ودوافع العنف في العالم العربي، ولكنها تظل عوامل مساعدة، إذا ما قورنت بما نجم من تداعيات إحساس مفاجئ بالقوّة ولّدته ثروة النفط، وترجمة القوّة المفاجئة في مشروع للأسلمة. واللافت صعود المشروع بعد نصر أكتوبر، لا بعد هزيمة حزيران. والحاسم تنازل مصر عن دورها، في العالم العربي، بعد أكتوبر، وانخراطها كشريك صغير في المشروع.
لذلك، إذا تناولنا الظاهرة الداعشية بالتحليل انطلاقاً من فرضية أنها نجمت عن رعونة القوّة لا عن مهانة الضعف، وأنها وثيقة الصلة بثروة النفط، ومن نتائج مشروع للأسلمة، نكون قد تحررنا من أعباء فرضيات سائدة ومُضللة ينسخها محلل عن آخر، وكأنها حقيقة لا تقبل الشك. والواقع، أيضاً، أن أطرافاً مختلفة، ولأسباب مختلفة، تستفيد من "حقيقة" كهذه.
هذا لا يعني أن الوحش الداعشي، بصورته الحالية، وبعدما انقلب على أسياده الماليين، والأيديولوجيين، كان ما أراده أصحاب المشروع، بل يعني أن للمشروع (ككل مشروع للهندسة السياسية والاجتماعية والأيديولوجية) حياة مستقلة وخاصة، ومُخرجاته لا تتطابق، بالضرورة، مع الوصفة الأصلية في المعمل، وإن حملت كل مكوّناتها، وعلاماتها الفارقة. ألا تعيد المُخرجات تذكيرنا بماري شيلي، ورواية فرانكنشتاين، الذي أردا بعث الحياة في المادة فخلق، في المعمل، مسخاً مخيفاً، تحوّلت صورته، مع مرور الأيام، إلى مجاز للتجارب الفاشلة في الهندسة الاجتماعية. المفارقة أن فرانكنشتاين شعر بالندم بعد موت صانعه، وهذا مُستبعد في حالة الوحش الداعشي.
إذاً، إذا وضعنا في الاعتبار أن "داعش" نجم عن إحساس بالقوّة، وفي زمنها، وأنه من مُخرجات مشروع للأسلمة، يمكن التفكير في أسباب رواجه، بالمعنى الأيديولوجي، ونجاحه في تجنيد القريب والبعيد، وإقناع شبّان في مقتبل العمر بتفجير أنفسهم في مطاعم وأسواق وحانات. والواقع أن ثمة أكثر من سبب:
توهّم القاعدة والطالبان أنهم هزموا الإمبراطورية السوفياتية في أفغانستان، وهذا الوهم وثيق الصلة بمحاولة إعادة سيرة الإسلام الأوّل، الذي هزم كسرى وفارس. المزاوجة بين وهم الانتصار الأفغاني، وإعادة سيرة الأوّلين، تعني الانخراط في تاريخ مقدّس، ولا يمكن تحقيق أمر كهذا دون إحساس قناعة بقرب نهاية الأيام. وهذه القناعة هي الدينامو العاطفي والرمزي لكل الحركات (الميسيائية) الخلاصية على مر التاريخ.
يمكن التفكير في سبب آخر يعود الفضل في اختزال دلالاته للفرنسي أوليفيه روا، الذي أطلق على حاضر البشرية هذه الأيام تسمية "الجهل المقدّس"، وعلامته الفارقة انفصال الأديان في ظل العولمة عن خصوصياتها الثقافية وتاريخها الحضاري، واختزالها في إيمان بلا ثقافة.
وأخيراً، وُلد الوحش الداعشي على دفعات، وتجلى في أكثر من جسد، وتحت أسماء وثياب مختلفة. وبينما انخرطت شعوب آسيوية، وأفريقية، ولاتينية، في مشاريع قومية للتحديث والتنمية، في الربع الأخير من القرن العشرين، تصادف أن مصالح الأميركيين، وحلفائهم في أوروبا الغربية، والعالم العربي، أصبحت في هذه المرحلة بالذات: حماية أمن إسرائيل، حماية مصادر الطاقة، وحماية طرق التجارة الدولية، ومعاهدات السلام، وهذا ما استدعى، ضمن أمور أخرى، تحقيق "الاستقرار"، وتصفية النزعات القومية واليسارية، والاستثمار في مشروع الأسلمة كضمانة لتحقيق وتثبيت الأمر الواقع، ولم يفكر أحد، في حينها، في ولادة الوحش على دفعات، ولا حتى في عدوى قد تصيب العالم.